مسـتـقــبــلـنــا الـعــربــي كما يكشفه العالم الافتراضي
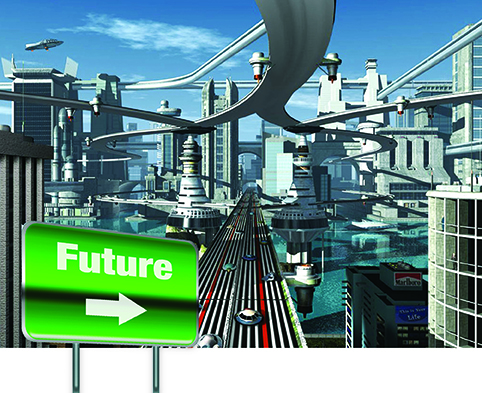
عند البحث عن كلمة «مستقبل» باللغة العربية في محرك البحث «جوجل»، فاجأني أن عدد نتائج البحث بلغت 104 ملايين نتيجة..قلت: رائع! هناك محتوى رقمي عربي ضخم يهتم بالمستقبل! ثم بحثت عن الكلمة بالإنجليزية، ووجدت نتيجة صادمة! فقد بلغت نتائج البحث مليارًا و870 مليون نتيجة.
أي أن الفارق حوالي 18 ضعفًا تقريبا! قلت لا بأس، في النهاية نحن نعرف أن المحتوى العربي على الإنترنت لا يزال فقيرًا، ولكن في النهاية نحن لدينا 104 ملايين نتيجة وهذا لا بد أن يعكس اهتمامًا كبيرًا بالمستقبل، ثم غيرت محرك البحث جوجل من اجوجل الكويتب إلى اجوجل مصرب، فارتفعت نتائج البحث عن كلمة االمستقبلب؛ وكانت النتيجة زيادة نتائج البحث إلى 240 مليون نتيجة بحث. تفاءلت وقلت لنفسي إن هناك أملاً كلما وسعنا نطاقات البحث كما يبدو، فدعنا إذن من هذه السفاسف العددية وللنطلق فورًا إلى المحتوى.
بدأت أتأمل النتائج تباعًا وجاءت كالتالي: االموقع الرسمي لجريدة المستقبلب، اتلفزيون المستقبلب، اجامعة المستقبل في مصرب، اموقع جريدة المستقبل في الكويتب، مُستقبِل (كيمياء)، وهي مرادفة تعني المستقبِلات العصبية، أو بالأدق، الأجزاء البروتينية القادرة على الاستقبال والاستجابة للنواقل العصبية، ثم امواصفات زوجة المستقبل في السعوديةب، اجائزة زايد لطاقة المستقبلب، وهنا نكون وصلنا لأول تماس يقترب من معنى المستقبل الذي نبحث عنه، لكن مع استمرار البحث سنعود لدائرة الاستخدام الدعائي لكلمة مستقبل التي تمثل إما اسم جريدة أو مجلة أو موقع خبري أو مدرسة، ولكن لا يوجد شيء يتعلق حقا بفكرة المستقبل بالمعنى الفكري أو العلمي.
في المقابل وفي الإنجليزية فإن النتائج الأولى للبحث تأتي كالتالي: االمستقبل.. في الموسوعة الافتراضية الشعبية ويكيبدياب، امجموعة المستقبل الإعلامية PLCب، امستقبل الإلكتروناتب، اخبراء تصميمات المستقبلب، امنتدى المستقبل..العمل من أجل عالم مستدامب، امستقبل العلوم في بي بي سيب. وهكذا.. والمؤشر الأولي العام والبديهي الذي يمكن أن يستقرئه الفرد حين يطالع مثل هذه المؤشرات قد يبدو سطحيًا، وهو أن النتيجة الطبيعية هنا أن العالم العربي لا يهتم إطلاقًا بالمستقبل، بينما الغرب يهتم كثيرا بالمستقبل. فهل هناك ثمة مؤشرات أخرى أكثر عمقا تؤكد أو تنفي هذا الاستدلال القائم على ملاحظات أولية من عالم الإنترنت الافتراضي؟
فوارق لانهائية بين ثقافتين
بالتأكيد هناك فروق ضخمة يمكن تبينها فور المرور المبدئي على العناوين، فبشكل عشوائي يمكننا أن نقع على بضعة عناوين متتابعة توضح لنا اهتماما كيفيا وعميقا بفكرة المستقبل. وبين تلك العناوين مثلا : نهاية المستقبل، وهو رابط يخص تفاصيل فيلم خيال علمي ضمن سلسلة أفلام أمريكية متخصصة في الخيال العلمي، ويحكي عن قيام مجموعة من رجال الفضاء عادوا من القرن الرابع والعشرين في الزمن إلى العام 1996، ويرغبون في العودة إلى زمنهم، لكنهم يخشون أن خطأ محتملا يمكن أن يقود سفينتهم إلى القرن السابع والعشرين بدلا من القرن الرابع والعشرين.
العنوان التالي سيكون انظام المستقبلب أو Future system، والمقصود به نظام في التصميم المعماري تأسس في لندن على يد فريق من المصممين تحت قيادة جان كبلسكي وأماندا ليفيت، وهو أسلوب في العمارة يستلهم أساليب بناء مستعارة من مهن أخرى مثل هياكل السيارات أو الصواريخ أو البواخر.
العنوان التالي سيكون مستقبل التوسع في الاتحاد الأوربي، وبعدها سيكون العنوان هو مستقبل الأرض. وهذه عينة مبدئية أولية، ليست شيئا في نتائج تصل إلى اكثر من مليار بعدة ملايين.
لكن هذا يوضح لنا بجلاء أن الغرب ليس فقط مهتما بالمستقبل، بل مهموما به، يتعامل معه كأنه واقع موجود، وليس مجرد ضباب مشوش لاحتمالات غير معروفة كما هو شأن تعامل ثقافتنا العربية مع المستقبل.
ودلائل التعامل الغربي مع المستقبل كثيرة، شواهدها لا تقف عند حدود المواقع الإلكترونية أو الواقع الافتراضي. فالأخبار تملأ الصحف عن محاولات الولايات المتحدة الوصول إلى المريخ، وإيجاد فرصة للحياة عليه، وأن يصبح ربما أول ملكية بشرية خارج نطاق الكرة الأرضية، كما نسمع يوميا اليوم عن التطور الكبير الذي يشهده الجيل الجديد من الروبوتات الآلية التي ستكون ذات قدرات أكثر كثيرا مما سبقها وسوف تكون لها هيئة أكثر إنسانية، في الوقت نفسه الذي بدأت فيه تجارب الأنسال، أو البشر الذين يتم تزويدهم بشرائح إلكترونية داخل أجسامهم تتصل بنظامهم العصبي. وهي مرحلة جديدة من أجل تطوير القدرات البشرية في سبيل الوصول إلى إنسان جديد أكثر قوة وتحضرًا.
وفي الطب والكيمياء والفيزياء والهندسة الوراثية نرى ونسمع كل يوم عن تطبيق علمي جديد، وكلها في النهاية نتاج اهتمام حقيقي بفكرة المستقبل وبناء هذا المستقبل والتحرك باتجاهه وليس الابتعاد عنه كما هو شأن ثقافتنا العربية التي تعيش دوما في ماضيها التليد، ولا تريد أو ترغب في أن تتحرك لتبتعد عنه على أي نحو.
النظر تحت موقع القدم
في محاولة لجرد ما يهتم به أغلب من يقعون في دائرة اتصالي على موقع الشبكة الاجتماعية Face Book، تبين لي بسهولة، أن الغالبية العظمى مما يطغى على اهتمام أعضاء هذه الشبكة هو الواقع الراهن الآني، وأغلبه يأتي في سياق النقد للممارسات السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وللحكومة التي يمثلها هذا الفصيل. هناك بعض المواد التحليلية الجيدة التي يكتبها عدد من شباب المثقفين، لكنها تكاد تكون محدودة.
لكن لا توجد رؤى تكشف قدرة على استجلاء مستقبل المجتمعات العربية في ضوء ما يحدث الآن من تغييرات. لاتوجد تعليقات تهتم بالخيال أو بالتركيز على موضوعات أساسية للمستقبل مثل التعليم أو العلوم.
لن تجد أحدًا يشارك البقية رابطًا علميًا من صحيفة أجنبية أو عربية، إلا فيما ندر. كما أنك لن تجد شخصًا يشارك، على صفحته الشخصية، أو يرفع رابطًا يتناول قضية التعليم مثلًا، والتي أظنها قضية الساعة الآن، في ضوء ما كشفته الانتفاضات وحركات التغيير والثورات العربية، من حجم رهيب للجهل والتخلف، الذي ترفل فيه قطاعات واسعة ليس فقط من الأميين، بل من نسبة كبيرة جدًا من المتعلمين أبجديًا، لكنهم يرفلون في أمية ثقافية وحضارية وديمقراطية وليبرالية، لا يعلم مدى فداحتها وبشاعتها إلا الله.
المثقفون الذين يفترض أن يلهموا الشعب والثورة، لن تجد لديهم رؤى مؤثرة وقوية لكيفية التعامل مع ما يحدث في الواقع السياسي، ولا في كيفية توجيه التكتلات السياسية المدنية في كيانات منظمة قادرة على العمل ومواجهة محاولات تمكين السلطة للإخوان في مصر. والآراء السائدة لا تعبر عن اختلاف في الرؤى بقدر ماتعبر عن تشتت وعدم قدرة على الحشد. والحقيقة أن توفير رؤية مستقبلية واضحة لما يريده المثقفون والثوار وقوى التغيير المدنية يحتاج إلى خبرات ما يطلق عليه علوم المستقبل التي مع الأسف لا تتوافر لدينا. وليس هذا فحسب بل إنها إن توافرت فهي لا تزال تعاني تناقضات كبيرة في رؤى من ينظرون إليها.
ولنأخذ مثالًا واحدًا، يمكن لمن يرغب أن يطلع عليه في الفضاء الافتراضي، هو موقع موسوعة اويكيبدياب الشعبية الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
عند البحث عن مصطلح اعلوم المستقبلب سنجد بداية هذا التعريف: اخلال الثمانينيات والتسعينيات تطور علم دراسات المستقبل، ليشمل مواضيع محددة المحتوى وجدولا زمنيًا للعمل ومنهجًا علميًا، يتحدث مع عالم اليوم، الذي يتسم بتغيير متسارع.
علم المستقبليات أو االدراسات المستقبليةب هو علم يختص بـاالمحتملب واالممكنب واالمفضلب من المستقبل، بجانب الأشياء ذات الاحتماليات القليلة لكن ذات التأثيرات الكبيرة التي يمكن أن تصاحب حدوثها. حتى مع الأحداث المتوقعة ذات الاحتماليات العالية, مثل انخفاض تكاليف الاتصالات, أو تضخم الإنترنت, أو زيادة نسبة شريحة المعمرين ببلاد معينة، فإنه دائما ما توجد احتمالية الا يقينب (بالإنجليزية: Uncertainty) كبيرة يجب ألا يستهان بها. لذلك فإن المفتاح الأساسي لاستشراف المستقبل هو تحديد وتقليص عنصر الا يقينب لأنه يمثل مخاطرة علميةب.
علم غربي
ثم يستعرض الموقع المبادئ الأساسية لعلم المستقبل ونماذجه قبل أن يتوقف عند إشكال أساسي يرى أن نشأة علم المستقبل هي نشأة غربية: انشأت الدراسات المستقبلية، أو علوم المستقبل بشكلها الحالي نشأة غربية، وترتب على هذا عدة نتائج يتوقع بروزها في الكتابات العربية، فنشوء الدراسات المستقبلية في الغرب تترتب عليه عدة ردود فعل ما بين متريب، مندهش، معجب، ورافض، ومن يريد أن تكون لدينا مثل هذه الدراسات لنفس الدواعي، أو لنفس الأهداف، أو لدواعٍ وأهداف مختلفة، ومن ثم تظهر المواقف الرافضة تمامًا، المنبهرة تماما، الاستطلاعية، المهتمة الناقدة، التوفيقية، المؤصلة.. الخ. كل ردود الفعل تلك من المتوقع أن تنعكس على خريطة التصنيفات والتوجهات في الكتابات التي حاولت أو تحاول التعريف بدراسات المستقبلب.
ثم يستعرض المواقف المتعددة من الدراسات المستقبلية بين الرفض والقبول، مميزا بين عدد من الاتجاهات التي تلقت فكرة علوم المستقبل وفقا لرؤى ومنطلقات مختلفة فيذكر الموقع: ايمكن التمييز بين عدد من الاتجاهات على النحو الآتي:
- اتجاه يسعى للتعريف بها كما نشأت في سياقها الغربي.
- اتجاه ينقل تعريفها ومراحل التغير والتحول التي مرت بها بهدف التعريف بها.
ويبدو هذا الاتجاه بدهيًا، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الدراسات المستقبلية بشكلها الحالي نشأت وانتشرت في السياق الغربي، ومن ثم يكون طبيعيًا البدء بالتعريف بها في سياقها.
- اتجاه ينقل المفهوم ومراحل التحول من أجل التعريف أولًا والدعوة لتبنيها كما هي ثانيًا.
ويلاحظ أن التفريق بين الاتجاهين هو تفريق لغرض التحليل، إذ عمليًا قد يصعب تحديد ما إذا كان الكاتب يدعو ضمنًا إلى تبني الدراسات المستقبلية الغربية بنفس المفهوم والمنهج ولنفس الدواعي والأهداف أو لا، حيث إن نقل المفهوم دون نقده قد يفتح الباب لفهم ذلك الموقف على أنه قبول للمفهوم، أو قبول المفهوم يعني الموافقة على مضمونه ومحتواه ودواعيه وأهدافه.
- اتجاه يبرز اهتمامًا بكيفية تبني الدراسات المستقبلية: وهو يقرن بالاعتراف بأهمية الدراسات المستقبلية أيضًا أهمية الأخذ في الاعتبار عنصر الملاءمة وأهمية التأصيل.
- اتجاه يحمل في ثناياه محاولة التوفيق، (إن صح التعبير)، وبيان أهمية الدراسات المستقبلية، فهو في معرض التعريف بالدراسات المستقبلية يحرص على أن يؤكد أنها ليست محاولة تنبؤ أو افتراء على الغيب (ويلاحظ هنا تكرار التأكيد على أن الدراسات المستقبلية لا تنافي الإيمان بالغيب وبالقضاء والقدر)، ويشير إلى أهمية وحاجة العالم العربي، الإسلامي، العالم الثالث إلى تطوير (دراساته المستقبلية).
- اتجاه يحاول التأصيل و/أو تسكين الدراسات المستقبلية كمفهوم وكمجال دراسة في إطار رؤية إسلامية للمستقبل ويعبر عن ذلك مثلًا المركز الإسلامي للدراسات المستقبلية والأهداف التي وضعها له وينعكس ذلك في الفصلية التي يصدرها، وهو لا يمثل المساهم الوحيد في هذا المضمار سواء في محاولة التأصيل أو الدعوة لأهميته.
ثقافة الهزيمة وعقدة الاضطهاد
وأظن أن هذا التعارض في الاتجاهات هو في حد ذاته يمثل أزمة الثقافة العربية في قدرتها على التعامل مع المستقبل. هذه المشكلة تعود ليس فقط لأزمة التعليم العربي التي أخرجت أجيالًا عديدة من المتعلمين الذين اعتادوا مناهج التلقين والحفظ والنقل بلا أي عقلية ناقدة أو قادرة على الابتكار وطرح الأسئلة، بل تعود كذلك لثقافة نشأت في ظل الاستعمار، واعتادت أن يخطط الآخرون ولا تقوم هي إلا برد الفعل، وإذا أرادت أن تكون فاعلة فكل قدرتها على الفعل لا تزيد الشك وتقديم نظريات المؤامرة، وتبرير كل مظاهر التخلف وعدم الابتكار والتأخر وغيرها، بحالتها على قوى خارجية أو داخلية أخرى. ومثل هذه العقلية بالتأكيد لا يمكنها أن تشعر بالقوة الفردية والإرادة الحرة التي تعد العمود الأساسي للابتكار والقدرة على الخيال، وهما عماد صناعة المستقبل.
والنتيجة أنه حتى فيما يتعلق بفكرة المستقبل سنجد خلطا بين مفاهيم يفترض أنها لا تعني الشيء نفسه مثل الوعي بالمستقبل وتخطيط المستقبل والفكر الاستراتيجي والدراسات المستقبلية.
وهذا إشكال يمتد إلى أفكار أخرى تناولت علم الاستقبال ورأت أنه ليس علما مستقلا بذاته مثل علم الرياضيات، بل علم يقترن بعلوم أخرى كالاجتماع مثلا، حيث يرتبط مع العديد من الفروع العلمية الأخرى، وهي طروحات نجدها لدى كل من المهدي المنجرة مثلا وأحمد صدقي الدجاني.
وفي الجدل حول موضوع المستقبليات وربطه بالعلوم الإسلامية ثمة مشكلات عديدة منهجية أخرى تربط بين علم المستقبل والتنبؤ على سبيل المثال. وبالتالي فنحن في الحقيقة نحتاج بالفعل إلى أن تصبح دراسات المستقبل قوة ضاربة في حياتنا، لأن ذلك يقتضي هز مواطن ضعف ثقافتنا التي تعتمد على تراث يفضل العودة للماضي والركون إليه، خوفا من المجهول، الذي يمثله المستقبل هنا.
إن الفارق الأساس في مفهومنا عن المستقبل مقارنة بالغرب أن الأخير يرى في المستقبل والوصول إليه وتحقيقه مضيًا وتقدما للأمام لا مفر منه، وخطوة رئيسة في إحساس الثقافة الغربية بضرورة السيطرة على مصيرها، وفرض إرادتها على ذلك المستقبل، بينما نركن نحن لفكرة التواكل على القدر. والبحث عن مبررات للضعف والتوقف والتردد والخوف وقلة الحيلة وضعف الإمكانات والكفاءة.
والمستقبل هنا لا يعني فقط دراسات المستقبل والاهتمام بها في شكل أكاديمي، بل تمهيد الطريق بحيث يصبح الاهتمام بالمستقبل جزءا من ثقافة عامة لدى الجمهور، بالإقبال على العلم والعلوم، وتوسيع دائرة الاهتمام به، والاحتفاء بالعلوم في شكل احتفالات مهرجانية شعبية، وتوسيع دائرة استقبال الأخبار العلمية التي يتداولها الغرب اليوم والتي تبدو كل منها فتحا جديدا للبشرية وتمهيدا لشكل مختلف تماما لحضارتنا البشرية سوف تعيشه في المستقبل القريب، والاحتفاء بالخيال والابتكار، وترسيخ أفكار عن التنمية المستقبلية لدى الجمهور، وإقبال الأدباء على الخيال العلمي، وغير ذلك.
فباليقين بالمستقبل ووجوده بالشكل الذي يمكن أن يتم تخيله عليه نجح الغرب في التغيير والارتقاء في سلم الحضارة البشرية، وهو ما ينبغي أن يكون قدرا مستقبليا لنا وإلا فلن يكون لنا مكان في المستقبل بلا أدنى مبالغة .

