مشكاة الذات بين الاعتراف والشهادة
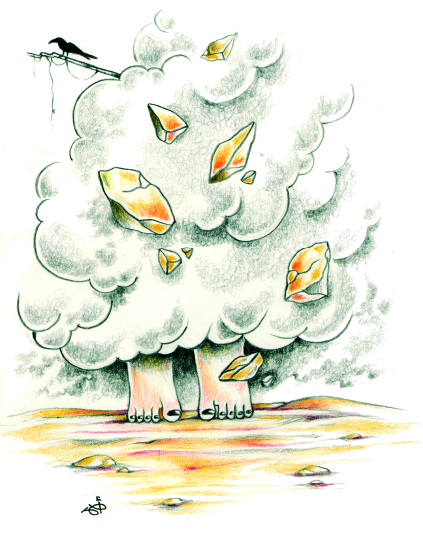
في أدب الرحلة والكتابة الذاتية عمومًا، يواجه الكاتب المعاصر كثافة حضور الآخر وأبعاده المتفرقة، بالاعتصام بسرود ذاتية، تتوالى في سياق من التذكر والاستدعاء، ووضع النقيض إزاء النقيض، وهي - وإن تشعّبتْ وجهاتها - تنهل في مجملها من رافدين أساسيين، هما: النشأة الأولى، والحياة العلمية وما يتصل بها من حيوات، ولعلّ أخصب هذه السرود ما قارب الوجدان، وأظهر الجانب «الجوّاني» من شخصية السارد، وحين يصّاعد السرد ليصلَ إلى جسارة المكاشفة والاعتراف، والإفضاء بما تُكنّ السريرة، بعيدًا عن مهادنة الواقع المتحالف مع المداراة والتعمية والإنكار.
يقتضي الوقوف على طبيعة الذات الانفصال - ولو قليلًا - عن الواقع المعيش، وحثّ الخُطى نحو أبعد نقطة يمكن أن تصل إليها الذاكرة؛ لاستحضار أحداثها وانفعالاتها، بوصفها درعًا ذاتية للثبات والحماية من طغيان الواقع وسطوته، والطفولة منطلق التكوين الخلقيّ والنفسي والروحي، وملاذ يتم اللجوء إليه كثيرًا في السرد بنوعيه، الواقعي والمتخيل، الموضوعي والذاتي، لهذا احتلت مرحلة الطفولة في فضاء السيرة الذاتية مساحة مهمة؛ لأن عواقب سرد تفاصيلها في الغالب مأمونة.
عهد الطفولة والسارد
وعهد الطفولة في كتاب «أيّامي في برلين» للأديب محمد متولي، هو منطلق الإحساس بالتميز لدى السارد، فيتذكر اشتراكه في الرحلة إلى مدينتي الأقصر وأسوان البعيدتين جدًا عن بلدته في شمال الدلتا، حين أجفل جميع زملائه بالمدرسة عن الاشتراك فيها. وكيف كان يشقُّ ظلام الطريق المرعب وحيدًا؛ ليصل إلى درس الأستاذ نجيب، حيث حلاوة درسه التي لا يعدلها شيء، وينازع الألم بعض مشاهد الطفولة، ويسهم - بدرجة من الدرجات - في تكوين وعي السارد بنفسه ومجتمعه، فحين يذهب العمُّ بالطفل الصغير أو السارد إلى المدينة في سفرة نادرة إبان حملة انتخابات مجلس الشعب، يبهره لمعان صور المرشحين وكثرتها تحت أعمدة الإنارة، وعلى واجهة السوبر ماركت، ثم يهمّ بنزع واحدة من هذه الصور، ليعود بها إلى القرية مزهوًا ببهائها وألوانها - كما أي طفل «أخضر القلب»، بتعبيره - وفي هذه اللحظة يلوذ بالسرد للإفضاء بهذه الاعترافية:
«ما إن هممتُ بنزع الصورة حتى هجم عليّ طفل في نفس سني تقريبًا، وركلني ركلات شديدة، ما زلت أشعر بألمها حتى الآن كلما تذكرت هذا الموقف الأليم، وسبّني سبابًا مقذعًا، ورماني بأنني من أعداء الحزب الوطني، ومن معارضي الزعيم المرشح العظيم، وأنني أريد تدمير دعايته الانتخابية والعبث بصورته. (كما فعل أبو السعد مع سيد بيه الحنش) آلمني ركله وسبابه، فتركته، وتركت الصورة مدلاة على الجدار لم يكتمل نزعها! ودخلت السوبر ماركت أكتم دموع الألم، وأخذني الخجل وغلبني حياء عظيم أن أشكو لعمي ما كان من هذا الطفل اللعين وطويت صدري على مرارة عظيمة. فما كان لابن القرية إلا أن يشعر بالصَّغار حين يزهو عليه أبناء المدينة؛ وليس له هناك فئة ينصرونه. ولا شك أن هذا الطفل اللعين لم يكن يفهم شيئًا في السياسة والانتخابات لكنه سمع أحاديث الناس في الأزقة على المقاهي المجاورة» (أيامي في برلين، ص 242).
القرويّ المقهور
ليس غريبًا، مع حميّا السرد الاعترافي، أن يتقاسم قارئ ما مع السارد وطأة الشعور نفسه الذي تخلّفه مثل هذه المواقف، بل ربما أحس بوقع «ركلة غبية» بعثتها ذاكرة القراءة: ألمًا نفسيًا، ومرارة، وإحساسًا بقهر ابن المدينة لابن قريته، والقوي للضعيف، والعُصْبة للوحيد المترقّب، وعندها يدرك القارئ أيضًا، أنه ليس وحده في هذا العالم، لكن السارد حين احتوى الحدث بالسرد والسخرية الممرورة، لم يكن ذلك من أجل جلد الذات، وإنما كان سعيًا نحو التجاوز والتخطي، وأحسب أن هذه الدلالة النفسية من الوضوح بمكان، فلا حاجة إذن إلى الاسترسال في مقولات علمي النفس والاجتماع.
من اللافت أيضًا، تقاطع هذه السردية الاعترافية مع اعتراف قريب من قريب، تجاوز قرنًا من الزمان للشاعر الناثر عبدالرحمن شكري (ت. 1958م)، سجله في كتابه الرائد «الاعتراف» الصادر عام 1916م، يقول شكري:
«وإني لا أزال أذكر ذلك اليوم النحس الذي لطمني فيه شقي، لم يكن يدري مبلغ إساءته إليّ، فرفعت يدي لألطمه كما لطمني، لكن الجبن وأخاه الحزم همَسَا في أذني قائلين: إنك إذا لطمته لطمك مرة ثانية، وهو أقوى منك فلا تصيبه إلا ببعض ما يصيبك، فخير لك أن تتحمل اللطمة الأولى، أن تنجو سليمًا، فوقعت يدي إلى جانبي، وأحسست أن روحي قد سُلبت أجلّ شيء فيها، فنظرت إلى بين قدمي لأرى ما سقط منها، من العزة والأنفة والشجاعة، فجعلت أعدو من الغيظ وقد اسودت الدنيا في عيني، وجعلت أنظر إلى المارين وهم ينظرون إليّ، فأرميهم بلحاظ المقت والكره، لأني كنت أحسبهم يسخرون بي ويعرفون ما حدث لي، ويفهمون سر روحي التي قد أهينت، ولم تعد تصلح للحياة، ثم وقفت على غدير وهممت أن أرمي بنفسي فيه، لكني هزئت بنفسي وسخرت منها، تلك النفس التي تفرّ من اللطام إلى الحمام، ثم ذهبت إلى البيت وأنا أرتعد، وقد جحظت عيناي وملأ الغل قلبي، فجعلت أقرض أسناني من الغيظ، حتى تكسّر بعضها». (المؤلفات النثرية الكاملة، ص80).
تعالى الساردان (شكري ومتولي) على مشاعر الخجل والانكسار إزاء الموقفين المتشابهين العصيبين، ولجآ إلى التنفيس السردي - إذا جاز التعبير - والإفضاء ببعض صور الاستقواء المقيتة التي تعرّضا لها في مرحلة الطفولة، وهي تعبير مرير عن استمرار ظاهرة «التنمر» الاجتماعي، رغم مرور عقود طويلة من السنين على الموقف الأول، ولتظلّ هذه المكاشفة علامة مهمة في سبيل السالكين نحو معالجة أدواء المجتمع، ومواجهة النزوع السلوكي الشائن لدى الأجيال المتلاحقة، للوصول إلى التنشئة القويمة.
جناية العنف (اللطم أو الركل) من الأقران واحدة على نفسية الطفلين، في المحصلة الأخيرة، ذكرى مؤلمة قاسية لا تنسى، فيأتي الملفوظ مؤكدًا «وإني لا أزال أذكر...»، ومستمرًا في الحضور «ما زلتُ أشعرُ بألمها حتى الآن...». لكن الساردين (شكري ومتولي) يفترقان في بعض عناصر الحكاية، وفي الأثر النهائي، فسردية متولي تستحضر الموقف بتفاصيله الواقعية الدقيقة، والشخوص على اختلاف أدوارهم، وطبيعة المكان وصوره؛ أما سردية شكري فتتراجع فيها تفاصيل الشخوص والمكان، ويتقدم التحليل، واستبطان الأبعاد الداخلية للسارد أو الشخصية الرئيسة، ويتبدى مكان الحدث مكسوًا بغلالة ضبابية.
ثم ينتهي الموقف لدى متولي - رغم الإحساس بالقسوة والألم - بقدر وافٍ من الاستيعاب والتجاوز، والاستعانة بخيوط دقيقة من السخرية، والسخرية دفاع نفسي فعال (... هذا الطفل اللعين لم يكن يفهم شيئًا...!)، أما شكري فقد خلّف الموقف العصيب نفسه حطامًا، وأنهك روحه من الغيظ والغلّ، و«عصفت به أسئلة عزة النفس، والثورة على الانكسار، والحاجة الملحة إلى الانتقام، فجاء الموقف النقيض، وكأنه انتقام من الموقف السابق، ورد فعل لا يقل عنفًا وطيشًا وشقاء، فبادر بلطم أحدهم عندما احتد الجدال بينهما خوفًا من أن يبدأ هو اللطام، لأن «المبادرة نصف الظفر».
تتحرك السرود الذاتية من دائرة الاعتراف بمعنى إظهار جوانب خفية من حياة السارد، إلى دائرة الشهادة على الآخرين والتنبيه إلى مواطن الخلل المجتمعي، وهي الدائرة التي تضم سرود الحياة العلمية في القاهرة وفي أوروبا، والشهادة السردية - في حقيقتها - لا تخص السارد وحده، وإنما تخص جيلاً كاملاً عاصره، واصطلى معه بوقائع العصر، ولا تزال تلك الوقائع فاعلة، ومؤثرة في المشهدين العلمي والثقافي.
الجامعة صدمة السارد
والسارد لا يخفي الأثر البليغ الذي تركته في نفسه الجامعة «وأخلاق من فيها»، وكانت واحدة من صدمتين ثقافيتين تعرّض لهما: الانتقال من القرية إلى القاهرة، والسفر من القاهرة إلى برلين، وتتعدد الأماكن مع هذه السرود، فبالإضافة إلى دار العلوم، هناك المدينة الجامعية، وقطار دمنهور، وبين السرايات، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعلى الشاطئ الآخر معهد الدراسات العربية ببرلين، ومدرسة تعليم الألمانية للأجانب، وأمستردام، ومدريد.
تصحب الأماكن سرديات تتنوع طولًا وقصرًا، وتأخذ وجهات توثيقية ونقدية وتحليلية، منها ما يصور حال الطالب «الدرعمي» داخل قاعات المحاضرات، ومنها ما يرصد مشاهد من مدينة رعاية الطلاب ببولاق، ومنها ما يعالج حَرْفية بعض الأساتذة في الدراسات العليا، وتعلّقهم بالأمور الشكلية، ومنها ما يحتل فصلاً كاملاً من فصول الكتاب، ليكشف جوانب مثيرة عن السكن الجامعي المشترك في برلين.
تذرع هذه السرود وغيرها صفحات الكتاب من بدئه إلى ختامه، إلا أن هناك هامشًا مهمًا عن علاقة الطالب/ السارد بالأساتذة (الكبار)، وأسلوب التسجيل العلمي، وأجواء السينمار، هذا الهامش يمثل شهادة على حالة متجددة بصور مختلفة، مكتنزة بالدلالة، ومثقلة بالمرارة؛ فخطة الدكتوراه أو الماجستير ترفض بشدة، ليس لأسباب علمية أو موضوعية، وإنما لمنازع شخصية، ومطالب خاصة، بل إن تقرير مصير البحث وصاحبه معا يرهن بالصراعات بين الأساتذة، وتصفية الحسابات التي لا تنقضي عجائبها، يقول:
«... حتى إن أحدهم هددني بالفصل من القسم، وأنني لن أسجل للماجستير مهما حدث، لا في هذا الموضوع الذي اخترته ولا في غيره، ما دمت أريد التسجيل مع هذا الأستاذ الذي هو على خلاف شخصي معه! عانيت من هذا طويلاً حتى كادت الصورة النبيلة التي رسمتها للأستاذ الجامعي تحترق بين ناظري! لكنني لم أتخل يوما عما آمنت به من مبادئ أفكار!!» (أيامي في برلين، ص 177).
في كل الأحوال، سواء أكان السرد اعترافًا أم شهادة فإنه لا ينفصل عن الذات، وسرود «أيامي في برلين» تتصل - بأوثق اتصال - بشخصية السارد وأفكاره، كما تتصل بالذات الجمعية في حراكها المجتمعي الفاعل، وحركتها الدائبة التي لا تتوقف لتنظر وتراجع وتحلل، وتقوّم، هنا تتقدم الكتابة الذاتية لتقوم بمهمات تاريخية واجتماعية وتربوية، تقوم بها وفق شروط الفن وتقاليده المرعية، ومع هذا، فبوسعي ألا أتوقف بمهمة الكتابة السردية الذاتية عند هذا الحد الذي يخص مجتمعًا بعينه أو بيئة من البيئات، ففي ظل التواصل اللامحدود بين أجزاء الأرض وأطرافها، ومع تحوّل العالم الفسيح إلى قرية صغيرة إدراكًا واتصالًا، وتدفق المعرفة تدفقًا هائلاً بين يدي الإنسان المعاصر تأثيرًا وتأثرًا، عبر تكنولوجيات متجددة متلاحقة في ظل هذا كله، فإن السرد الذاتي الكاشف لا يمكن اعتباره محليًا، لا يعني شيئًا للآخر البعيد أو القريب، وبالتالي لا يمكن عدّه مشكلة مضافة إلى مشكلات الوجود والاجتماع، والتغاضي عن قدرته على الإسهام في تحليل المشكلات أو حلّها، فالسرد، وإن أوغل في المحلية، فهو لا يخلو من شيات عالمية.
إن السرد في تقدير الناقد الأمريكي «هايدن وايت»: «معطى إنسانيّ كوني، يمكن على أساسه نقل الرسائل عبر الثقافات حول طبيعة واقع مشترك»، وهو تأكيد لتصور سابق لـ «رولان بارت» عن السرد، إنه «موجود ببساطة كالحياة نفسها... أمميٌّ، وعابر للتاريخ وللثقافات»، وربما كان السر الكامن وراء عالمية السرد، هو ذلك القدر المعتبر من العفوية، وأن السرد ينشغل بالموضوع قبل الكلمات التي تتحرك بالموضوع وفق تصور فني يتقصّده الكاتب. وهذا بخلاف الشعر مثلَا، فالكلمات في الشعر - بوصفها غاية جمالية - تتقدم على الموضوع، وشكل القصيدة آسر لفكرتها ومنطلق بها ■

