البيان العربي - الإسلامي خصائصه والعوامل المؤثرة فيه
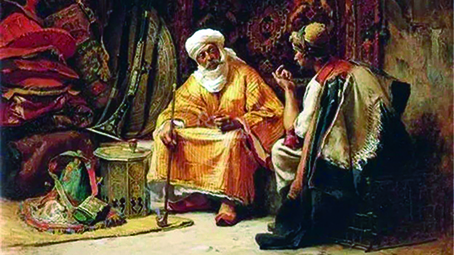
البيان العربي هو ما صدر عن الأعراب من إنتاج شعري ونثري قبل الإسلام وفي عصر الدعوة وصدر الإسلام، ثم في العصور التالية حينما استقر المسلمون في الأمصار الجديدة، وقد شارك في الإنتاج الأدبي بجميع أجناسه الشعرية والنثرية أفراد الأمم التي دخلت الإسلام وتعلمت لغة العرب وحفظت أشعارهم وأمثالهم وأقوالهم المأثورة، واستوعبت معاني كتاب الله الذي لا تبلى معانيه ولا ينضب معينه الفياض بالهدى واليقين، وكذا أحاديث رسول الهدى عليه السلام الذي أعدَه الله إعدادًا كاملًا ليواجه قومًا لدًا كانوا يصبحون ويمسون على الكلام البليغ الفصيح.
هذا البيان تغذّى من بيئة الأعراب ومن الكتاب المحكم وأحاديث أفضل من نطق بالضاد، وكل ما صدر من أفراد تلك الأمم بلسان عربي هو من هذا البيان الذي عمّ الكون بلغة عربية فصيحة بليغة وصور فنية بديعة تحمل نفحات القرآن العظيم والهدي النبوي الشريف اللذين قادا البشرية إلى طريق السعادة والاطمئنان الروحي والنفسي، ولهذا السبب تجد عند كل الشعوب العربية والإسلامية في مناهجهم الدراسية شعر الجاهليين وأمثالهم وحكمهم، والبيان القرآني والنبوي، فأصبح هذا البيان يجري في تلك المجتمعات مجرى الدم في العروق، فازدادت اللغة العربية وبيانها مع الأيام صمودًا وثباتًا في كل قارة أقام فيها من يتقن اللغة العربية وآدابها؛ وإذا استعرض الباحث أدب العربية في كل العصور التاريخية يجد خصبًا في العطاء ووفرة في الإنتاج حتى في العصر الذي سمّوه عصر الانحطاط، فقد ظهر فيه شعراء بارزون وكتاب ومبدعون ملكوا ناصية البيان فأبدعوا أدبًا رفيع المستوى، احتوى على معان طريفة وصور بديعة وحكم بالغة الدلالة مثلما أبدع شعراء وكتاب العربية في العصور الذهبية.
ظروف نشأة البيان العربي
إن الدارس لا يمكنه أن يعرف جوهر البيان العربي الإسلامي إذا لم يطلع على الظروف التي نشأ فيها والتطور الذي مرّ به بدءًا من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث، إنها مرحلة طويلة من الإبداع والتأثير والتأثر بالبيئة والثقافات الدخيلة على المجتمعات العربية الإسلامية والصراعات السياسية وما عرفته هذه المجتمعات من تطور في العمران وتقدم في العلوم، عوامل كثيرة تداخلت فيما بينها لتعطي الصورة التي كان عليها البيان في كل زمان ومكان، لأن البيان يصدر من الكائن البشري الذي يتفاعل مع بيئته الطبيعية والثقافية والفكرية، فالدارس حين يقرأ شعر زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي يجد فلسفة وحكم الإنسان الجاهلي الذي كره الحروب التي لا تجني منها القبيلة إلا الخراب والقتل الذي لا ينجو منه الصغير والكبير، فيدرك أن السلم محبّب للنفوس، وأن حياة الإنسان أسمى من كل ما يقع الصراع عليه من ماديات مهما بلغت قيمتها، لذلك تجدنا نردّد شعره بإعجاب في عصر الازدهار الحضاري والتقني.
البيان العربي الجاهلي: امتداد وتأثير
إذا وقف الدارس على مضامين البيان عند الشعراء والخطباء الذين عاشوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام فإنه يجد أثر البيان الجاهلي قويًا في إنتاجهم الأدبي، فهذا الشاعر الحطيئة الذي خبر الحياة في العصرين الجاهلي والإسلامي نرى في شعره جزالة في الألفاظ، وقوة في المعاني، وجمالًا في التصوير، وتقلبًا في المواقف والرؤى مثلما نجد في شعر كثير من الجاهليين، فتراه يمدح أجود المدح إذا أغدق عليه الممدوح المال الغزير، ويهجو مرّ الهجاء إذا حرم من المال لأن الزمان كان أشد قسوة عليه، فالفضائل عنده تقاس بالغنى واليسر، ولم يسلك هذا المسلك إلا لأنه كان نهمًا ومضطرب النفس لا يستقر على حال، فصورة البيان التي يراها الدارس عند هذا الشاعر قد تختلف عن شاعر آخر ولو عاش في زمانه وبيئته نتيجة قناعة كل واحد منهما بمثل وأخلاق وسلوك معين، وإذا اختلف الشاعران في تصورهما للحياة فقد يتفقان في جودة الإبداع من حيث جزالة اللغة وسلامة المعاني وحسن التصوير لأن البيان الأصيل الذي تعلموه من بيئتهم متجذر في عقولهم ووجدانهم، فخصائص البيان الجيد تجعلك تقف على ألوان متعددة من الأمزجة والعقليات عند الشعراء والأدباء والمفكرين ولو جمعهم عصر ومكان واحد لأن الأدب يصدر من كائن حيّ يتفاعل مع بيئته وثقافة عصره ونظرته للوجود.
إن البيان العربي الإسلامي الذي نشأت بذرته الأولى في بيئة صحراوية لا تجود على أصحابها بمقومات الحياة إلا بالنزر اليسير من عشب وماء وخضرة وطعام، ولم ينعم فيها الإنسان بالأمن والاستقرار، ولم تسعفه بالمقومات التي تقوم عليها الحضارة بالبنيان والتعمير، لكنه رغم كل ذلك ظل يسعى لتخليد نفسه وتقاليد وأعراف مجتمعه بالكلمة التي جرت على لسانه كشلال عذب الماء، غزير العطاء، مليء بالحكم والتجارب التي استقاها من مجتمعه، فكانت تلك الكلمات معبّرة بصدق عن واقعه في كل ما صور وأبدع لتريح أذنه التي تعشق هذا البيان وتطمئن قلبه التواق للجمال، وتعينه للتغلب على مصاعب حياته الشاقة في بيئة قست عليه. وسيزداد هذا البيان تألقًا وبهاء حينما خاطب الله العرب بلغتهم وأسلوبهم وصورهم البيانية، فرأوا بيانًا أسمى من بيانهم ولغة أجزل من لغتهم ومعاني محكمة فاقت ما بلغوا إليه بعد تجارب طويلة، وأخبارًا موثَقة ومواعظ بالغة الدلالة في الهدي والإرشاد والتنوير، لقد عرفوا من خلالها أنهم كانوا يسيرون في طريق مظلم، ثم اكتسى هذا البيان حلة بديعة من بيان المصطفى الذي لم ينطق العرب بمثل منطقه وبيانه فصاحة وبلاغة وسموًا في الهدي والرشد، ذا التكامل الذي ازدان به البيان العربي ليجمع بين إبداعات الأعراب والكلام المعجز وأقوال من أوتي جوامع الكلم لم تستطع الأعوام والدهور أن تطفئ بريقه، بل ازداد توهجًا على مر الأيام، وتفرعت أغصانه، ونضجت ثماره لتصير حلوة عذبة رائقة الجمال والبهاء، مخضرة على الدوام.
والدارس لهذا البيان في مختلف العصور ينهل عصارات من بيئات متعددة وعقليات متنوعة وثقافات مختلفة، فيجد فيه كل ما كان يتطلع إليه العرب من كرم وشجاعة وإقدام وحلم، وما دعاهم إليه كتاب الله من تسامح ونبل وأخلاق وهدي وإرشاد، ويرى بين ثناياه ثقافات الأمم التي دخلت الإسلام بعد الفتوحات الكبرى، وكان لها فكر عميق في الفلسفة والمنطق والطب والهندسة والسياسة والاقتصاد.
ولكي تتضح لنا صورة البيان العربي الإسلامي في أتم كماله لا بد من الوقوف على مرحلة نشأته وتطوره عبر العصور، والعوامل التي أثرت فيه ليصل إلى هذه المكانة التي نراها في عصرنا الحديث بواسطة اللغة العربية التي ستظل محفوظة بفضل كتاب الله وجهود العرب والمسلمين الناطقين بها .
خصائص البيان العربي في العصر الجاهلي
هذا البيان أنتجه عرب الجاهلية في كل ما أبدعوا من شعر وخُطب وحكم وأمثال وأقوال مأثورة بلغة عربية سليمة في تراكيبها ودلالتها ونحوها وصرفها وأوزانها، إنه إنتاج أدبي وفكري عبّروا فيه عن أحوالهم الاجتماعية والنفسية، ووصفوا فيه طبيعتهم الصحراوية بوحشتها وأنسها وواحاتها وحيواناتها الأنيسة والضارية، فجاء كل ذاك الإنتاج معبِّرا بعفوية وصدق عما عانوا في تلك البيئة من قسوة الطبيعة وظلم الأقوياء للمستضعفين، جاء بصور بديعة وعواطف جيّاشة بالحب والألم والحرمان انبعثت من نفوس مكلومة تبحث عن العيش الرغيد والأمن والأمان في بيئة حرمته من كل ما يسعده إلا ظلم الظلمة واعتداءات المعتدين؛ في هذا الوضع نما البيان العربي عند الإنسان الجاهلي، وتفرعت أغصانه لتعطي ثمارًا ناضجة في كل جنس من أجناس القول التي عرفت في هذا المجتمع لاسيما الشعر والرجز والخطابة والأمثال.
إن اللغة التي صيغ بها هذا البيان وهي العربية الفصحى بلغت مبلغًا عظيمًا في مستوياتها الدلالية والتركيبية والصرفية، وهذا يدل دلالة قوية على أنها قطعت أشواطًا كبيرة في تطورها قبل أن تصبح لغة الشعر والخطابة لأن ظهورها في الإنتاج الأدبي بهذا النضج والكمال لدليل قوي على أنها عرفت أطوارًا متعددة قبل هذا الاستواء ليعبر بها الشعراء والخطباء عن أغراض متنوعة، ولتكون لغة التواصل بين القبائل والقرى العربية الممتدة في جزيرة العرب، ولتصبح لغة الأدب في الأسواق الأدبية التي كانت الوفود تأتي إليها من كل جهة لتستمع إلى الشعراء والخطباء وهم يلقون إنتاجهم الشعري والنثري بعربية سليمة في ألفاظها وتراكيبها ومعانيها، وليختاروا ما بلغ منها جودة عالية في البيان فتعلق على أستار الكعبة لتكون نموذجًا لكل من أراد أن ينتج بيانًا ساميًا.
أغراض ودلالات هذا البيان
إن الأغراض التي تناولها الشعراء والخطباء في هذا العصر كانت متعددة المضامين، عميقة المعاني، مليئة بالتصوير الفني البديع، نابعة من واقع مجتمعهم ومعبرة عن مشاعرهم وأحاسيسهم، لقد تغنوا في شعرهم بالحب والوفاء والشجاعة والإقدام والبذل والجود في زمن الشدة وقلة الطعام وانعدام الأمن، ووصفوا رحلاتهم ولقاءاتهم في زمن النجعة، وما خلف الفراق من أثر على نفسيتهم. أما الخطباء فكانت أغراض خطبهم تتلون بالمعاني التي كانت داعية إليها في زمن السلم والحرب، وفي الدعوة للحفاظ على وحدة القبيلة وحمايتها من المعتدين. يكاد الشعراء والخطباء يلتقون في كل تلك الأغراض لأنها نابعة من واقع مجتمعهم، فإذا وصفوا أثر الحرب ومخلفاتها على الإنسان والطبيعة تجدهم يجتمعون على صورة واحدة، وهي بشاعتها وأثرها القبيح على الإنسان والطبيعة والتركيبة الاجتماعية، قال زهير بن أبي سلمى :
فتنتجُ لكم غُلمانَ أشأمَ كلّهم
كأحمِر عادٍ ثم تُرضع فتَفْطم
شبه الشاعر الحرب بالناقة التي ينزوي عليها الفحل ثم تضع، لكنها تلد لهم مولودًا أشأم ينشأ على العداوة والقتل والفجور، وبذلك لا يسلم المجتمع من مأساة الحرب ومخلفاتها على الإنسان والطبيعة.
واذا وصف الشاعر الجاهلي الفارس الذي يحمي قبيلته من المعتدين فإنه يصفه بهذه الصورة التي جاءت في بيت الأخنس بن شهاب التغلبي:
هم يضربون الكِبشَ يبرقُ بيضهُ
على وجههِ من الدماءِ سبائبُ
فالفارس منهم لا يصارع في الحروب إلا فارسًا مثله لكنه يكون قادرًا على صرعه بضربة قاضية تترك الدماء تسيل منه بغزارة؛ فهذا التصوير نابع من أوضاعهم الاجتماعية أيضًا حيث كانوا يعيشون في حروب دائمة، لذلك كانوا يفتخرون بفرسانهم الذين يحمون القبيلة ليعيش أفرادها في عزّ ومنعة وأمن.
وفي بيئتهم التي عانوا فيها الفقر والحاجة وقسوة الطبيعة تغنوا بالجود أجمل غناء ومدحوا الكرام من القوم بأسمى الصفات التي تليق بأمثال هؤلاء الناس، فهذا زهير بن أبي سلمى يمدح رجلًا جوادًا فاضلًا، أطعم الجياع وأوقف الحروب بأمواله التي بذلها بسخاء في زمن الشدة والعسر، فقال:
قد جعل المبتغون الخيرَ في هرمٍ
والسائلونَ إلى أبوابهِ طُرُقا
من يلقَ يومًا على عِلاَّتهِ هَرمًا
يلقَ السماحةَ منه والندى خُلُقا
تصوير في غاية الجمال والروعة البيانية للتعبير عن التضامن والجود في زمن الشدة خاصة، فهذا الرجل وهو هرم بن سنان يقصده كل من له حاجة، فترى أمام بابه صفوفًا طويلة لتسلم الأعطيات التي يأخذونها من هذا الجواد الكريم، وإذا لم يجدوا مالًا في ذاك اليوم فهم يجدون السماحة والخلق النبيل عنده، كأنه يعوض زواره بهذه السماحة ويعتذر لهم عما فقدوه منه في يومهم ذاك. وزهير حينما يصف هذا الجواد بوصف البذل والطلاقة والخلق الذي يستقبل به زواره فإنه يدعو أفراد مجتمعه الميسورين للاقتداء بفعل هذا الكريم الجواد لكي يخففوا عن الجياع والمستضعفين آلامهم وحرمانهم، ويجعلوا التكافل الاجتماعي ظاهرة مميزة في مجتمعهم.
إن البيان في المجتمع الجاهلي كان يصور كل كبيرة وصغيرة لأنه كان بالنسبة لهم كالهواء والماء
لا يستطيع أحد الاستغناء عنه، به كان الجاهلي يشكو همومه وصروف الدهر ليخفف عن نفسه قسوة البيئة وشدتها، فترى أحزانه في شعره، وتسمع أنينه بين أبياته وتشعر بثقل الزمان عليه من خلال هذا البيان الفصيح البليغ، فهذا شاعر قديم اشتكى من صروف الدهر وهو على فراش الموت، كأنه بذلك يبلغ رسالة لمن حوله أنه لا أحد ينجو من صروف الزمان، ولا سبيل لمواجهته إلا بالصبر والتحمل، فقال:
ألقى عليَ الدهرُ رِجْلًا ويَدًا
والدهرُ ما أصلحَ يومًا أفسدا
يصلحُهُ اليومَ ويفسدُهُ غدا
إن الإنسان الجاهلي كان يشعر في كل لحظة من حياته بأنه يعيش من أجل أن يخلد نفسه بالكلمة التي هي أقدس شيء عنده، فيفرغ معاناته وهمومه في شعره أو أمثاله أو حكمه أو أقواله المأثورة، لأن الكلمة هي التي ستظل معبرة عن وجوده؛ وبذلك يجزم الباحث المتقصي لخصائص البيان في مجتمعهم بأنهم عشقوه مثل صحرائهم وحيوانهم الأليف الذي كان أنيسًا لهم في تلك الصحراء، فلا تجد حادثة من حوادث زمانهم، ولا منظرًا من مناظر طبيعتهم ولا عادة من عاداتهم إلا صوروها ببراعة في إنتاجهم الإبداعي شعرًا ونثرًا لجيلهم وللأجيال القادمة لتكون شاهدًا على ظروف حياتهم بغير زيف أو كذب أو تحريف. ولنختم التصوير البياني عند الجاهليين بأبيات لامرئ القيس يصف فيها أحواله النفسية عند الفراق، ذلك أن أفراد المجتمع الجاهلي كانوا دائمي الترحال، فتشط النوى بالأليف والرفيق، فيترك ذلك أثرًا كبيرًا في أنفسهم التي كانت لا تهدأ آلامها على الدوام حيث يقول:
كأني غداةَ البينِ حين تحمَّلوا
لدى سمُراتِ الحيِّ ناقفُ حنظلِ
إنه إحساس صادق صور به نفسه بهذه الحالة التي تجعل المتلقي يتعاطف معه، ويشاركه أحزانه في لحظة الفراق، ولا يدري الشاعر هل ستجود الأيام المقبلة بلقاء آخر، فلم يجد للتعبير عن غزارة دموعه التي لم تتوقف إلا بهذا التشبيه البديع الذي اختار له نبات الحنظل الشديد الأثر على حاسة البصر.
وفي أبيات أخرى يأتي بصورة من واقع بيئته ليظهر للمتلقي ما يعاني في وحدته من هموم في ليل طال عليه، فتسعفه قريحته بهذه الصورة البديعة التي عبرت بصدق عما يحس به:
وليلٍ كموجِ البحرِ أرخى سدولَهُ
عليَ بأنواع الهموم ليبتلي
فقلتُ له لمّا تَمطَّى بصلبِهِ
وأردفَ أعجازًا وناءَ بكلكلِ
ألا أيها الليل الطويلُ ألا انجلي
بصبحٍ وما الإصباحُ منك بأمثلِ
هي صور متلاحقة تكشف حجم همومه في ليل طال عليه، وكانت البيئة مساعدة له في هذه الصور البيانية البديعة التي رددها النقاد والبلاغيون بإعجاب في كل العصور لأنها معبرة بصدق عن حالته النفسية، وصادرة من واقع يمسي ويصبح عليه, وهذا هو الذي يحبب للناس الأدب لأنهم لا يرون فيه زيفًا وخداعًا.
هذه هي الصورة المثالية للأدب عند الجاهليين، جسدوها بشتى صور من البيان الذي عشقوه، فجاءت صافية مشرقة، واضحة كصحرائهم التي لم تكن تخفي عنهم شيئًا، فكذلك كان البيان، صوَّروا به كل ما كان يشغل بالهم في مسراتهم وأحزانهم، وآمالهم وإخفاقاتهم، ومقامهم وترحالهم، وفي حربهم وسلمهم، فلا تجد بيانًا جامعًا للصفات الإنسانية النبيلة والصدق في التعبير مثل هذا البيان الذي تحدى الزمان والمكان ليصبح بيانًا كونيًا رغم مرور هذه القرون ■

