«لماذا لم توجد عصور وسطى إسلامية؟»
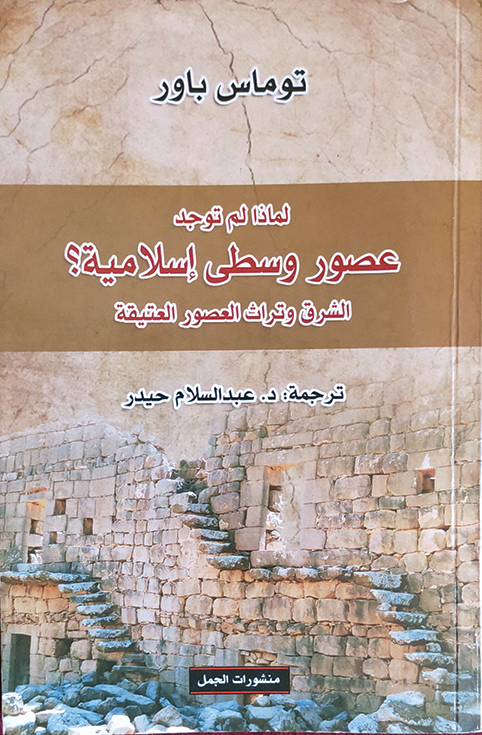
تسيطر علينا صورةٌ ذهنية تحصر دراسات المستشرقين في الهجوم والتربص حالَ كتابتهم عن الشرق بشكل عام وديننا الحنيف بشكل خاص، وعلى إثر ذلك انتشرت بصورة كبيرة مصطلحات مثل إسلاموفوبيا، والتزمنا المتابعة عن بُعد، وأعجَبَنا موقعُ الضحية واستمرأنا المكوثَ فيه. وإذا كان هذا الحال واردًا فالحق أنه ليس مهيمنًا، وإذا تحلت بعض دراساتهم بالتعصب فإن ذلك لا يمنع ظهور كتب أكثر اتصالًا بالنقد العقلاني الموضوعي، والمحايد تقريبًا، ومنها دراسات الاستشراق الألماني الذي يتسم حاليا بقراءة التاريخ والولع بتحليله؛ فيصف الأمور بحجمها الحقيقي دون لبس أو تضخيم، ويصل - في الأغلب - إلى نتائج موضوعية، وهو ما تجده لدى «توماس باور» في كتابه المترجم آنفًا «ثقافة الالتباس»، وصدر منذ سنوات قبل كتابنا هذا: «لماذا لم توجد عصور وسطى إسلامية؟» بترجمة رائقة للدكتور عبدالسلام حيدر.
لعل ماسبق نتاج تلاقح ذكي بين وعي غربي المنشأ، صار شرقي الهوى، ومن ثم يرد فيه - من طرف خفي - نقدٌ ذاتي للأحكام الغربية المغلوطة، واتهامٌ بعدم الموضوعية لكثير من المناوئين بالترصد للإسلام؛ إذ لا يرى إجراءاتهم تجاه تاريخ الصين متسمة بالتعسف ذاته، كما يحدث كثيرًا مع التاريخ الإسلامي. وهو النسق ذاته الذي يناقش - على ضوئه - بعض المؤلفات التي تتعرض للمسألة ذاتها، ويفيد كثيرًا من آرائهم معتمدًا على كون السياق غائبًا عن وعي أغلبهم، وأن اعتبارًا قليلًا تم بذله بخصوص الخلفيات الثقافية الشاملة فكان تركيزه على اليونان والرومان والتجاهل التام للحضارة الفارسية مؤذنًا بتحقيب غير عقلاني.
يبدأ توماس باور في كتابه الثاني المنقول للغة العربية (لماذا لم توجد عصور وسطى إسلامية؟)منطلقًا من سؤال حول مصطلح العصور الوسطى، وهل يمكن نقله إلى الحديث عن الإسلام، وراهن بحثُه أن ظِلالَ المصطلح لا تضيف وضوحًا وإنما على العكس تمامًا؛ إذ إن القول بعصور وسطى إسلامية يفترض اعتبار أوربا وتاريخها ميزانًا ونبراسًا للعالم كله، واتخاذُ أوربا معيارًا عالميًا هو حجة استعمارية في جوهرها، تُبطِّنُ الأطماعَ كما الحال مع نابليون في حجته غزو مصر لتطويرها.
يؤسس الكتابُ - تحت سطحه البادي - تصورَه على أن نقل المصطلحات دون وعي بخلفياتها الحقيقية، في بيئتها الأم، يسبب كثيرًا من الإرباك؛ ذلك أن ظلال المصطلح قد تكون أكثر أهمية من منطوقه، المغري بالعملية، وقد يوهم الظل أبعادًا زائفة كما قد يعلو الهامش على المتن أحيانًا. فهذا التصور لحقبة العصور الوسطى لم يدمغ الحياة في الشرق.
ثمة أيضًا منزع مضاد لفكرة التحقيب؛ إذ يجد فيه فكرة مثالية لا تراعي تغير اللغة، أو طبيعة ثقافة غير قابلة للتأثير أو مرونة فهم دين يتباين بين فترة وأخرى. والكتاب يلفتنا إلى أن تقسيمات العصور الوسطى ليست حدية، وأن كثيرًا من الحدود موهومة، وأن التداخل متن وليس هامشًا. إننا نُنْصِت إلى صوت فريد بعيد عن الخلط وركام المفاهيم المغلوطة، فتراه يبغي إقامة أود نظرة محايدة لبعض القضايا المعاصرة، لتغفر له - بسبب موضوعيته تلك - تجاهل البداية بالسؤال دون افتراض هل عرفته العصور الإسلامية أم لا.
مبدئيًا، مصطلح العصور الوسطى ليس مصمتًا ذا زاوية واحدة للنظر، وليس من باب أولى ظلاميًا خالصًا أضاءته جهود مارتن لوثر كنج. إن للفترة وجوها كثيرة، ومصطلح العصور الوسطى مضلل لأنه يوحي بتوجه ديني قوي للمجتمعات التي يصفها. ثمة فارق بين الإثارة الصحفية والوعي الأكاديمي، والتعميم من خلال مدينة واحدة مختلف عن الاستقصاء التاريخي الذي بذله الكتاب؛ إذ الشرق الأدنى لم تحدث فيه أي قطيعة مع العصور المتأخرة كما كان الحال في الغرب، والظروف المعيشية في الغرب تختلف عن مثيلتها في الشرق.
تختلف الفترة من 500-150 ميلادية عما قبلها وما بعدها حتى اعتبرها البعض فاصلًا، وأسند إلى التحري العلمي مهمة محاولة تصحيح صورة العصور الوسطى. يتم تقييم التاريخ على أساس ما مر بها البشري، بينما الثابت أن تاريخ العالم في الفترة ما بين القرن السادس الميلادي والقرن الحادي عشر الميلادي لم يكتب لا في غرب أوربا ولا في وسطها.
ويفجر الكتاب عديدًا من القضايا تلح على ذهن المؤلف، ولم يكن مروره السريع عليها دلالة إهمال قدر دلالته على إلحاحها وسيطرتها على ذهنه والرغبة في الإمساك بتفاصيلها بدقة، وليضع أفكارًا للتأمل لا القفز عليها، من ذلك تأكيده اعتبار العصور الوسطى قرينة التعصب الديني وهو ما يرى براءة تاريخ الإسلام الحقيقي منه، فيرى أن المجتمعات الإسلامية في فترة ما قبل الحداثة كانت تتميز بنسبة عالية من «التسامح الملتبس»، وكيف أن حركة من الفن والطب والترجمة وتلاقح الثقافات كانت موجودة باضطراد، وهي الظلال البعيدة عما يلقيه مصطلح «العصور الوسطى» من معان متصلة بالظلام الحالك قبل عصر النهضة. إنه مصطلح عابر للزمن ولا يختص بحقبة زمنية، وإنما يشير إلى تخلف وتعصب وعنف قد لا تبرأ منه أكثر الدول «حضارة» حين تنزع عنها حقوق الآخرين.
ويدحض «إشاعة» كراهية الأجانب التي يرصد مظاهر لا تؤيدها، وتناقضها مثل تباين القضاء الشرقي المتطور، والمعتمد على تطبيق قوانين يدخل الفهم البشري في صياغتها وتطبيقها، وبين الاتكاء على الحكم الإلهي في الغرب، وكذلك تمتع الأقليات الدينية بالكثير من الاستقلالية وإن لم يحوزوا المناصب واكتفت الدولة بتوفير التعددية الدينية وربما لاعتبارات التأثر بالسياق الرأسمالي كان تركيزه على تحليل تطور العملة، وانتقالها - مثلًا- للتخلي عن الصورة وصولًا للشكل الموحد، ولم يكن ذلك نتيجة عداء إسلامي مزعوم للصور-حسب تعبيره الذي لا تخفى فيه كلمة مزعوم. يبدو أنهم يرون جوهرنا أكثر من بعضنا.
وفي الكتاب دلائل على قراءة مستوعبة وموسعة للتاريخ الإسلامي وإبداعاته ويصل في نقده إلى العدول عن دراسات مهمة مثل «تاريخ التراث العربي» الذي يراه خلوًا من مؤلفات مهمة، ويقيم الكتاب فسيفساء متكاملة لظواهر عملية وعلمية تؤكد رهانه وتدعمه.
يرصد الكتاب بعض المظاهر التي تبدو قليلة الأهمية مثل تطور مواد البناء، وقيام العالم العربي بالسبق في هذا، وليس في الأمر استخفاف أو بحث في الأمور الأقل أهمية، كالتفاته إلى تطور صناعة الزجاج، كما يرصد بوادر بعض ملامح الفردية التي ظهرت في شعر كبار الشعراء كالمتنبي ويوميات المغمورين كابن البناء البغدادي، وهي الملامح التي لم تظهر إلا في القرن الخامس عشر في أوربا، وللحق فهو يبالغ في اعتبارهم من جهة، ويعمم ظهورها من جهة أخرى. والإقبال على عمارة الدنيا كان فرعًا عن التطلع إلى الجنة والتركيز عليها في التصور الإسلامي حتى خلت رسالة الغفران من ذكر النار، بينما الكوميديا الإلهية تركز على النار والعذاب، ورأى - في غمرة حماسته - في الأعياد المسيحية وثنية-من نوع ما - في تصوره، بينما انفتح المسلمون على أعياد غيرهم من مسيحيين وفارسيين، دليلًا على رغبة المسلمين في التعايش وانحباس المسيحيين في تصوراتهم الخاصة. وثمة حركة عمران كبيرة لم تقتصر على المدن الجديدة كبغداد والفسطاط وإنما كان عمرانًا طاغيًا بشبكة المواصلات والنقل والجسور وتقسيم الدواوين، وانتشار الورق وصناعته وأسواق الكتب وطبقاتها، واختراع المعداد رغم بساطته، وابتكار الصفر والأرقام الهندية.
إن نقل المصطلح إلى العالم الإسلامي لا يعكس وعيًا بجوهره في أصله الأول، بداية من أمور النظافة الشخصية واستخدام الحمام وتباينه بين الشرق والغرب، مرورًا بالعملة وتاريخ صناعة الكتاب، وليس انتهاء بكتب عن فنون مختلفة كالجنس ومؤلفات عن الحيوان والنبات وتنوع العملة وتباين شعر الغزل بحسب البيئة وكذلك تقدم الطب الذي يرصده مدينًا للسريان واليهود، ليكون الاهتمام بالطب دليلًا على الانفتاح على السريان من جهة واليهود من جهة أخرى والولاء لقسم «أبو قراط» «الوثني» - بحسب تعبيره -، وجمعُ الطب بين الممارسة والتأليف كما في «القانون» للرازي، وليس انتهاء بالالتفات إلى المعاجم وتأليفها حتى تلك التي لم تعرف أوربا مثيلاتها إلا في العصر الحديث تمامًا كما حدث مع معجم كبير الحجم مثل «تهذيب اللغة».
يخرج الكتاب أحيانًا إلى توسعة زاوية النظر فتطرق إلى أبعاد أخرى كإحالاته الكثيرة إلى بعض تطورات في مفاهيم الديانة المسيحية. إنه يرصد عدة نماذج لتلاقح وجهات النظر على العكس من الشائع من سمات فترة العصور الوسطى، بما يؤسس لقبول الإسلام دخول الحداثة، على العكس من وجهات نظر لا تقتصر على المستشرقين، بل يتزعمها بعض أبناء جلدتنا ■

