العالم العربي ثقافة التحديث أم ثقافة التجديد؟
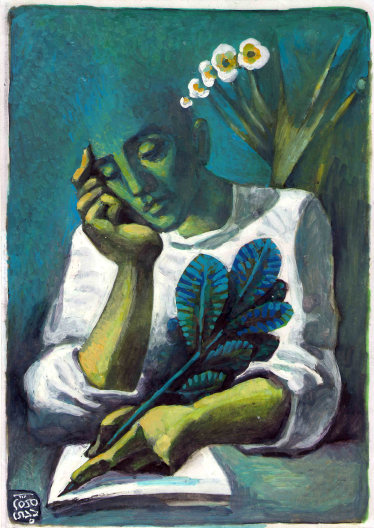
الثقافة هي التعبير الأسمى عن الهوية الجماعية لأمة من الأمم، وتجسيد للوعي الذي بلغته في مجالات الحياة، غير أنها تخضع لسيرورة تاريخية وحضارية تسهم في إحداث تغيّرات ومغايرات وفق السياقات التي تحكمها وتؤثر في مساراتها الممتدة. والإنسان كائن ثقافي يصيّر وجوده، ويبتني الكينونة انطلاقًا من اللغة كقاسم مشترك، وطريقة القول باعتبارها مكتسبًا فرديًا، والخيال الذي به يفكر بشكل مختلف ويبدع عوالمه وتراثه ويخلّف أثره. وعن طريق الممارسة الثقافية يعطي الإنسان معنى لوجوده ولأشياء العالَم.
عندما تتلاشى الثقافة تفقد الحياة نكهتها ودلالتها، لكن حركيّة الثقافة تتّسم بقدرتها على اقتحام كل ما يثير ويستفز العقل من أجل الابتكار والاختراع، وفي غياب الحافزية التي تثير القلق (قلق السؤال) تبقى الثقافة من دون جدوى ولا يمكنها التأثير في مجريات التّحولات الاجتماعية والتاريخية والحضارية. من هذا المنطلق هل يمكن الحديث عن الثقافة العربية وفق رؤية مفعمة بالأمل؟ وكيف نتمكن من جعلها هاجسًا للتفكير والتأمّل، في ظل ما نعيشه، من أوضاع اجتماعية وقيمية لا تبشّر إلا بالالتباس والخوف من المستقبل؟
(1) على مدار السؤال الثقافي:
أسئلة مضنية تثير الحرقة والقلق والمكابدة لدى المنشغل بقضاياها واستشكالاتها، خصوصًا أننا نمرّ من منعطف موسوم بمخاطر كثيرة، منعطف تاريخي يشعر الذات العربية بأنها خارج التاريخ والأسئلة، وأن الإنسان العربي مغيّب ثقافيًا وحضاريًا، نظرًا للوضع الكارثي الذي بلغه الرأسمال الرمزي من حيث الوضعية العامّة الموصوفة بالهشاشة الثقافية - إن صحّ التعبير- لعلّة أصابته في مَكْمَنٍ. فإذا كان السؤال الثقافي/ الفكري / السياسي / الاجتماعي، الذي طرح نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين الذي مداره ومحوره التقدّم الغربي والتّأخّر العربي. إنّه «سؤال النهضة»، الذي حتّمته ظروف معينة وسياقات مختلفة ترتبط بواقع الأمة العربية المتّصف بالانغلاق والانكفاء وعدم الوعي بالذات، والارتكاسة الحضارية للإمبراطورية العثمانية، إضافة إلى واقع الاستعمارات الأوربية المتكالبة على الوطن العربي، فبرز مثقفون ومفكرون وشعراء وأدباء يمثلون التيار الإصلاحي حملوا مشعل هذا السؤال الملتهب، وقُدمت حول هذا السؤال العديد من المقاربات أسهمت في بلورة تصور تجديدي متأثر بالثقافة الأوربية، راصدين أعطاب هذا التأخر العربي، وأسباب تقدّم الآخر الغربي، ومن دون أن نعيد ما قيل حول هذا الأمر، يمكن القول إن من أسباب عدم قيام نهضة عربية حقيقية غياب الرؤية الواضحة والفهم العميق والدقيق للماضي الموروث، هذا الماضي المثقل بقيود النص الديني وكيفية فهمه وتأويله، وكذا العجز الملموس في طرح السبل الكفيلة لتجاوز هذه الأعطاب، وخوف الأنظمة الحاكمة من إعادة النظر في التراث بعيون تنويرية وأكثر جرأة في تناول المقدس وفق خلفية معرفية مخالفة لمصالح الطبقات السياسية المحافظة، لأن هذا يشكّل تهديدًا لوجودها.
كذلك لابد من الإشارة إلى أن هذه الصحوة كانت بشارة إيجابية للخروج من الانتظارية التي عمّرت طويلًا وأناخت ردحًا من الزمن بكلكلها على كاهل الأمة العربية، كما حدّدت(الصحوة) مكامن الارتكاسة الحضارية للعرب، معتبرين أنها نتاج عدم الوعي بالتراث أولًا، ما حال دون إزالة ما علق به من الشوائب في القراءة والممارسة والإدراك العميق. كما أن هاجس الرواد تمحور حول ضرورة الحفاظ على قداسة اللغة العربية، من دون التفكير في الآليات الكفيلة لمواكبة ما يجري من تقدّم وتطوّر في الجانب الغربي. يمكن الإشارة إلى عاملين أساسيين كان لهما تأثير في هذا التأخر الحضاري، يتعلق الأول بالعامل الذاتي المرتبط بالأنا العربية، التي لم تستطع التخلّص من نسق الثقافة الفقهية المتخلف، وعجزها في بناء نسق ثقافي حداثي؛ حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات الحضارية المطروحة والإجابة عن الأسئلة المتشابكة. يرتبط الثاني بالعامل الموضوعي، الذي تجسّده سياسة الغرب الاستعمارية بالعمل على الحفاظ على الواقع القائم، بتكريس سلطة تحديثية على مستوى الظاهر، لكنها تقليدية في الجوهر، بغية الحفاظ على مصالحها وامتيازاتها، دون إغفال الفكر الاستشراقي الذي زاد من تعميق عزلة الأنا أمام الآخر، وهو عطب ما زال العرب يتكبدون من ورائه الويلات والتخلف، ليبقى السؤال مُشْرعًا على ضرورة التجديد كإشكالية تفرض وجودها بالقوة والفعل.
(2) من أجل وعي جديد بالثقافة العربية:
تعود بداية هذا التحوّل، من خلال الجهود المبذولة من لدن زمرة من المثقفين والمفكرين العرب، الذين حملوا لواء التجديد وضخوا دماء جديدة في شرايين الثقافة العربية، ومن أبرز هؤلاء طه حسين المفكر الذي حاول تسليط الضوء على دور الثقافة في ارتياد آفاق التقدم، من خلال ما قدّمه من أطروحات تعتمد على الشك الديكارتي لبلوغ يقين الواقع، وما كتابه «في الشعر الجاهلي» إلا تعبير صارخ في وجه الثقافة السائدة، ثقافة الاجترار والاحتذاء، ما أثار حوله زوبعة من الرفض واتهامه بالردّة والكفر، لا لشيء إلا لكونه قوّض بنية النسق الثقافي الذي كان يرتكز على الثبات، إضافة إلى كتابه، وفي اعتقادي الخاص المشروع الثقافي الموؤود يتعلق بكتابه «مستقبل الثقافة في مصر» الذي عالج فيه قضايا الفكر والثقافة والتعليم، وإشكالية النهضة والهوية، وهو مشروع تنويري تمكّن طه حسين خلاله من الكشف عن حاجة المجتمع العربي إلى ثورة حقيقية تتجاوز التحديث. هذا الأخير تمّ حصره في البنى التحتية وتعزيز السلطة بمؤسسات تنفيذية وتشريعية لا تحمل في جوهرها إلا ترسيخ التسلط والاستبداد والتقليد، والعمل على عرقلة إقامة دولة الحق والقانون.
هذا المشروع التنويري الذي وضع أسسه الكواكبي والأفغاني وطه حسين سيشهد قفزة نوعية منتصف الخمسينيات وبداية الستينيات والسبعينيات، في سياق الصراع القائم بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي، حيث شهد العالَم العربي مدا للفكر التنويري المشبع بالنسق الاشتراكي، وقد كان وراء إرباك البنية التقليدية السكونية، واقتراح ثقافة تجديدية، ليسطع جيل مؤمن بالتحويل والتغيير كسلامة موسى ومحمد عابد الجابري ومحمد أركون وعبدالله العروي وعلي الوردي ومحمد برادة وصنع الله إبراهيم والسياب وأدونيس ومحمد بنيس وأمل دنقل وصلاح عبدالصبور وآخرين، هذه الحركية الثقافية عكست رغبة الأنا في تجاوز كل ما يعيقها للتعبير عن وجودها، مانحة أفقًا تجديديًا قوامه ثقافة تطرح السؤال، وتهدّم الثابت لخلْق التحويل، وخرق جدار الصمت والجمود لإعلان فكر آخر جدارته تتمثّل في التحرر من الرقابة التراثية، والانعتاق من أغلال التكرير والاجترار، وفي اكتشاف جغرافيات مجهولة في حاجة إلى الكشف عما تخفيه من أسرار، وما تكتنزه من ثراء وغنى، ويمكن نعتها بالصحوة الثانية التي أحيت أمّة تعاني الجمود والانغلاق والركون إلى الجاهز والثابت، إلى الموجود المتجاوَز. هذه الصحوة هي الأخرى لم يواكبها تحوّل في عقلية الدولة القائمة في العالَم العربي، ذلك أنها ظلت ملتصقة بالهواجس الأمنية؛ من دون التفكير في الهواجس الفكرية والثقافية، فنظرتها للثقافة قاصرة، فكان رد فعلها تجاه هذه التحولات إعلان حرب على كل فكر تحرري تنويري إما عن طريق الاعتقال والمطاردة أو النفي، لتبقى الممارسة الثقافية معطوبة، كما أن تأثير الصحوة الثقافية الثانية كان محدودًا ولا أثر له على الإنسان العربي، ولعلّ الردّة الفكرية التي يتخبط فيها العالَم العربي صورة حقيقية لأزمة الذات وعدم امتلاكها إرادة التجديد الثقافي، لأن واقع الثقافة العربية في العصر الذي نحن فيه موسوم بتكبيل الخيال برؤى ضاربة في كلاسيكية بالية ورثّة، ولم تعد تستجيب لما يمور به العالَم من تغير وتحويل مس كل الأشياء والموجودات، بل إن الطبيعة تبدّل كيانها وتنبعث من جديد بصيغة تختلف عمّا ألفناه، وهذا يؤكّد أن طبيعة الكائن التحوّل والانتقال من حال إلى حال وفق سيرورة الزمان وصيرورته، هذا يجعلنا نعيد التفكير في ثقافتنا العربية بروح جديدة، روح تنتصر إلى الإبدال بدَل الاحتذاء والعيش تحت جناح السّلف الذين ابتدعوا رؤيتهم للإبداع والكتابة، ونهجوا النهج الملبّي لنداء زمنهم وعصرهم، فإذا كان الشاعر العربي، منذ قرون، مخترقًا واقعه بالنشيد / الإنشاد، لأن المكان اللانهائي الذي يواجهه يحتّم عليه خلْق صوته، لا صدى هذا المكان، إذ نجد المكان منسوجًا داخل القصيدة بطريقة يشكّل فيها المأوى وتارة أخرى المحفز للتذكّر ومطاردة طيف المرأة المحبوبة، وفي هذا بعث للغياب كي يصبح حضورًا، إنها «جدلية الخفاء والتجلي»، وتستمر القصيدة في بناء كيانها على أساس الانتماء إلى اللحظة الزمنية والامتداد في حركية الإنسان داخل المكان بما يحمله من حمولات وجودية، لذا كانت تصاغ بالشكل الذي تمّت صياغته انسجامًا مع الوعي بالذات والعالَم.
ما أنجزه المثقفون العرب في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين من ثورة ثقافية أساسها حداثة فكرية لم يكن على صلة بواقع المجتمع العربي، هذا الواقع المشلول وغير القادر على استيعاب الفكر التنويري نظرا للانتشار المهول والمروع للأمية والجهل، فكان مآل هذا المشروع الخيبة والفشل. ونعتقد أن المشروع الحداثي ظل مجرد حلم بعيد الحصول مادام مستوردًا غير منبثق من رحم المجتمع العربي.
(3) الثقافة العربية بين التحديث والتجديد:
إذا كانت الثقافة العربية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين - بعد فترة ركود - لم تعرف نهضتها الحديثة إلا بالانفتاح على الثقافة الغربية، بمعنى آخر أن المؤثّر الغربي حاضر بقوة في نسق الثقافة العربية، بل يشكّل مكونًا من المكونات الفاعلة في تشكيل هذه الثقافة وهو أمر محمود وذو أبعاد مهمة، فإن صيرورة الثقافة تبتني وجودها الرمزي عن طريق المثاقفة مع ثقافة الأمم الأخرى. الجدير بالذكر أن ما عرفه الإبداع العربي في القرن الرابع للهجرة، من تحويلات وتوهّج فكري وعلمي، كان جراء حواره الفعّال مع الإبداع اليوناني والفارسي والهندي، ما نجم عنه تخصيب الثقافة العربية، وجعلها أكثر عطاء وإضافات، وهذا يسري على العصور الآتية، إذ نجد أن العرب قد جسّروا صلاتهم مع نتاجات الشعوب والأمم الأخرى بعد مرحلة الانهيار الحضاري في عهد الامبراطورية العثمانية، وقد كان هذا التجسير إثر فترة الاستعمار الأوربي، التي كانت بوابة مهمة لبناء أجيال متشبعة بالثقافة الأوربية، واتّخاذها أحد أعمدة التحديث الثقافي والسياسي والاقتصادي.
رغم ذلك ظلت الثقافة العربية بعيدة كل البعد عن التجديد وقريبة من التحديث، فالواقع يعطي صورة مغلوطة عن الممارسة الثقافية في العالم العربي، فهي تبرز أن المجتمع العربي حداثي على مستوى المظهر، لكن الجوهر يعرّي وجه التناقض الذي تحياه الذات المثقفة في نسق ما زال مشدودًا إلى الماضي بعلّاته ونواقصه وشوائبه، منبهرًا بالسّلَف ومتشبثا بما أنتجوه من نتاج ثقافي يعبّر عن لحظتهم التاريخية، ما يعكس أن التحديث هو القائم في بنية المجتمع العربي، بينما التجديد في الثقافة العربية المرتبط بالاختراع والابتكار والإبداع والخلق؛ يعيش غربة قاسية ومزدوجة، بين الرغبة في تجاوز الثقافة التقليدية وتقديم ثقافة تنتمي إلى عصرها، تجسّد أسئلة اللحظة التاريخية المنتمية إليها. فالصراع بين الحداثة والقدامة أبدي لن ينتهي مادام النسق المتحكم في التفكير العربي تعتوره العديد من العوائق الاجتماعية والعقلية والسياسية والثقافية، ما جعله عاجزًا أمام سطوة ثقافة الاجترار والتقليد. وما شهدته عقود الستينيات والسبعينيات من حروب ثقافية بين نمطي التفكير في البنية الثقافية العربية يعكس مرارة هذا الوضع غير السليم، نمط ثقافي يَدينُ بعقيدة الأسلاف، ونمط آخر مرتم في الثقافة الغربية ذات النسق المناقض للنسق الثقافي العربي. ومن مظاهر هذا الصراع ما تعرض ويتعرض له المفكرون المجددون التنويريون من مضايقات ومطاردات ومحاولات الاغتيال (تجربة نجيب محفوظ) واتهام البعض بالردة والكفر والزندقة (نموذج)، وهذا دليل على النسق التقليدي هو المهيمن والسائد، وكأن العقل العربي منذور للحجر عليه، وأن ما أنتجه السابقون هو النموذج، متناسين أن الثقافة تعبير عن نداء الحاضر لارتياد المستقبل، لكن العرب يتهيبون من المستقبل لذا يقومون بهجرة عكسية إلى الماضي مُتخلّين عن الحاضر، وهنا مكمن داء التخلف على مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ما أفضى إلى التمزق الداخلي للثقافة العربية - بعبارة عبدالله إبراهيم - يقول فيها «من الطبيعي أن يؤدي كل هذا إلى تمزيق النسيج الداخلي للثقافة العربية الحديثة إلى درجة أصبحت فيها التناقضات ظاهرة لا تُخفى، فتتحلى بصور النّبذ، والإقصاء، والاستعباد المتبادل بين الممارسات الفكرية التي تستثمر هذه المرجعية أو تلك ضد الأخرى، ومن خلال إشكال التمويه، والتّخفي، والإكراه»، وكشف عن أن التحديث في الممارسة الثقافية لا يعكس حقيقة المجتمع العربي الراسب في امتحان الحداثة ذات الأصول الغربية، والمنبجسة من رحم التحولات والارتجاجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية، والمخلخلة لبنية النسق الثقافي الغربي. لكن يبدو أن استيراد الحداثة الغربية إلى العالم العربي لم يفلح في تغيير منظومة القيم التقليدية الراسخة في الثقافة العربية، لأنها ليست من صلب الأرض العربية، وكل غريب عن الأرض يعيش في غربة واغتراب داخل النسق المستورَد إليه، دون إغفال غياب الإرادة السياسية للأنظمة العربية للتغيير والتحديث، ونتج عن ذلك تعطيل بناء الإنسان العربي المُفكّر والطّارح للأسئلة بدل الركون إلى الأجوبة جرّاء السياسات التعليمية المتخلّفة عن مواكبة ركْب الحضارة المتغيّر الانعطافات الحادّة والمباغتة، والتي لا تستجيب لحاجات العصر، في زمن تعرف فيه التقنية مدًا كبيرًا وتطورًا مهولًا وسريعًا جعل الإنسان العربي خارج التاريخ وأسئلة الواقع العالمي المتجدّد.
في الختام:
يبقى السؤال الثقافي في العالم العربي قائمًا مادامت الذات المفكّرة تتعرّض لكل أصناف التهميش والإقصاء، وذات مشروع ثقافي مجدّد ومتجدّد ونابض بضوء الحياة، لأن النسق الثقافي / الفكري المناقض والنقيض لجذوره ما زال متجذرًا في العقلية التقليدية الرافضة لكل تجديد، والعازمة، بما ملكت من سلطة مادية ومعنوية ، على مواجهة كل فكر تنويري يروم إقدام الشمس لإضاءة مغيب المجتمع العربي المحرّض على الإقامة في الماضي، والرافض للوعي بالحاضر لاستشراف أفق مستقبلي بإمكانه تقديم حلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي يتخبط فيها العالم العربي في اللحظة الراهنة الموسومة بتأليه الآلة والسّقوط في فخ عولمة جارفة، مهدّمة لليقينيات والسرديات الكبرى، وطارحة على دول العالَم الثالث سؤالًا حول كيفية الانخراط في سيرورة حضارية خاضعة لإيقاع تاريخي متبدّل وغير مستقر ■

