لسان العرب يقلصه عصر «البوتوكس»
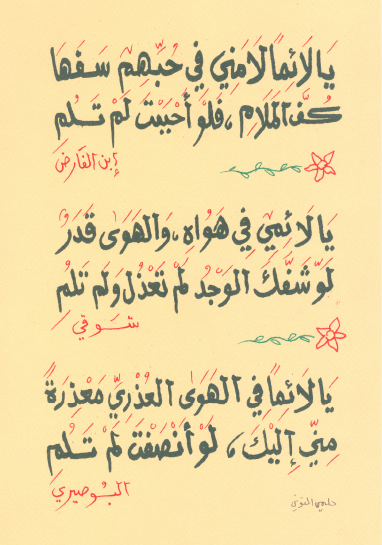
كما في كل عام في الثامن عشر من شهر ديسمبر، تطوى احتفائية اليوم العالمي للغة العربية باهتمام وحرص على إحياء هذه المناسبة العالمية. فنقرأ قصائد جميلةً للتعبير عن فضل العربية وسمو مكانتها والاعتزاز بها، وتطالعنا منشورات فيسبوكية وفيرة تعيد نشر بعض المعلومات التي تعزف على وتر فرادتها وميزاتها، من قبيل غناها بالمترادفات والأضداد، وطواعيتها في اللحاق بقطار التقدم الحضاري العالمي. ويغنينا بعض المحتفين بها باقتباسات لبعض الكتّاب العرب أو الأجانب تبين فضل العربية وجمالها، وتسافر بنا مقالات عديدة جديرة بالقراءة إلى رحابها مسلطةً الضوء على خصائصها وواقعها والتحديات التي تواجهها، وعلى آفاقها المستقبلية والحلول المرجوة للنهوض بها من كبوتها، كما لا تمر هذه المناسبة من غير تنظيم مؤتمرات وندوات تعقد لأجل تعزيز الانتماء إلى الهوية اللغوية العربية في غير دولة عربية وإسلامية.
للمفارقة أن ثمة من يحتفون بلغتهم الأم احتفاءً أشبه ما يكون باحتفاء ابن عقوق رمى بوالدته في مأوى العجزة كأنها كتلة وجودية فائضة في حساب انشغالاته وأيامه، حتى إذا حلت مناسبة عيد الأم استردها لسويعات إلى بيته محتفيًا بها احتفاءً طقسيًا فارغًا من العاطفة والمشاعر، لأن كل همه تكريس نزعته الأنانية إلى حب الظهور عبر تخليد احتضانه الزائف إياها في مساحة تتقلص إلى حجم صورة فوتوغرافية يتيمة المحتوى والأثر، قبل أن يعيدها إلى مأواها الغريب هزيلةً وحيدةً مستوحشةً!! وإلا كيف يمكن أن نفهم ظاهرة ردود بعض المتحمسين للغتهم الأم على تعليقات المتفاعلين مع ما يكتبونه ثناءً وإطراءً بعبارات مكتوبة بالأجنبية أو بما يسمى «العربيزي» أو «العربتيني» (العربية المكتوبة بالحرف الأجنبي والأرقام) من قبيل: «Merci beaucoup,Thank you, Teslam, Kellek zo2 hbbti...»؟!
تراجع اللسان العربي
ولئن تجاوزنا الكلام على هذا الاحتفاء الشكلي العابر لدى فئة من «الفسابكة» ممن يحتفلون بالعربية كما في كل عام، فإننا سنفصله على بعض ما جاد به فكر بعض المثقفين والأكاديميين والباحثين والصحفيين من طروحات وحلول مقترحة للنهوض باللسان العربي من كبوته، ومنعه من الانحدار نحو هجعة التداول اليومي سواء في القطاع التعليمي أم الإعلامي أم التقني أم الثقافي أم الحياتي عمومًا.
ولذلك سنناقش طرحًا جديرًا بالقراءة والنقد شدد على إرجاع سبب تراجع اللسان العربي اليوم إلى أساليب التدريس الروتينية المبنية على مهارات التلقين والحفظ بدلًا من مهارات التفكير التحليلي والنقدي، وإلى إصرار من يمكن تسميتهم حراس «هيكل النحو» على تعليم قواعد العربية بقوالب تجريدية جامدة تكاد تفصلها عن بعدها الوظيفي في توليد دلالة النصوص الأدبية؛ لذا، يجب إحراق كتب النحو والصرف حسب زعم هذا الطرح الذي يضيف أصحابه أسبابًا أخرى لانحدار اللسان العربي تتمثل في تركيز المناهج التربوية المعتمدة في معظم الدول العربية على استثمار نصوص بعيدة من لسان الطالب المعاصر ومن انشغالاته الذاتية وملامسة همومه وقضاياه الراهنة؛ فيبدو إزاءها أجنبيًا عنها لا يكاد يفقه معجمها، ولا يجتذبه ما تضمره من مضامين وقضايا وإشكاليات حضارية أو ثقافية؛ لأنها لا تتصل بظروف بيئته إلا بخيوط رفيعة وواهية، ومن شواهد ذلك الإصرار على تدريس قصائد تنتمي إلى العصر الجاهلي أو الإسلامي أو الأموي أو العباسي في مرحلة التعليم الثانوي، وكأن قضايا العرب التي يدعى الطالب إلى مناقشتها اليوم قد توقفت عند أعتاب مشكلة التمييز العرقي الذي مارسه شداد العبسي في حق ابنه «عنترة»، أو عند تخوم تمرد الشاعر «أبي نواس» على ظاهرة الوقوف على الأطلال وعلى بعض ركائز العمود الشعري
كما حاول أصحاب هذا الطرح الإشارة بإصبع الاتهام في انحدار اللسان العربي، وخلق جدار من النفور بينه وبين الناشئة العرب إلى من يمكن تسميتهم «شرطة التصويب اللغوي» الذين يتشددون في أمر استخدام بعض المثقفين والكتاب العرب بعض حروف الجر استخدامًا خاطئًا مثل استخدام «عن» بدلًا من «على» في تعدية الفعل «تكلم» على سبيل المثال، أو في أمر استعمال هؤلاء بعض الكلمات في غير ما استعمله العرب قديمًا بحسب معاجمهم الأصيلة مثل استعمال كلمة «مبروك» في التهنئة بدلًا من «مبارك»، أو إلحاق هؤلاء علامات التأنيث ببعض الصيغ التي يشترك لفظها في المذكر والمؤنث مثل وزن «فعول» مثلًا في قولنا: أب حنون وأم حنون... ويتساءل هؤلاء: ما الخطر الذي من شأنه تهديد مستقبل الأمة العربية ومصير أبنائها لو قالوا: «تكلم عن»، و«مبروك» و«أم حنونة»؟!
نصوص معاصرة
وفي سياق مناقشة ما يطرحه أصحاب هذا الطرح، نشير بدايةً إلى التسليم بالدعوة إلى ضرورة اختيار نصوص أدبية معاصرة لاستثمارها في عملية التعليم والتعلم، ولا سيما في مرحلة التعليم الثانوي التي لا يكاد المتعلمون فيها يتفاعلون كثيرًا مع النصوص الشعرية المختارة لصعوبة معجمها اللغوي، وابتعاد مضامينها من همومهم وتطلعاتهم المستقبلية؛ لذلك ترى المعلم يلجأ إلى استبدال لغته المعاصرة بلغة النص الأصلي الصعبة الفهم كي يحيط المتعلمون بدلالات النص ومعانيه ويلمسون شيئًا من بنيته الجمالية؛ ونتيجة ذلك يكاد النص الشعري التراثي الأصيل يغيب باعتماد «النص البديل» الذي يقدمه المعلم بلسان معاصر قريب من أفهام هؤلاء المتعلمين. ولولا ذلك لما وجدت بادية الجاهليين، وما تختزنه من قيم وأبعاد وعلاقات اجتماعية وسياسية، قادرةً على جذب متعلمي المرحلة الثانوية؛ لذلك يطرح سؤال بدهي مفاده: ما الذي سيدفع هؤلاء المنخرطين في فضاء المعرفة الرقمية الحديثة إلى العودة إلى فضاء الرمال الجاهلية التي تصبغها دماء الحروب بنجيعها وتحاصرها قيود الأمية وهواجس العدم والفناء في كل حينلولا إلزامية المناهج التعليمية التقليدية؟!
تجديد نصوصنا الأدبية
نعم، نحن مدعوون إلى تجديد نصوصنا الأدبية في العملية التعليمية التعلمية، وإلى ترحيل دراسة النصوص التراثية من جاهلية وإسلامية وأموية وعباسية وأندلسية إلى المرحلة الجامعية، وذلك لِمنِ اختار أن يختص في دراسة اللغة العربية وآدابها. كما أننا مدعوون إلى تحديث طرائق تدريس كفايات القواعد والبلاغة والعروض، وإخراجها من الدائرة التجريدية التقسيمية التي تقدم من خلالها، وإلى التخفيف من وطأة «الحذلقة» الإعرابية التي يمارسها بعض أباطرة «إمارة النحو والصرف» بحق الكثيرين من المتعلمين الذين ينهون المرحلة الثانوية وهم لا يكادون يميزون الفعل من الاسم، ولا صيغة الماضي من صيغة المضارع أو الأمر.
أما ما سوى ذلك، فإن هذا الطرح قد انطوى على مبالغات جمة؛ لأن المشكلة التي تمنع قطاعًا وافرًا من المتعلمين العرب، وخاصة في الصفوف الأولى، من تملك معظم مهارات العربية: إصغاءً وتعبيرًا وقراءةً وكتابةً، والتي تبني جدارًا من الغربة والنفور منها، إنما تكمن في أساليب التعليم وطرائقه الجافة المستهلكة منذ الصغر في مرحلة التأسيس المدرسي الأولى؛ وإلا فأين نجد المبالغة في التركيز على الإعراب أو الهوس في تصويب الأخطاء الشائعة لدى مدرسي العربية سواء في رياض الأطفال أم في صفوف الحلقتين التعليميتين الأولى والثانية؟! ومن مِن معلمي العربية (بل من سلفييها المتشددين في القواعد النحوية)، في تلك الصفوف المدرسية، يحمل مسطرته ليقيس بـ«المليمتر» ما يتفوه به المتعلمون الصغار أو يكتبونه من أخطاء شائعة، ثم يعمد إلى أن يقص «تاء التأنيث» بـ«مقصه اللغوي الذكوري» من آخر كلمات من قبيل «نائبة» أو «حنونة»...؟!، أو يفتي بوجوب «رجم» بعض الكلمات حتى هلاكها متى أقحِمت في استعمال خاطئ من قبيل «مبروك» بدلًا من «مبارك»، أو «مدراء» بدلًا من «مديرين»؟!
لذا، فإننا نرى أن النفور المشار إليه لدى أبناء العربية من لسان أجدادهم يمكن رده إلى ضعف امتلاكهم الكفاءة اللغوية اللازمة بفعل المناهج التربوية والأساليب التعليمية التي يتقدم فيها التقليد والمحاكاة على النقد والإبداع؛ ومتى افتقد المتعلم الكفاءة المطلوبة في العربية عجز عن الأداء اللغوي أداءً سليمًا، مما يجعله يلجأ إلى تغطية عجزه ومواربته، فتجده إما أن يستعين بلغة أجنبية بديلة إذا استطاع إلى ذلك سبيلًا كنافذة على العلم والثقافة والتحصيل المعرفي، وإما أن يستسلم لأميته المقنعة. ولا غرو أن من يكره العربية من أبنائها لشعوره بالعجز عن التفاعل مع نصوص أمثال «عنترة» و«قيس بن الملوح» و«أبي نواس» و«أبي تمام» والمتنبي»...، فهو أعجز من أن يتفاعل مع نصوص المعاصرين أمثال «بدر شاكر السياب»، «أدونيس» و«يوسف الخال» و«خليل حاوي» و«أنسي الحاج».
كما يمكن رد هذا النفور من اللسان العربي إلى استلاب الشخصية العربية بصورة خاصة، وتكبيلها بأسر عقدة الدونية الحضارية والثقافية واللغوية التي تدفع إلى الانبهار بكل ما هو غربي - ومن ضمنه لغات الغرب - نتيجة الانحدار الحضاري العربي المريع؛ وإلا كيف يمكننا أن نفهم ظاهرة توكؤ بعض المثقفين والأكاديميين والباحثين والمعلمين - ومنهم بعض معلمي اللغة العربية وآدابها - على ما يعرف بـ«لغة الإنترنت» في الدردشة ما بينهم متعمدين الحروف اللاتينية وبعض الأرقام بديلًا من الحرف العربي؟! وكيف نفسر ظاهرة إقحام هؤلاء بعض الكلمات الأجنبية في لغة حديثهم اليومي أو حتى في لغتهم التعليمية داخل قاعات التعليم؟! حتى لكأن كلمتي (Ok) و(So) أصبحتا محطتين جاذبتين إلزاميتين يتخفف فيهما «المثقف العربي»، بصورة غير واعية، مما يكاد يحجب وهج صورته «العصرية» كلما ظن أن في عودته إلى اللسان العربي عودةً إلى لسان ما قبل «العصرنة»!!
ولئن كانت هذه حال بعض النخب من المثقفين والمعلمين العرب «العصريين»، فما الذي ترِك للطلاب ولعموم الناس من العرب الحالمين بفرصة للدخول إلى «جنة» الحضارة والثقافة المعاصرتين غير محاكاة أولئك ومشابهتهم بدءًا من الاتكاء على موضة «لغة الإنترنت» وتطعيم كلامهم ببعض ملح الألفاظ الأجنبية؟!
خلط العربي بالأجنبي
وإذا ما حاولت أن تبحث عن دوافع أولئك وهؤلاء إلى اعتماد الحرف اللاتيني وبعض الأرقام بديلًا من الحرف العربي في محادثاتهم اليومية عبر مواقع التواصل، وإلى تعمد خلط الكلام العربي ببعض الألفاظ الأجنبية بدلًا من الحفاظ على نقاء اللسان الأم، فإنك ستعود حتمًا إلى البنية النفسية الجوانية لدى الإنسان العربي المعاصر الذي يظن، نتيجة الاستلاب الذاتي والحضاري، أن مفتاح المعاصرة يمكن أن يحوزه كل من نجح في أن يقول: «Ok» بدلًا من «حسنًا»، و«So» بدلًا من «إذًا» أو «لذا»، و«Merci» أو «Thank you» بدلًا من «شكرًا»، و«Please» بدلًا من «أرجوك»!
فهذا الأكاديمي «المثقف» أو المهندس «العصري» الذي ينتمي إلى روح عصره، والذي يحمل هاتفه الحديث باهظ الثمن، وينخرط في موضة «اللحية الطويلة» و«الجينز الممزق»، كيف يمكنه - نتيجة استلاب الوعي الثقافي والحضاري - أن يسمح لك بالتنازل عن بعض متممات لائحة الظهور الشبابي العصري الرائجة لدى ذوي ثقافة «محبي الحياة»، حين تدعوه إلى استعمال الحرف العربي، أو إلى التخلي عن «لغته الشبابية العصرية»؟! وكيف يقبل أن يتفوه كلمة «أرجوك» بدلًا من «Please» بالفم نفسه الذي يمضغ «السوشي» أو «البيتزا»؟! وهذه الفتاة التي بذل والداها المبالغ الطائلة لتتخرج في أرقى الجامعات الخاصة طبيبةً أو محاميةً، والتي لا تبخل على جمال جسدها لا بالشد ولا بالنفخ، كيف لها أن تدردش مع صديقاتها الجميلات بأحرف كان يكتب بها جيل ما قبل اختراع الكهرباء والهاتف و«النوتيلا» أمثال «الجاحظ» و«المعري» و«ولادة بنت المستكفي» على سبيل المثال؟! كيف لها أن تفعل ذلك وهي بنت هذا العصر، عصر «البوتوكس» ومتمماته الجمالية الذي كرسته الرأسمالية المعولمة إلهًا جديدًا قادرًا على أن يعيد نحت أجساد النساء (بل أجساد الرجال!!) المنافحات في وجه غدر الزمن نحتًا لا يتخلف عن الصورة الجمالية النمطية التي رسختها نجمات موضة الثقافة العالمية؟!
لذا، لا يجوز أبدًا أن نفصل خطط النهوض باللسان العربي عن مشاريع النهوض الحضاري البنيوية الشاملة التي تحرر المواطن العربي، من محنة الشعور بالاستلاب النفسي والفكري والتبعية للآخر، تحررًا يرقى إلى درجة أن يصبح الوالدان يبادران إلى التباهي والتفاخر بطفلهم الصغير إذا ما امتلك معجمًا عربيًا غنيا حتى قبل دخوله إلى عالم المدرسة، كما يتباهيان ويتفاخران اليوم به إذا ما راح يردد بعض الكلمات الإنجليزية أو الفرنسية في سن مبكرة! ويرقى إلى درجة أن يكف حتى بعض رجال الدين عن تصدير محاضراتهم التبليغية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعبارة «سأتحدث إليكم بلغة الشباب» قاصدًا بها اللهجة المحكية، وكأن اللسان العربي الفصيح بات محصورًا بالشيوخ وكبار السن ممن فاتهم قطار الحلم والزمن، أما الشباب فلسانهم مختلف متحرر من لسان أجدادهم. ولعل هذا المبلغ الديني «الشبابي» بلسانه الجذاب قد فاته أن يدرك أن عبارته تلك إنما تضمر ترسيخ بنية نفسية وفكرية غير واعية، تقر ضمنًا بأن لسان القرآن الكريم العربي أمسى لا ينفع في مخاطبة الشباب المعاصرين الذين يحرص هو نفسه على دعوتهم إلى الاهتمام بالقرآن الكريم والتزود من لغته ومعارفه ونوره!!
وفي ختام مناقشة هذا الطرح، نتوقف عند اتهامه من يمكن تسميتهم «شرطة النحو والتصويبات اللغوية» بأنهم يضيقون مساحة الحرية والهواء التي تتنفس العربية في أرضها، ويخنقون البسمة والورود التي يمكن أن تتفتح جمالًا وإبداعًا في بساتين العربية ضمن نصوص أدبية متمردة نتيجة بعض «الفتاوى اللغوية المتزمتة» الحريصة على تصويب الأخطاء الشائعة التي يمكن غفرانها والتجاوز عنها!
ولكن هذه التهمة يمكن دفعها ودحضها؛ لأن العربية لغة غنية جدًا وأرض خصبة لا تحتاج إلى عكاز الخطأ كي تمشي على دروب الجمال مبتسمةً تجتذب إليها فراشات المجاز حتى ترفعها إلى سماء الإبداع والفرادة التعبيرية، وخاصة إذا ما عرفنا ما تتميز به هذه اللغة من آليات مهمة لتوليد الكلمات الجديدة مثل آلية القياس والمجاز اللغوي والاشتقاق. كما أنها لا تحتاج إلى محرقة تلتهم نارها كتب النحو والصرف (وفق ما يدعو إليه أصحاب هذا الطرح) لتعبيد طريق الشعرية والفتنة الأدبية، ولنا في إبداع أبي تمام والمتنبي والمعري خير شاهد على الشعرية العالية الجمال من غير تكسير موازين اللغة من نحو وصرف!
ولا يخفى علينا أن أنصار «التصويب اللغوي» إنما يحرصون على «إشهار سلاحهم» في وجه الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المختصون باللغة العربية وآدابها والدارسون والباحثون والإعلاميون، لا في وجه المتعلمين من الأطفال والناشئة في المراحل الدراسية الأولى؛ فلا يجوز أن يتهموا بأنهم يبنون جدارًا من الكره بين أبناء العربية ولغتهم الأم. وعليه، فنحن نسأل: أي محذور يمنع تصويب أخطاء المختصين بالعربية بدافع الحرص على الصواب الدقيق؟ وهل نجد معلمًا من معلمي اللغة الفرنسية مثلًا يزعم أن التحرر من قيود سلفية الماضي أو أن تطوير الفرنسية إنما يحققهما تهشيم قواعد اللغة الأصلية؟! أو يدعو إلى عدم مراعاة الدقة في استعمالها في المدارس الفرنسية والفرنكفونية طلبًا للسهولة وعدم تنفير المتعلمين من لغتهم الأم؟!
استعادة الشخصية العربية
إذًا، في الخلاصة نقول: لئن كان بيت العربية يخنقه إغلاق النوافذ في وجه التجديد والانفتاح على لغة الآخر، فإن زعزعة قواعده وإحراقها بحجة الدعوة إلى الإبداع والتجاوز يهدمه من أساسه أيضًا. وإن التحرر من وثنية وهم الحداثة ووثنية وهم الأصالة لهو شرط أساس لاستعادة الشخصية العربية توازنها الحضاري والثقافي واللغوي؛ ونعني بالوثنية التمجيد غير العقلاني لكل ما يفد من الغرب من وثن الموضة العالمية، ووثن تقليد النجوم والمشاهير، ووثن الذوق العالمي في المأكول والمشروب والملبوس وصولًا إلى وثن أنماط التفكير والعيش، كما نعني بها، في المقابل، التمجيد غير العقلاني لكل الماضي متدثرًا ثوب القداسة والأصالة، ومكرسًا أوثان التقليد والاتباع ■

