حرب المعرفة
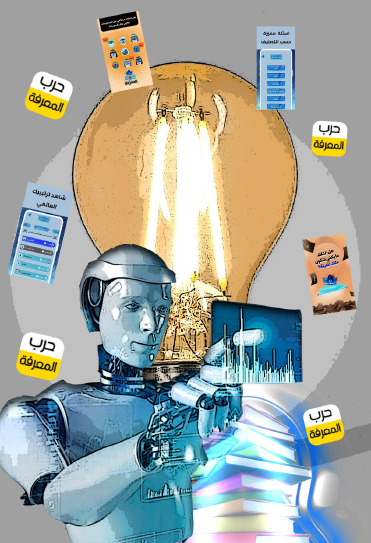
العالَم، في هذه اللحظة، يتغيّر ويدخل مسارًا جديدًا؛ أفقًا مغايرًا، سيثير الكثير من الأسئلة والإشكالات المتعلّقة بالمجهول الذي ينتظر الإنسانية قاطبة. هذا المجهول الذي تأسس وفق نظام عالمي عولَم الشّرّ بأوجهه المتعدّدة، الشرّ الاقتصادي القائم على العرض والطلب ومن ثم على الربح، الشرّ الاجتماعي المبني على الفوارق الطبقية بين فئة تغتني من عرق الفقراء، وطبقة تموت قهرًا واستعباداً، بفعل الظلم الاجتماعي، الشرّ السياسيّ الذي برز في ما يشهده العالَم من حروب وخراب وتهجير وتغيير للخرائط، الشرّ الثقافي الذي يهيمن عليه الابتذال والضحالة والعصبية والصراعات الحضارية المجانية. هذه الشرور كانت وراء هذا الارتكاس الحضاري الذي تمرّ منه الحضارة الإنسانية، إضافة إلى التسابق نحو التسلّح وامتلاك قوة عسكرية واقتصادية والهيمنة التكنولوجية.
إن عالم اليوم يخوض حرب المعرفة بتجلياتها التقنية والتكنولوجية، ذلك أن العالَم يزداد بونا وشساعة بين دول تمتلك كل الإمكانات التكنولوجية وما يترتب عنها من تسلط وتحكّم، من قدرة على رسم خرائط جديدة حسب مصالح الدول الغربية، وما حدث بعد أحداث شتنبر من إعلان حرب ضد ما سمّوه إرهابًا وانجراف العديد من دول العالَم وراء ادّعاءات الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة «الإرهاب الأصولي»، يكشف بالواضح أنها حرب، في جوهرها، دينية حضارية. ودول تفتقر لأبسط شروط الحياة، فأحرى أن تكون لها القدرة على مناكفة هذه الدول العظمى.
إن الحرب المعلنة من قِبَل الغرب عن طريق التكنولوجيا يثبت حقيقة التغوّل الغربي في حياة الإنسان، فعن طريق الوسائط الاجتماعية من فيسبوك وتويتر وإنستغرام وغيرها تمكّنت هذه الدول من تحطيم جدار الحميميات والحياة الخاصة للناس، وتمت إزاحة كل ما يحافظ على إنسانية الإنسانية، وهذا أفضى إلى إشاعة ثقافة الابتذال والضحالة، فأصبح الفرد يعيش في عزلة قاتمة قاتلة ومسببة في أمراض نفسية واجتماعية، فساد بين الناس التباعد الاجتماعي داخل البيت وخارجه، فالكل منغمس في عوالمه الافتراضية والوهمية، والأكثر من ذلك أن هذه التكنولوجيا أسهمت في تكريس عقلية الاستهلاك والتواكل، والعمل على إشاعة حقّ الغش والوصولية وترسيخ الهاجس المادي كوسيلة لتحقيق السعادة المتوهّمة. كلّ هذا نتجت عنه مجتمعات لا تفكّر، لا تدبّر، لا تتدبّر، لا تنتج، لا تبادر، بقدر ما تنتظر سماء الافتراضي أن يمطر عليها ذهب الغنى والثراء. إنها ثقافة الربح السعير والأكلات السريعة والظواهر السريعة، والفنون السريعة والنقد المتسرع وغيرها من الأنشطة الفكرية التي كان الانشغال بها يتطلب عقودًا من الزمن، هو زمن الاستسهال، استسهال المعرفة، استسهال الإنتاج المعقلن، استسهال الإبداع، مما نجم عنه اختلالات في منظومة العالَم، قِيمِيًا وإنسانيًا، ولا غرابة في ذلك لأن المعرفة التكنولوجية أعلنت الحرب على العقل الذي كان الفضل فيها لفلسفة الأنوار في القرن التاسع عشر، وما تلاه من حرية وحقوق وظهور مجتمع مدني، ومؤسسات سياسية وتيارات إبداعية، هذه التجليات للعقلانية كان وراءها مرجعيات ثقافية وفكرية وحضارية ممتدة في الماضي ومرتبطة بالحاضر وحاضنة للمستقبل، لكن الإرث العقلاني يتعرّض لأبشع حرب ضروس جيشه المعرفة التكنولوجية مدعّمة بلوبيات عالَمية هاجسها الأول والأخير الربح دون غيره، وما استنزافها لمقدرات الطبيعة وما نجم عنه من كوارث بيئية ستؤدّي الإنسانية ضرائب ثقيلة والأكثر من ذلك تهدّد وجودها.
التغوّل الغربي وحرب المعرفة
إن المفارقة التي تعيشها الحضارة الإنسانية غريبة الطبع والأطوار، غربٌ يتحوّل إلى غول يريد التهام الحجر والبشر، والتحكم في الرّقاب والعباد، وينشر حروبه البيولوجية، في سياق الصراع بين القوى العظمى، أسفر سابقًا عن الحربين العالميتين الأولى والثانية بما خلّفتاه من مآسٍ تضرب القيم الإنسانية في الصميم، لكن جشع هذه القوى ازداد لتخلق في الألفية الثالثة جائحة كوفيد 19، والتي قلبت الموازين في الاقتصادات والعلاقات الاجتماعية، في القيم الإنسانية والتأثير على العقلانية، وأسهمت في تغيير وجه السلطة من الديمقراطية إلى سلطة مستبدة، وضاعت الحقوق بل تمت إقامة صلاة الغائب عليها دون رحمة، وتفرّقت الأمم والشعوب داخل الخريطة الجغرافية نفسها، وانتصر الموت في دواليب الحياة.
إنها حرب قائدُها تكنولوجيا المعرفة وجيشُها إعلام متحكم فيه؛ يشكل إمبراطورية شاسعة، تمتلك ترسانة مالية وتقنية، وتتحكم في توجيه الرأي العام، والتأثير في منظمة الصحة العالَمية، التي تحوّلت إلى بيدق في يد شركات الأدوية العالَمية والمتحكّمين في دواليب السياسة الدولية، وأصبح الإنسان عبدًا بين كمّاشة الكِمامة المفروضة والجرعات المسمومة بِعِلل عديدة تختلف باختلاف سياق التحكّم، وعزلة تأتي على ما تبقى من أمل في المستقبل.
كل هذا أفضى إلى صناعة معرفة هشّة، ضحلة ومبتذلة تكرّس التجهيل والاستغباء، وتعليب الإنسان وتسليعه، بمحاربة المعرفة التي تبني الإنسان، وتجعله قادرًا على مواجهة تبدّلات الحياة، والإسهام في ثورة تقنية تنجم عنها معرفة حضارية، جوهرها العقل وإعطاء القيمة الجديرة بالإنسان؛ حتى يؤدي دوره الوجودي ويسهم في إغناء منظومة الأفكار، والدفع به إلى أن يكون في طليعة المدافعين على معرفة عقلانية عمادها التنوير والانتصار للفرد داخل نسق اجتماعي متطور ويتسم بدينامية فعالة وحيوية دائمة.
التقنية ودورها في شيوع المعرفة
وتشكّل شبكة الإنترنت نتيجة منطقية للتطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات، ذلك أنها من الوسائل التي لعبت دورًا مهمًا في ترويج المعرفة وإشاعتها بشكل واسع بين دول المعمورة، لكونها آلية من آليات تبادل الخبرات والتجارب وتمتين العلاقات التواصلية بين الشعوب والأمم، كما أصبحت مرجعًا أساسيًا في البحث المعرفي والثقافي، وهيمنت على الحياة العامّة للناس، مؤسسة بذلك أفقًا جديدًا من آفاق الاتصال والتفاعل، بل يمكن اعتبارها مستودع المعارف والمعطيات المرتبطة بمجالات العلم والمعرفة، وتحوّلت إلى قِبْلة لطالبي العلم والباحثين والأساتذة وللمستعملين العاديين لها، فكل واحد منهم يبحث عن مساعيه العلمية والخدمات المألوفة. والأبلغ من هذا أن هذا الاختراع حوّل العالَم إلى قرية صغيرة، بل إن الناس قاطبة كسّرت الحدود المصطنعة والمتاريس المفتعلة بين أفراد المجتمع الدولي، من خلال الاختراق القويّ للمنازل والأمكنة التي لم تكن تخطر على بال. أضف إلى هذا أن هذه الشبكة العنكبوتية فضاء للتعبير عن الجيّد والرديء في كل ما يُعرض فيها من أفكار وتصورات ورؤى تختلف باختلاف الأمم والشعوب والأهواء والرغبات، لكن الكلّ يلتقي في نقطة واحدة تكمن في العيش الافتراضي. ووسيلة شملت كل مناحي الحياة من مؤسسات اقتصادية وتعليمية وثقافية وتجارية، إنه الجسر الذي يربط قبائل العالَم ومدنه وقراه وجغرافيته المترامية الأطراف.
إن التكنولوجيا الحديثة أتاحت للإنسان فرصًا عديدة للانفتاح على الآخر والاطلاع على كل المستجدات في جميع المجالات، فـ «الإنترنت» صارت ذاكرة الإنسان وعن طريقها يتم الوصول إلى المعرفة بشكل ميسّر وسهل للغاية، خصوصًا في ظل هذه الطفرة النوعية للمعلومات التي غزت وتغلغلت في كل شيء. وهذا ما تؤكده الدراسات المختصة، من خلال الإشارة إلى الانتشار الهائل للمعلومة، مما يطرح العديد من التساؤلات المرتبطة بما تحمله هذه التطورات السريعة للتقنية الحديثة، أولها كيف يمكن للإنسانية مواكبة هذا التقدم التكنولوجي؟
الواقع الافتراضي وعزلة الإنسان
إن العالَم انتقل من وضعه الواقعي إلى وضع افتراضي متسيّد وقائم الذات، الأمر الذي انعكس سلبًا على الأفراد الذين نزحوا صوب العزلة القاتلة مما أفضى إلى التباس وغموض الواقع المعيش، مما يطرح الجدوى من التقنية إذا كانت تفرز واقعًا آخر مناقضًا لحقيقة الواقع الفعلي، ومن ثمّ يكون اللامعنى هو هوية عالم متغيّر ومتحوّل بطريقة سريعة ومفاجئة في آن، والمرآة التي تنعكس عليها صورة مجتمعات موكولة لجغرافية افتراضية توهم بالحقيقة، رغم أن جوهرها في الكثير من المفارقات والتنابذات والتجاذبات المقلقة والمحيّرة في ظل وقوع الإنسان المعاصر في فخ الإنترنت.
فالإنسان، في سياق هذه الثورة المعلوماتية، لم تعد له القدرة على استيعاب ما يجري من تطورات، ليعثر عنه رهين ثقافة استهلاكية أثرت على كينونته، التي غدت حبيسة التافه والعابر والمبتذل، في الوقت الذي تمّ وضع الثقافة بين كماشة الثنائيات المؤلمة في عمقها بين الواقعي والافتراضي، بين الجودة والرداءة، بين العميق والضحل، بين النفيس والبخس، لتسقط في شرك الدوران في هذه العوالم. والثقافة باعتبارها نسقًا متكاملًا ومتداخلًا من الروابط والتصورات والرؤى والعلامات والسنن تعيش اليوم وضعية التشظي بين الورقي والرقمي، وما يعرفه سوق القراءة من كساد وخسائر يثيران الخوف من مستقبل الكتاب الورقي ويكشفان عن حقيقة الكل يتغاضى عنها المتجلية في اكتساح العالم الرقمي لمجال الكتاب.
على سبيل النهاية
إنّ هذا الوضع الجديد يفرض على المثقفين إعادة النظر في علاقتهم بالكتاب من حيث الترويج والانتشار، خصوصًا أن أرقام المبيعات تعرّي الوجه السلبي لفعل القراءة. فواقع الارتكاس القرائي لا يعني التنصل من الكتاب الورقي، ولكن هو دعوة للتفكير في آليات جديدة تتماشى والهيمنة للعصر الرقمي وما يطلبه مجتمع المعرفة ■

