دعوة للفلسفة
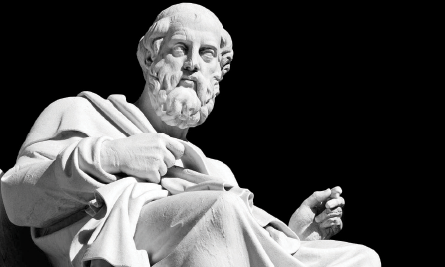
«إن مَن يريد أن يكون سعيدًا، لابد له أن يتفلسف، أي أن يهب نفسه للفلسفة» (أرسطو).
لم نكن نتوقع أننا سنصل في نهاية المطاف إلى الربط بين الفلسفة وحياة الفيلسوف، أو جعل من تاريخ الفلسفة حضورًا دائمًا، ذلك إن تاريخ الفلسفة، كما يقول هيجل، يوجد بكامله في الحاضر أكثر مما يوجد في الماضي، والفلسفة هي طريق يؤدي إلى هذا الحاضر الذي يهيمن على أفق المطلق الذي يجتذب بإغرائه محب الحكمة، وبخاصة بعدما تذوق الطعم الذي يريد اصطياده وهذا هو قدر الفيلسوف، على عكس الإنسان الطبيعي٠
ولذلك نجد أن الحكيم أرسطو يقول «إن من عادة المنحطين من الناس إذا حصلوا على ثروة طائلة أن يقدروا قيمة هذه الثروة تقديرًا يفوق تقديرهم لخيرات النفس، وهذا هو أحقر شيء في الحياة»، لأن الذي يسير في ذلك الطريق الذي يؤدي إلى الثروة واللذة والسلطة، ولا يلتفت إلى سمو الروح ونبل الأخلاق، وفيوضات المحبة، لابد أن يحشر مع التعساء الذين لا يتميزون عن الحيوان إلا بانتسابهم إلى الإنسانية، هكذا: «يتحتم علينا، كما يقول أرسطو، أن نحشر في زمرة التعساء أولئك الذين يجعلون لاكتساب الثروة أهمية تفوق العناية بطباعهم وأخلاقهم».
عشق الفلسفة
يفتتح أرسطو كتابه دعوة للفلسفة بنداء مفعم بالأمل إلى صديقه الأمير ثيموس، ذلك أن معلم الإنسانية يرى أن أعظم وأثمن هدية يمكن تقديمها للأصدقاء الأوفياء الذين نحبهم هي دعوتهم إلى عشق الفلسفة، والعيش في لذيذ نعيمها، لأنها بوابة مفتوحة على السعادة، إذ ليس هناك طريق يؤدي إلى السعادة، لأن السعادة نفسها طريق ليس سوى الفلسفة، باعتبارها حياة سعيدة ممتلئة بالفرح والبهجة، لأن الحياة الخالية من التأمل والنظر حياة لا تليق بالإنسان، كما قال سقراط. ومع ذلك تظل هذه الدعوة للالتحاق بمملكة الفلسفة التي يوجهها أرسطو لصديقه الأمير غامضة في عمقها وغايتها، هل لها مقاصد أخرى تتجاوز حدود ما تفصح عنه، أي أنها موجهة لكل إنسان مؤهل للتأمل والنظر؟ وبعبارة أخرى، هل بإمكان الفلسفة أن تعمم فقط على الأصفياء من الناس الذين يشتاقون إلى الحياة السعيدة، وقلوبهم عامرة بالآمال والمحبة؟ وهل انقلبت آمال المعلم الأول إلى فشل رافقه في سكينة المساء؟ لم يكن حلم أرسطو يتجه نحو شخص مشار إليه وهو الأمير ثيموس، بل كانت غايته هي الوصول إلى استقطاب كل إنسان أمير في سلوكه وأخلاقه مهذبًا ومثقفًا من أجل الزواج بالفلسفة والسير في طريق السعادة، والشاهد على ذلك، أن المعلم الأول لم يوجه رسالة إلى صديقه بإمكانها أن تنتهي بانتهاء مهمتها، بل اختار أن يؤلف كتابًا في هذا الموضوع الطريف والمدهش في مسعاه، إذ ما معنى أن تستدعي الناس إلى بهجة محبة الحكمة وقلوبهم ممتلئة بالكراهية للفكر والنظر الفلسفي؟ هل كان أرسطو يسعى إلى استغلال صداقته مع هذا الأمير المتنور من أجل منح للفلسفة مكانة رفيعة في مجتمع يسيطر عليه أعداء الفلسفة؟
يتوجه المعلم الأول بنداء إلى الأمير ثيموس قائلاً: «إن تطلعك للمعرفة، أي عزيزي ثيموس، وسعيك إلى الرفعة والحياة السعيدة أمور أعلمها عن طريق السمع وأني لمقتنع ما من أحد يملك أنسب مما تملك من ملكات تعنيك على الإقبال على الفلسفة: فأنت غني بحيث يمكنك أن تنفق على تعلمها، وأنت كذلك تحتل مكانة مرموقة»، ولعل أهم ما يثير الانتباه في هذه الدعوة هو إلحاح أرسطو على أن الثروة والسلطة ليست إلا مجرد وسيلة ينبغي استغلالها للوصول إلى تعلم الفلسفة باعتبارها أهم الخيرات التي تدوم وترافق الإنسان طيلة حياته، وتبعده عن شقاء الشيخوخة وتقلبات الأحوال، ذلك أن الفلسفة لا تنقلب على عاشقها مهما كانت الأحوال، وطال الزمان لأنها عاشقة مخلصة تقيم في صميم الكينونة، وتجدد بهجة الوجود فيها، وتقدح شرارة السعادة في قلب كل محب اختار السير في طريقها، ويبرر أرسطو صحة هذه الدعوة من خلال الاستشهاد بما آلت إليه أحوال أولئك الذين كانوا يعتقدون في أن الحياة السعيدة تعتمد على امتلاك الخيرات الخارجية، ويحتقرون خيرات الروح وسمو الفكر، ونبل الأخلاق: «وقد يمكنك من معرفتك بالماضي أو من تجربتك الخاصة أن تتذكر عددًا من الوقائع التي كان فيها الغرور سببا للسقوط، لقد عرفت رجالاً أسرفوا في الثقة بالثروة والحظ والقوة، ولهذا قضي عليهم بالانحدار إلى هاوية الشقاء، وعلى قدر تفوقهم السابق في النجاح يشتد عمق إحساسهم بالإخفاق وسوء الحظ ويشعرون بالخجل من أن وضعهم الحالي لا يحفزهم على النهوض بما يرونه واجبًا مفروضًا عليهم».
أبشع الشقاء
هكذا يستنتج معلم الإنسانية حكمة جميلة ونافعة لأصحاب القلوب اللطيفة مدى الحياة عندما ينصح صديقه الأمير بالابتعاد عن ذلك القدر الحزين الذي ينتظر كل إنسان قضى حياته في جمع المال واستغلال نفوذه في السلطة، وكراهيته للحكمة، لأنه بمجرد إخفاقه يشعر بأبشع الشقاء، لأن أوضاعه قد ساءت بعدما فقد نفوذه أو انهارت ثروته، ولذلك فإن أرسطو يثير انتباه صديقه الأمير إلى أن السعادة في الحياة لا تقوم على امتلاك الثروة الكبيرة والسلطة، وإنما تعتمد على الحالة النفسية الطيبة، لأنه من العيب أن نصف أحدًا من الناس بأنه «مبارك الحظ» لمجرد أنه يرتدي ثيابًا فخمة، بل سنمنح هذه الصفة لمن وهب الصحة النفسية وتمتع بالمزاج الصحيح والفطرة الفائقة، حتى وإن لم يكن له أدنى نصيب من الزخرف الخارجي: «وبالمثل لا يصف المرء نفسًا بأنها سعيدة، كما يقول المعلم الأول، إلا إذا كانت نفسًا مثقفة، ولا إنسانًا بالسعادة إلا إذا كان مهذبًا وحكيمًا. ولكننا نمنع هذه الصفة عمن يتحلى بمظاهر الزينة الفخمة دون أن يكون له أية قيمة في ذاته».
ميراث الأجيال
كان أرسطو إذن، واضحًا في دعوته للفلسفة، لأنها أثمن ثروة وميراث تتوارثه الأجيال، وهي نافعة في جميع مراحل العمر، لأنها تبعد الإنسان عن الشقاء طيلة حياته، وحين يلتحق بذلك المخبأ الرفيع سيكون قلبه ممتلئًا بالآمال، أما أولئك الذين ساءت نفوسهم وعاشوا النهم والجشع، فلن ينفعهم الثراء ولا القوة ولا الجمال، بل كلما توفرت هذه الأمور ازداد ضررها على صاحبها عمقًا وتنوعًا إن لم تقترن بالتبصر والحكمة، ذلك إن المثل القائل: «لا تعط السكين للطفل يعني ألا تضع السلطة والقوة في أيدي الرعاع».
لا بد أن نعترف بأننا نتعلم كلما اقتربنا من لهيب النص الأرسطي ومنحنا أنفسنا بدون تردد إلى حكمته وآمنا بأن الحوار معه لا ينتهي، وإنه حاضر معنا يوجهنا باستمرار نحو طريق محبة الحكمة باعتبارها بمثابة نور يطل من نافذة السعادة، خاصة وأنه وضع أمام أعيننا هذا الكنز الثمين والإرث العظيم الذي سيفتح أبواب الأمل والحياة السعيدة، التي بدونها سيكون قدرنا هو العيش في حميمية مع أبشع الشقاء الذي ينتظرنا هناك هادئًا، ذلك إن الفلسفة ليست فقط طريقاً يقود الذي يسير فيه نحو السعادة، ولكنها هي السعادة ذاتها باعتبارها تنطوي على الحكم الصحيح والتبصر المعصوم من الخطأ الذي يملك القدرة على تحديد ما ينبغي علينا أن نأتي من الأفعال، وكيف يمكن أن نعيش حياة توجهها الفضيلة، ونتشوق إلى عشق الحقيقة، لأنه إذا كان الشفاء هو بالتأكيد علة الصحة، قبل أن يكون علة المرض، فإن فن البناء هو علة تشييد البيت لا علة الهدم، ولذلك فإن مصير الإنسان العاقل الحكيم يتجه نحو غاية وهدف معين، وهو أن يعيش حياة سعيدة.
ويستشهد أرسطو بتلك الحياة اللذيذة التي عاشها الحكيم فيتاغوراس حين حسم اختياره منذ أن جاء إلى الحياة، فاختار طريق التأمل باعتباره منفذًا على السعادة، ولذلك فإن المعلم الأول يقول: «ولقد سئل فيتاغوراس لماذا جئت إلى الحياة فأجاب قائلاً: من أجل أن أتأمل السماء، ولذلك تعود أن يصف نفسه بأنه إنسان يتأمل السماء والنجوم والقمر والشمس»، هكذا يكون فيتاغوراس قد زعم بحق أن كل إنسان جاء إلى الحياة لكي يعرف وينظر ويتأمل ليصل في نهاية المسار إلى السقوط في تلك العوالم الممتعة لمحبة الحكمة، ذلك أن الفيلسوف وحده هو الذي يحاكي الأشياء الدقيقة والجوهرية، لأنه يتأمل الأشياء ذاتها لا الصور المقلدة لها، وفي هذا الأفق المشرق بتأملات فيلسوف الحقيقة الذي استطاع أن يجعل من الفلسفة قدرًا سعيدًا للإنسان الذي يولد بفطرة فائقة تمنحه خفة الفهم وقوة الذكرة والشجاعة على المغامرة في مملكة الحكمة، نجد أنفسنا أمام حكيم يحترق بعشقه للفلسفة، ويسعى إلى اقتسام هذا العشق مع كل الأصفياء الذين بلغوا مرتبة كل الواصلين وامتلأت قلوبهم بالمحبة، حيث البهجة والسرور تنتظرهما.
محبة الحكمة
ثمة اختيار صعب، ومغامرة محاطة بالمخاطر لا يعرف سرها إلا سقراط وأفلاطون وابن رشد وغيرهم من الحكماء الذين عاشوا هذه التجربة النبيلة واحترقوا بمتعتها، لا لشيء إلا لأنهم اختاروا طريق محبة الحكمة، وتركوا طريق الخيرات الخارجية، ولعل وضعهم يشبه ذلك المهندس الذي يبدع في مجال إنشاء البيوت السعيدة، باعتبارها مكانا للإقامة الفرحة، التي تؤهل الإنسان الحكيم إلى تقبل فيوضات العقل من أجل أن يعيش في فضاء الروح المشع بالفرح، والذي يبدعه الفلاسفة.
ولذلك فإن أرسطو يذهب إلى حدود القول: «وكما يمنع على المهندس الذي لا يستخدم المسطار وما شابهه من الأدوات، بل يعتمد ببساطة على محاكاة البيوت الأخرى، أن يصبح مهندسًا جيدًا، كذلك يصعب على المشرع أن يباشر العمل السياسي في الدولة بمجرد محاكاة الدول الأخرى، ذلك إن المحاكاة شيء غير جميل ولا يمكن أن تكون جميلة».
خلاصة القول إن أرسطو يضعنا أمام حقيقة غاية في الروعة آمن بها كل من جاءوا بعده، خاصة الحكماء، حينما اعتبر أن الفيلسوف وحده يتصف بثبات قوانينه ونبلها، لأنه يعيش في الحياة وبصره مثبت على الطبيعة، وفي نفس الوقت يتأمل السماء إنه يشبه الملاح الجيد الذي يرسي سفينة حياته عندما هو أبدي ودائم، هناك حيث يلقى مرساته ويحيا سيد نفسه حياة ممتزجة بالبهجة والسرور، ذلك أن امتلاك الحق في الوجود وحده يكفي لكي يشعر الإنسان الحكيم بالفرح.
هكذا يجتذبنا هذا الشوق الهادئ والعميق إلى تخوم محبة الحكمة، حيث يعدنا أرسطو بمذاق السعادة ومتعة الحياة. ولذلك ينبغي على الإنسان الفاضل ألا يهرب من الفلسفة إن كانت هي اكتساب الحكمة وتطبيقها في الوجود، وكانت الحكمة نفسها من أعظم الخيرات، مادام أنها تتصف بالبقاء والدوام، ترافق الإنسان مدى الحياة، وتبعده عن الشقاء، والقدر الحزين، لأنها هي الخير ذاته، على عكس الثروة والسلطة باعتبارها خيرات عرضية مهددة بالزوال في كل لحظة، إذ لا قيمة لحياة خالية من التأمل الفلسفي، لأنها حياة حيوانية منغمسة في الشهوات واللذة، غالبًا ما تكون عبارة عن حجاب يفصل بين الإنسان وحقيقته، خاصة وأن حقيقة الإنسان هي ماهيته التي ليست سوى التأمل والفكر باعتبارهما يقودانه نحو جنة محبة الحكمة.
نعم لم نكن نتوقع بأن الحوار مع أرسطو قد انتهى بمجرد تطبيق تعاليمه، والسير في سبله الغامضة والممتعة، بيد أن ترك أرسطو هنا هو بمنزلة استئناف لحوار جديد معه لأن الحوار أبدي كما علمنا سقراط الذي كان يتفق في نهاية كل محاورة مع محاوريه على أن يلتقي في الغد المشرق الذي يشبه طلوع الشمس في نهايته.
«الفلسفة هي الأساس ونقطة البداية في كل نهضة فكرية، وإبعادها إهانة للعقل والفكر» ■

