مندرجات الرؤية حين يتماوج الضوء على إيقاع رقص الذرات!
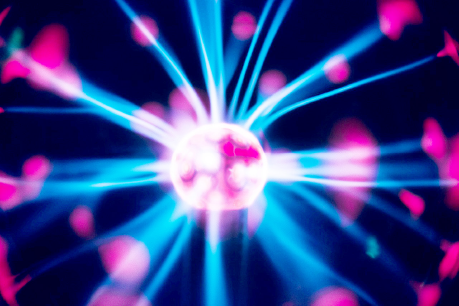
لا يختلف اثنان على دور ابن الهيثم في تصحـيح مفهوم عملية الرؤية، في القرن الحادي عشر الميلادي، وكانت العملية قبل ذلك تفترض أن عيون المخلوقات رادارات طبيعية من صنع الله تطلق أشعة غير مرئية نحو الأجسام، عبر وسط افتراضي غير مرئي، فتنعكس عليها وتعود حاملة تفاصيل الأجسام إلى العيون التي تحللها وترسلها إلى الدماغ! لقد قال ابن الهيثم بخطأ تلك النظرية وأثبت أن العين البشرية (وعيون كل الكائنات الحية) تتلقّى الضوء من الجسم المرئي ولا ترسله إليه، وبالتالي لن تكون هناك رؤية للأجسام دون ضوء خارجي ينعكس عليها أو ضوء ذاتي تنتجه تلك الأجسام. ولم يظهر إلى الضوء عالِم يعتدّ به بعد ابن الهيثم إلا في القرن السابع عشر أي بعد نحو سبعة قرون.
العين جهاز استقبال فوتونيّ (ضوئي) أوتوماتيكي معقّد متعدد المهام، بل أجهزة في جهاز! فهي كاميرا طبيعية آلية سريعة الإستجابة وذاتية التعديل بما يتناسب مع مسافة الجسم المرصود، وهي دائمة الغسل آلياً في كل رمشة من أهدابها الحامية، وهي جهاز استشعار ضوئي (فوتوسكوب)، وجهاز مطياف لتحليل الضوء (سبكتروسكوب)، وخلايا استقبال كهروضوئية ذكية (Photocell) في شبكيتها الحساسة (Retina)، التي ترتبط بدورها بملايين الألياف العصبية الدقيقة التي تنقل إلى الدماغ نبضات كهربائية شديدة التعقيد من حيث الشكل والتردد والقوة. والدماغ بدوره يعرض بالتالي صورة الجسم المرصود في فضاء افتراضي يتماهى مع موقع الجسم وطريقة إضاءته!
والعين تتلقى الإشارة الضوئية من نقاط الجسم المرئي، نقطة نقطة، بحيث يتم مسحها بسرعة هائلة، تذكرنا بالطريقة التي يتم فيها عرض الصورة على شاشة التلفاز: أكثر من مليون سطر أفقي وأكثر من 16 ألف نقطة ضوئية بالسطر الواحد، و24 صورة في الثانية الواحدة – أما العين فقد قدّر الاختصاصي الأمريكي في التصوير، روجيه كلارك، قوة العين التمييزية بـ 576 ميغابكسل بالميلليمتر المربع الواحد من الشبكية المستقبِلة! ثم يعالج الدماغ الصور المتلقّاة بسرعة كبيرة تضاهي أسرع أجهزة الكمبيوتر العملاقة المعروفة على الأرض.
ولشبكية العين ذاكرة تصل إلى عُشْـر الثانية تقريباً، أي أن الصورة المتلقّاة تبقى فيها لحوالي عُشْر الثانية بعد الرؤية، ما يعني أنه يمكن خداع العين وجعلها ترى صورًا متقطعة متتالية أساسًا وكأنها متواصلة مستمرة إذا عُرضت بأكثر من 10 صورٍ في الثانية الواحدة؛ لذلك تُعرض صور الأفلام في السينما أو على شاشة التلفزة بسرعة 24 صورة في الثانية (إلا في النظام الأمريكي حيث تكون السرعة 30 صورة في الثانية الواحدة).
الرؤية في الضوء الخافت: أسود ورمادي
وفي مكان مظلم أو قليل الإنارة قد تستطيع العين تمييز أشكال الأجسام إنما ليس ألوانها، أي أن الرؤية ممكنة إذاك بالأسود والرمادي. وذلك يعود إلى نوعين من الخلايا الحساسة في شبكية العين: خلايا قضيبية قادرة على استشعار الضوء الخافت بالأسود والأبيض دون القدرة على تمييز الألوان، وخلايا مخروطية تتعامل مع طيف ألوان الضوء القادم إذا ما كانت قوته كافية لإثارتها.
جدال تاريخي حول طبيعة الضوء: جسيم مادي أم روح موجية؟!
إذا كان الضوء لغة العيون الوحيدة، فما هي أحرفه ومصادره وطريقة قراءته؟ ما هي طبيعته أولاً؟
البحث عن طبيعة الضوء شغل البشرية منذ القدم، وكان للإغريق القدماء مساهمات نظرية جدّية حولها، لكن البصمة الواضحة حول طبيعة الضوء والعلوم البصرية الأخرى بدأت فعلياً مع العلماء المسلمين في القرون الوسطى، وفي مقدمتهم الحسن بن الهيثم (354- 430هـ، 965-1039م) في كتابه «المناظر». وكان على البشرية انتظار نحو سبعة قرون بعد ابن الهيثم، كي يظهر إلى الضوء عالمٌ يُعتدّ به مليًا، إنه الإنجليزي الـ»سير إسحق نيوتن» (1643 – 1727م) الذي شكّلت إنجازاته ثورة في المعرفة العلمية في أكثر من مجال. وفيما يخص طبيعة الضوء، فقد أطلق نيوتن عام 1666م نظرية «الجسيمات الضوئية» التي تفترض أن الضوء هو عبارة عن أجسام صغيرة مكروية تنتقل في الفراغ في خطوط مستقيمة. وهذه الطبيعة المادية للضوء أمكنها شرح ظواهر عدة في زمن نيوتن وما بعده، مثل قوة ضغط الأشعة، والشراع الشمسي، وعمل الخلايا الكهروضوئية... وقد أُطلق لاحقاً على الجسيم الضوئي اسم «فوتون»، وبات الفوتون يميّز وحدة الدفق الكمومي للأشعة الضوئية وطاقتها الإفرادية.
كما اكتشف نيوتن أن ضوء النهار مؤلف من طيف مركّـب من جميع الألوان، وأمكنه فصل الألوان عن بعضها البعض باستخدام منشور زجاجي، وجمع الألوان بواسطة قرص مخطط بجميع الألوان بحيث ينتج دورانه اللون الأبيض نسبة للرائي!
لكن عالمًا آخر في عصر نيوتن كان له رأيٌ آخر حول طبيعة الضوء، إنه الفيزيائي الهولندي كريستيان هويغنز (1629 – 1695م)، الذي قال إن للضوء طبيعة موجية يمكن الاستدلال عليها من خلال ظواهر متعددة، كالانكسار الموجي للضوء (Refraction)، والحيود (Diffraction)، والتشتت (Dispersion)، والتداخل (Interference)، والاستقطاب (Polarization).
لقد عاش العلماء إرباكًا طويلًا حول الضوء وسلوكه، فالضوء يتصرف في بعض التجارب كما لو أنه أشعة موجية، وفي بعضها الآخر كما لو أنه جسيمات مادية. وبدت النظريتان متناقضتين تماماً، فهل الضوء جسيم أم موجة؟ مادة أم روح؟!.. وانقسم العلماء حولهما لحوالي مئة سنة، يتجادلون حول حيثيات ومآلات كل من تلك النظريتين. وكان على أصحاب النظرية الموجية افتراض وجود وسط مادي خفيف جداً وشفاف جداً يتيح انتقال الموجات الضوئية، كما هو الهواء مثلًا نسبة للأمواج الصوتية. وقد أطلقوا على هذا الوسط الافتراضي اسم «الأثير»، ولم يثبت انعدام وجوده حتى مطلع القرن العشرين.
طبيعة أخرى للضوء: الموج الكهرومغناطيسي
بعد أكثر من مئة عام من الجدل ظهر العالم السكوتلندي جيمس كليرك ماكسويل (1831–1879) الذي اكتشف أن الضوء هو موجة كهرومغناطيسية Electro-Magnetic Radiation: EMR تحمل طاقةً وتنقلها على مسارها. وكان العالم الرياضي الفرنسي أندريه-ماري أمبير (1775-1836)، استناداً إلى أبحاث العالم الفيزيائي الدنماركي هانز كريستيان أورستد (1777-1851)، قد اكتشف أن الشحنة الكهربائية الساكنة تولد حقلاً كهربائياً حولها، وإذا تحركت فإنها تولد حقلاً مغناطيسياً حولها! أي أن التغيّر في المجال الكهربائي يولد حقلاً مغناطيسياً، والعكس، فإن التغير في الحقل المغناطيسي يولد حقلاً كهربائيا. هذه الحقائق أوحت لماكسويل بأصل تكوين الموجات الكهرومغناطيسية حيث إن شحنة كهربائية متذبذبة تولد في الفضاء حقلين، كهربائي ومغناطيسي، أي حقلاً كهرمغناطيسياً متغيراً، وهذا الحقل الموجي يتحرك في الفراغ بسرعة الضوء نفسه.
إذن، فالضوء بحسب ماكسويل، من فصيلة الإشعاع الكهرومغناطيسي الناتج عن مساكنة انسجامية للحقلين الكهربائي والمغناطيسي. هذان الحقلان ينطلقان سويًا من ذرات وجزيئات الأجسام المادية إثر هياجها كتعبير عن دفق الطاقة التي أصابت إلكتروناتها. وهما حين ينطلقان معًا يشكلان موجًا شديد التذبذب وشديد السرعة، بل الأسرع في الكون (حوالي 300 ألف كلم في الثانية الواحدة!).
وقاموس الإشعاع الكهرومغناطيسي هذا يمتد على مليارات الترددات، من موجات الراديو والرادار والموجات الميكروية الأخرى في الهواتف المحمولة وأجهزة التحكم عن بعد المنزلية، إلى الأشعة الحرارية ودون الحمراء (IR)، إلى أشعة الضوء المرئي، إلى الأشعة فوق البنفسجية (UV)، إلى الأشعة السينية (XR) التي تنطلق من تفريغ كهربائي لأكثر من 30 ألف فولت، إلى أشعة غاما (yR) القاتلة التي تنطلق من التفاعلات النووية.
وتتزايد طاقة الأشعة الكهرمغناطيسية طردًا مع تذبذبها (أو عكسًا مع طولها الموجي)، إذ إن العلاقة بين التذبذب والطول الموجي هي تعاكسية: (= c/f λ) حيث λ تمثل الطول الموجي للأشعة (بالأمتار) وf تمثل مقدار تذبذبها (بالـهرتز). ولمعلومات أكثر حول طاقة الأشعة وطولها الموجي أُحيل القارئ المهتم إلى النص في هامش هذه المقالة.
بعدٌ آخر للضوء: الفوتون وحدة الضوء الكمومية
منذ بداية القرن العشرين نبغ العالم الألماني ماكس بلانك (1858-1947م) الذي درس الطاقة المنبعثة من الأجسام الساخنة وعلاقتها بالإشعاع المنبعث، واكتشف الطبيعة الكمومية للضوء، أي أن الضوء ينصبّ على عيوننا كدفق متقطع من نبضات مستقلة (فوتونات) تحمل كلٌ منها طاقة مقدّرة تماماً! ووضع بلانك القانون الأهم والأشهر في فيزياء الكم: (E= h. f) حيث (E) هي طاقة الفوتون الضوئي و(h) هو ثابتٌ يسمى ثابت بلانك و(f) هو تردد الضوء المنبعث.
دي برويلي وآخر الحلول
وفي عام 1924م وضع العالم الفرنسي لويس دي برويلي (1892-1987م) مبدأً مهمًا لحل مشكلة الازدواجية في طبيعة الضوء: كل موج كهرومغناطيسي لابد أن يحمل بعدًا ميكانيكيًا يتعلق بطوله الموجي، وبالمقابل، كل جسيم مادي متحرك يمكن أن يُنسب إليه موجة يتعلق طولها بطاقته الحركية! وقد ترجم مبدأه هذا بقانون فيزيائي مهم هو: (λ = (h) / P) حيث p تمثل كمية الحركة الميكانيكية، وλ تمثل الطول الموجي المرافق.
لقد وحّد دي برويلي بين مفهومين لطالما كانا متناقضين للضوء. قبل دي برويلي كان بإمكانك التحدث عن الوجه الميكانيكي للضوء كجسيم مادي، أو عن الوجه الموجي للضوء كـ «روحٍ موجية»، وكانت النظريتان تنتميان إلى عالمين مختلفين في المفهوم والرؤية. وبعد دي برويلي بات هناك ما يعرف بـ»الميكانيكا الموجية» الموحِّدة!
أنا أراك بفضل ما ترفضه من أضواء!!
منذ ابن الهيثم في القرن الحادي عشر بتنا نعي أن رؤية الأجسام تحدث بسبب ما يصل إلى عيوننا من الأشعة المنعكسة على تلك الأجسام أو المنبعثة منها. لكن، كيف تنعكس الأشعة على مختلف الأجسام شكلًا ولونًا؟
في العلوم الطيفية بتنا نعرف أن مصادر الضوء الحقيقية هي الذرات والجزيئات، وأن كل ذرة أو جزيء يمكن إثارته إلى حد إطلاق الأشعة، أو تبريده إلى حد امتصاص الأشعة الواقعة عليه. وفي الحالتين، إطلاق الأشعة أو امتصاصها، فإن طيف تلك الأشعة هو ذاته لمادة محددة؛ أي أن العنصر الكيميائي يطلق في حال استثارته، نفس الطيف الإشعاعي الذي يمتصه حين يكون باردًا! لذلك يعتبر هذا الطيف البصمة الضوئية الحاسمة للمادة المعنية.
وكذلك حين يقع ضوء النهار – وهو غني بكل ألوان الطيف، كما سبق وذكرنا – على جسمٍ ما، فإن ذرات وجزيئات سطح ذلك الجسم تعكس الضوء بشكل انتقائي يتعلق بالبنية الكيميائية للمواد السطحية! فحين نرى جسمًا أحمرَ، على سبيل المثال، فهذا يعني أن جزيئات سطح ذلك الجسم ترفض اللون الأحمر فتعكسه نحو عيوننا، بينما تمتص بقية ألوان طيف ضوء النهار. ولو كانت جزيئات سطح الجسم ترفض اللون الأصفر مثلًا وتمتص باقي الألوان فسوف نرى الجسم أصفرَ.. أما إذا كانت المادة التي تشكل سطح الجسم تمتص كل ألوان الطيف ولا تعكس شيئًا منها، فسوف نرى الجسم أسودَ في ضوء النهار، ولا نراه أبدًا في ظلام الليل الحالك السواد. أما إذا كانت مادة سطح الجسم تعكس كل ألوان الطيف الضوئي، فإن اجتماع تلك الألوان يعيد إنتاج ضوء النهار الأبيض، ونرى الجسم أبيضَ. وإذا كان انعكاس الأشعة كلياً - مئة بالمئة- نكون حينها أمام مرآة عاكسة. ونستنتج هنا أن الأبيض والأسود ليسا في الفيزياء الطيفية لونين ذويا أطوال موجية محددة، فالأسود هو غياب الألوان تمامًا، بينما الأبيض هو اجتماع الألوان كلها!
كذلك بالنسبة لزجاج شفاف ملوّن حين ننظر من خلاله إلى الأجسام، فلون الزجاج ولون الأجسام المرصودة خلفه تقرره الأشعة التي يسمح الزجاج باختراقها، أي التي لا يمتصها.. فإذا كنا ننظر مثلاً إلى جسمٍ أبيض من خلال زجاجٍ أحمر، فإن الجسم الأبيض سوف يبدو أحمرَ من خلال ذلك الزجاج، لأن هذا الأخير امتص كل ألوان الجسم الأبيض ماعدا الأحمر الذي تركه يعبر إلى عيوننا. هنا ينبغي التأكيد أن الزجاج لم يضف اللون الأحمر الى الجسم المرصود من خلاله، كما قد يتراءى إلى الذهن، بل طرح منه بقية الألوان وترك الأحمر يعبر إلى عيوننا.
وحكاية الزجاج الملوّن في الحقيقة أكثر تعقيدًا مما ذكرنا. فهناك مواد زجاجية شفافة مصمّمة بدقة كي تمرر أو تعكس موجة ضوئية واحدة، لنقل مثلاً الموجة الضوئية الحمراء، مثل تلك الزجاجة تسمى «مصفاةً ضوئية حمراء» أو «فلتر» ضوئي أحمر. مثل هذا الفلتر الأحمر ترى من خلاله الجسم الأحمر بلونه، لكنك ترى بقية الأجسام سوداء تماماً، إذ إه يوقف تمامًا كل ما هو غير الأحمر.
أنت ترى الشمس بعد غيابها!
ما يصل إلى شبكية العين هو صورة الجسم إذ تحملها إليها الأشعة القادمة منه مباشرة، أو عبر مسارٍ غير مباشر (كالرؤية عبر المرآة مثلاً). ويكون اتجاه موقع الجسم نسبة إلى العين في اتجاه الأشعة التي تصل إلى العين في آخر مسارها. ففي وسط متجانس، نرى صورة الجسم في موقعه، لكن عبر وسط آخر نرى الصورة في غير موقع الجسم بالضبط، كأن نرى السمكة في الماء في غير موقعها الحقيقي. وكذلك نرى، في حالة السراب، صورة شجرة بعيدة في الصحراء تحت الشجرة ذاتها. هذا فيما يتعلق بالأجسام الأرضية حولنا، أما رؤية الأجرام السماوية فتتم حين يصلنا ضوؤها، بتأخير تتعلق مدته ببعد تلك الأجرام عنا؛ فضوء الشمس مثلاً يحتاج لحوالي 8 دقائق وثلث الدقيقة للوصول إلينا، وحين تغيب الشمس خلف الأفق يستمر ضوؤها بالوصول إلينا مدة 8 دقائق وثلث الدقيقة، أي أننا نستمر برؤية الشمس بعد غيابها العلمي بمثل هذه المدة.
سيمفونية الضوء على إيقاع رقص الذرات!
لكن، ما الذي يدفع ذرات أو جزيئات مادة ما أن تبث هذه الموجة الكهرومغناطيسية أو تلك، هذا الإشعاع أو غيره، هذا اللون أو غيره؟ يكمن الجواب في الهيكلية الإلكترونية لذرات تلك المادة، وفي التردد الذي تهتز به أنوية تلك الذرات، ومستويات الطاقة التي تصطف إزاءها الإلكترونات حول أنوية تلك الذرات.
فكما الأوتار، يطلق كلٌّ منها نغماً موسيقياً مميِّزاً يتعلق بطوله وسماكته وتوتّره، هكذا الذرات والجزيئات لكل منها أنغامها اللونية المميِّزة، لكل منها طيفها الموجي، بصمتها الضوئية، التي تتعلق باهتزازية أنويتها الذرية وهيكليتها الإلكترونية... وما تراه عيناك من جمال الطبيعة وأشكالها المختلفة وألوانها الزاهية، هو من فعل تماوج الضوء وتشتّته على إيقاع رقص ذرات الأجسام المستثارة، وأن ما تراه ليس سوى رسائل من ذرات تلك الأجسام إلى الخلايا الكهروضوئية الحساسة في شبكية عينيك، ومنها إلى الحاسوب العجيب داخل رأسك! وسبحان الذي خلق ■

