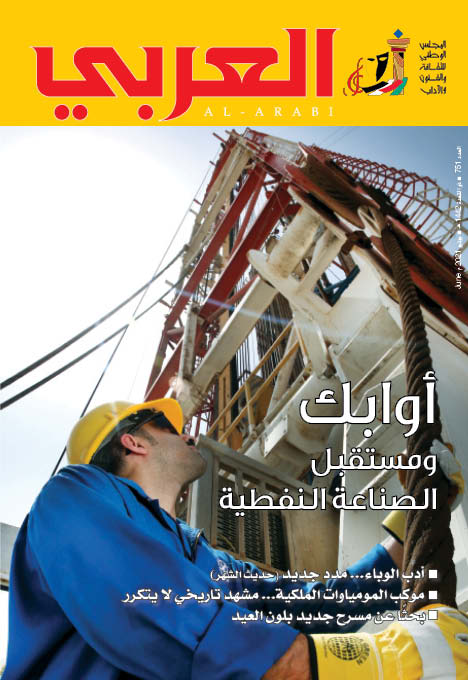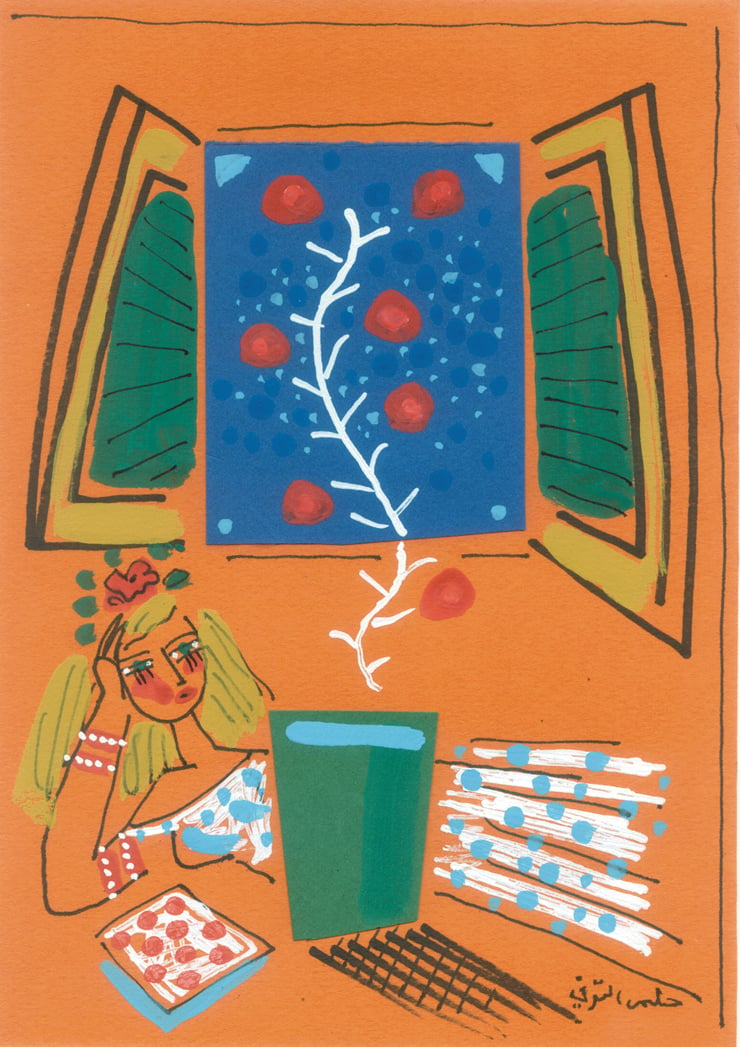العدد (751) - اصدار (6-2021)
يلجأ يوسف إدريس إلى الأسلوب السينمائي ليفتتح روايته «الحرام» كما لو كان يعرف مُسبقًا أنها ستصبح فيلمًا سينمائيًّا، فنرى الخفير عبدالمطلب المسؤول عن الري وهو يعثر في غبشة الفجر على جثمان طفلٍ مولودٍ ومخنوقٍ في الوقت نفسه، كما لو كانت الأم قد آثرت التخلص منه بخنقه وإلقائه في الطين على شاطئ الترعة. وتتوالى الشخصيات التي تُشارك الخفير في الاكتشاف، فها هو عطية الذي لا نعرف له عملًا معروفًا، والأسطى محمد المسؤول عن ماكينات التفتيش، ثم يظهر في المشهد مسيحة (الباشكاتب) ودانيال شقيقه، وتتوالى بقية الشخصيات التي تنتسب إلى العزبة، ومَن يسيطر عليها أصلًا من سكّانها والقائمين بالأمر فيها، ويتبعهم بالطبع، المأمور فكري أفندي الذي يعدّ نفسه أول المكتشفين والمُتعهد باكتشاف السّر.
يبدو الاتساق بين مكونات النص الشعري أمرًا مستقرًا لدى منشئي النصوص العالية، والكلمات تقود هذا الاتساق طوال الوقت؛ ولهذا لم يبعد صلاح عبدالصبور عن الحقيقة، حين أعلى من شأن الكلمة في الشعر في كتابه «حياتي في الشعر»؛ لأنه بإيجاز لا يُكتب بالأفكار، ولا بالصور العيانية كالأحلام؛ وإنما يُكتب الشعر بالكلمات، وذهب إلى ضرورة لجوء الشاعر إلى رموز الكلام أيضًا؛ لكي يستطيع وصف هذا العالم الجديد.
منذ أن استخدم البشر الأحجار وفروع الأشجار كأسلحة للمقاتلة، وحتى الآن (العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين)، ما زال البشر يبتكرون الجديد من الوسائل القاتلة، والأكثر فاعلية! وقدّم العلم منجزاته في الانشطار النووي واستخدامات «السيلنيوم» في الأسلحة الإلكترونية المبتكرة، إضافة إلى السياسات العدوانية الظالمة إلى حد اغتصاب الأرض والأوطان. وبقي الأدب مخلصًا لفكرة الخلاص والحريّة، إذن للأدب دوره المعبّر عن مواجهة الآخر العدواني، وتحقيق قيم العدل والحريّة، من خلال إبراز القوى الذاتية وتنمية عناصرها، من «الانتماء» والرغبة في «الفداء» من أجل الجماعة والأرض/ الوطن. وقد شاركت القريحة الإبداعية العربية إنجاز تلك القيمة الإنسانية، كما في الإبداع الفلسطيني، ومنه ما أبدعته شعرًا فدوى طوقان.
هي شهرزاد إذن في كل زمان تقص حكاياتها. طفلة كنت لا أعرف الأحلام الرغيدة، ففي عذابات النهار لا وقت للأحلام، وفي الليل تنثال عليّ مخاوف النهار فأغدو كفأرة تلتمس الأمان في خشونة جحرها. وتصير الأحلام ضربًا من الكوابيس المتناثرة، لكن الشهرزادات المُعبآت بحكايات مُقطوفة من زمن لا أعرفه كنّ يمنحن تلك الفأرة بستانًا ملوّنًا تشرد فيه وتقرض من ثماره. كانت تلك الحكايات سردًا من عجائب وغرائب يتفتق عنها خيالهن أو تلك التي توارثنها عبر الأجيال من حكايات شعبية تغوص في عوالم الأسفار والسحر والجان والأميرات الجميلات والحب النبيل وأحزان الفراق وموت العشاق.
لم تتوقف القصيدةُ العربيَّةُ منذ ارتجالها على أَلْسنةِ الشعراء في عُصورها الأُولى عن مواصلة طريقها نحو افْتِتَانِ مُتلقِّيها؛ حيث ينصرفُ شاعرُها إِلى ما يُمكن أَنْ يجعل من جسدها كائنًا حيًّا، لا تُخطِئ عينٌ ناقدةٌ رؤية الحياة فيه، سوف تراها بِكلِّ إِسرارها وإِعلانها، هَدْأَتها وهبَّتها، سُكُونها وحركتها، طيبتها وقسوتها، مُترادفاتها ومُتَضادَّاتها، أَلوانها، وعجائبها. وسوف تظلُّ القصيدةُ تَسْتَفِزُّ القصيدةَ؛ فتكون القصيدة ذلك المُثير والمُثَار؛ عندما يكون المُتلقي ذلك الشاعر الذي اهتاج قلبُه وعقلُه لقصيدة ما، فكتب أُخْتَها قصيدةً تُشْبِهُهَا على قالبها، بِوزنها وقافيتها؛ فكانت المُعَارضة تلك التي أَغْرَقَهَا كثير مِن الشعراء والنقاد في المُمَاثلةِ مع الأُولى، بَيْد أنَّها تكون فِي أَبْهى صُورها عندما تَنْزَاحُ عن تلك المُمَاثلة؛ فتأخذ نصيبًا من الانحراف، وقدرًا من المُخَالفة.
لنتفق أولاً أنّ في الكتابة يستوي الرّجل والمرأة معًا، لا أفضلية لأحدهما على الآخر إلا بقوة النص ومتانة المُنجز نثرًا كان أو شعرًا أو نقدًا. غير أنّ ما يُحدث الفارق في هذا المجال وجهات النظر في تقبّل ما تكتبه المرأة المبدعة، والتي تقوم في أغلبها على تقييم انحيازي ذكوري، ومحاصصة «جنسانية» تقوم على أساس الذّكر الفاعل، والذكر الأكثر قدرة على الإبداع والخلق. فأن يكون مقاس التقييم بمنطق العنصرية الجنسانية يفرض ذلك إعادة النظر في وعي مجتمعي وإدراك جماعي قائم على التمييز والأفضلية في الكتابة الإبداعية يعيدنا إلى ثنائية المرأة والرّجل، الذكر والأنثى، وهذه المراجعة لما هو بنيوي متجذّر في اللاوعي الجماعي والبناء النفسي للمشهد الثقافي العربي، ومن بينه تونس، غير متاح ولا ممكن، لما ندركه جميعًا من أن تغيير الوعي الجماعي هو بمنزلة الحرث في البحر، أو اقتلاع زيتونة بمشبك شعر.
قال بوشكين ذات مرة: «إن غاية الشعر هي الشعر»، وكذلك غاية الحُب هي الحُب. في زيارتي هذا العام إلى معرض الزهور، تذكّرت أول زيارة لي منذ سنوات، عندما كنت في دوامة من دوامات البؤس، فأشار لي «هو» بأن أذهب إلى معرض الزهور. ذهبت يومها فورًا، كانت شرارة الحب تملأ قلبي وتملي عليه أن يستمع إلى صوت الإلهام الذي أمرني بالذهاب إلى المعرض. كنت وحدي وكان النهار في نهايته، ومع ذلك قضيتُ أجمل ساعة في حياتي بين الزهور، أراها بعيني، لكنّ قلبي يرى غبار الحب الذي غطّى كل شيء. من يومها بدأت تعلُّم الزراعة في المنزل، أحببت كل تفاصيل الورد، وتعلّمت أن بعض الرجال قد يهادونكِ بالزهور، لكنّ رجلًا واحدًا هو الذي يعلّمكِ كيف تزرعين وردة.
قررت أن أقتله. أنا المرأة الهادئة الوديعة الحالمة، الجالسة أمام بلّور النافذة، تنساب عليها خيوط الأمطار المتراكضة. قررت أن أقتله. هكذا، بغتةً، خطرت الفكرة، وقصف الرعد يرجّ السماء والأرض، عاليًا، غاضبًا، مرعبًا. بزغت الفكرة. قصفت هدوئي الصباحي وصمتي الهادر، على حافّة انفجار مبهم. بزغت كالقصف المصمّ لرعد هذا الصباح المنفلت من صيف يحتضر.