اللغة السندية في إهاب الحرف العربي
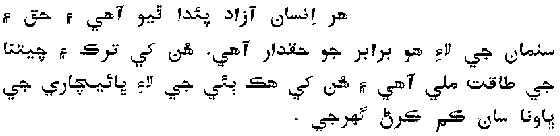
لاأزال أذكر الدهشة التي كانت تعتريني في يفاعتي الأولى، وأنا أطالع كثيراً من ملصقات الأفلام الهندية التي كانت سيدة السينما المغربية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، فأتأمل باستغراب كتابة عناوينها بخط مُلتوٍ غريب، بجنبه ترجمة للعنوان بخط لاتيني، وتحته - بحجم أصغر - ترجمة أخرى بخط عربي مكتوب بشكل جذاب، ومنها ملصق فيلم «الصداقة» الشهير الذي يعود إنتاجه إلى سنة 1964م، والذي حظي بشعبية كبيرة في المغرب والجزائر، لأنه تُرجم إلى العربية العامية المغربية، وما كان أندر مثل ذلك آنئذٍ.
رَسم الملصقُ بإتقان بطلي الفيلم الشابيْن «رامو» المُقعَد، مفترشاً الأرض وقربه عصَواه الإبِطيتان، وهو يعزف على الهارمونيكا، و«مُوهان» الضرير واقفاً يغني، وفي أعلى الملصق العنوان بالكتابة الغريبة التي سأعلمُ في ما بعدُ أنها اللغة الهندية الحديثة المدعوّة «الديواناكرية» Devanagari، (وهي كتابة شبه مقطعية متحدّرة من السنسكريتية القديمة)، وفي الوسط باللاتينية: «DOSTI»، ثم في أقصى يمين الأسفل ما سأعلم من بعدُ أيضاً أنه تعريب، وليس ترجمة، بلغةٍ اسمها «السّندية» (سِنْ ي) Sindhi، وبخط عربي جميل على النمط النسخي، لفظ: «دوستي».
والأمر نفسه سيتكرر في جينيريك البداية، وهو يهُيئك بموسيقى لاتزال ترن في آذان كثير من أبناء جيل سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لاستقبال المشاعر الإنسانية الجياشة التي ستحملها أحداث الفيلم العميقة التأثير حدّ البكاء.
وقفة مع بلاد السّنـد
سميت «السند» كذلك نسبة إلى نهر «سندوب» Sindhu أو «هندو» Indus العظيم، ويعني اسمه باللغة السندية «النهْر»، وقد اكتسبت البلاد تسميتها منه بسبب أنها تتمركز خلال الروافد الكثيرة المتفرعة عنه.
وهناك من يرادف بين السند والهند، على أساس أنه هو النهر نفسه الذي وهب بلاد «الهند» اسمها؛ والحقيقة أن السند تاريخياً إقليمٌ غير إقليم الهند. أما حديثاً فلم يكن يشكل إقليم السند غير ولاية هندية إلى حدود تقسيم البلاد بين باكستان والهند عام 1947م.
وبذلك توزع الإقليم كما كان معروفاً تاريخياً بين أغلبية في باكستان، وأقلية في شمال غرب الهند، وجزء من أفغانستان.
وعلى الرغم من أن محاولات فتح السند بدأت منذ عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، إذ وصل جيشه الماخر في بحر عُمان إلى الساحل الهندي، وفتح «خَوْر الديبل» ومدينتي «بروص» و«تانة»، فإن فتح البلاد كلياً تأخر إلى عهد الوليد بن عبدالملك، على يد القائد محمد بن القاسم الثقفي، ابن عم الحجاج - كما يذكر البلاذري في «فتوح البلدان»- بعد أن هزم الملك «داهر»، وخليفته «دوهر»، سنة 92 هـ، فاتحاً مدن الديبل وراوُر ورهمانابان وساوندري وسمند وغيرها، معقلاً تلو آخر.
وفي ذلك قال شاعرهم «الرجَز»:
نَحْنُ قَتَلْنَا دَاهِرًا وَدُوهَــرَا
وَالْخَيْلُ تَرْوِي مِنْسَرًا فَمِنْسَــرَا
وهكذا آمَنت البلاد وأمِنت، واستقرت في ظل دولة الإسلام وهي في أوج فتوتها، وفرح الأهالي البوذيون بالفتح الذي خلّصهم من سطوة الحكام البراهمة.
وبعد إسلامهم، أسهم السنودُ إسهاماً مشهوداً لا في فتح ما وراءهم من بلاد الهند فحسب، ولكن كذلك في مختلف العلوم والفنون والمعارف، يداً في يد إخوتهم في العقيدة من جميع العناصر الإنسانية التي صهرتها بوتقة أخوة الدين الجديد، في سبيل بناء الحضارة الإسلامية الوليدة ورُقيّها.
وإذا كانت بعض النقوش التاريخية ذات الرموز والأشكال السندية تشير إلى هجرات جماعات سندية قديمة إلى بلاد ما بين النهرين، تعود إلى حوالي 2300 قبل الميلاد، مما يدل على وجود علاقات تاريخية تتجاوز التجارة عبر الملاحة البحرية بين العرب وشبه الجزيرة الهندية، فإن هذه العلاقات ستتوطد بعد الفتح، لاسيما لما استوطنت بعض البيوتات العربية - ومنها بيوتات لأحفاد الصحابة والتابعين - بلادَ السند، فـ «تسنَّدتْ» جنباً إلى جنب مع أهالي البلد، إلى درجة أن اللغة العربية - كما يسجل الاصطخري في «مسالك الممالك» - شاع استعمالها إلى جنب السندية على ألسن أهالي بعض المناطق، خاصة «المنصورة» و«الملتان» اللتين بناهما الفاتحون، وما جاورهما. وهكذا إلى أن بلغ أثر العربية أقوى درجاته في كثير من لغات الهند - بعد السند - كالبنغالية والبلوشية والأردية والبشتوية.
ولم تزُل المكانة الرسمية للعربية إلا لدى زوال الحكم العربي للبلاد، وتسليم المشعل للغة الفارسية المُعرَّبة مع الحكام الجدد، الغزنويين والمغول. ومع ذلك فقد تركت العربية بصمتها الخالدة في كتابة هذه اللغات - ومنها السندية- بأبجديتها.
اللغة السنديـة
السندية إحدى لغات المجموعة الهندية الآرية التي هي بدورها من عائلة اللغات الهندوأوربية. وتضم المجموعة المذكورة الهندية والأردية والبنغالية والبنجابية والنيبالية والغوجاراتية Gujarati، والسنهالية Sinhali، والسرائيكية Saraiki، والأساميسية Assamese، علاوة على السندية.
ويدقّق جورج أبراهام غريرسون G. A. GRIERSON أكثر، ليعتبر السندية مع لاهْنْدا Lahnda (وهي مجموعة لغوية تضم الهندوكية والخِطرانية والجاكاتية والسرائيكية والبنجابية) تشكلان المجموعة الشمالية الغربية للدائرة الخارجية للغات الهندية الآرية، مُنبهاً إلى ارتباطها الوثيق باللغات الداردية Dardic، ولاسيما الكشميرية.
ووفق مصادر اعتمدت على الإحصاء الرسمي العام في باكستان سنة 2014م، فإن أغلبية متكلمي اللغة السندية يستوطنون باكستان، بتعداد 22 مليون نسمة ونيّف، من أصل 26 مليون سندي باكستاني، لتشكل اللغة الثانية في البلاد بنسبة 14 في المائة، بعد البشتوية Pachto. في حين يحدد إحصاء الهند لسنة 2011 متكلميها في أكثر من مليونين ونصف المليون، مع الإشارة إلى أن كثيراً من السنود هاجروا من الهند عقب تقسيم 1947، وإلى أن السندية ليست منحصرة في إقليم السند التاريخي، ولكن لهجاتها متكلَّمة كذلك في أقاليم بلوشستان وراجستان والبنجاب وراجا بوتونا ولاس وبومباي نفسها، كما تجد في السند متكلمي البنجابية والبلوشية في تناغم وتعايش للغات، سواء بسواء مع تعايش الإثنيات؛ وللإشارة فإن رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو سندية، بينما زوجها الرئيس الحادي عشر لباكستان آصف علي زرداري بلوشي.
وهكذا يفوق العدد الإجمالي لمتكلمي السندية 30 مليون نسمة، إذا أخذنا في الحسبان بضعـــــة ملايين من الـــسنود المتفرقين أقلياتٍ في المهاجـــــر، وخاصة في إندونيسيا وسنغافورة وشبه الجـــــزيرة العربــــــية وبريطانيا وأمريكا.
ومن المعروف عن السنود اعتزازهم الكبير وفخرهم بلغتهم، لا لحضارتها العتيدة التي اكتُشف أخيراً أنها قد تكون أعتق من حضارتي الفراعنة والسومريين فحسب، ولكن لما أبدعه بها جلة من كبراء أدبائها، وعلى رأسهم شاه عبداللطيف بِتائي الذي سنقف معه وقفة بعد قليل.
وتُعد السندية لغة رسمية في كل من باكستان وولاية السند في الهند، وتتفرع عنها لهجات عدة، يذكر منها د. مقيت جاويد من جامعة البنجاب بلاهور لهجات: لاري Lari في دلتا السند، وتاريْلي Tharaili في صحراء تارا، وفِتْشولي Vicholi في وسط السند، وسرائيكي Saraiki في السند الأعلى، ولاسي Lasi في لسبيلهْ وكوهستان، وكاجهي في منطقة كجه، علاوة على شيكاري وكاشي وباتيا وجادجي، في بيئة آسيوية تموج فيها مئات الألسُن المختلفة، قُدّر منها في الهند وحدها 122 لغة، و234 لهجة أو لغة أم! بل إن اللهجة الزدجالية في سلطنة عُمان تعد أحد تجليات امتزاج السندية بالبلوشية، انتساباً إلى ما تبقى من ألسنة جيل بعيد من الأجداد الذين عبروا بحر العرب إلى المنطقة من باكستان وإيران.
الخط العربـي
خصّ السير غريرسون المذكور آنفاً الباب الأول من الجزء الثامن من موسوعته «Linguistic Survey of India» للُّغة السندية ومجموع لغات لاهندا، وتحدث كثيراً عما له تعلُّق بهما: التسمية، والتاريخ، وإحصاءات الناطقين، والموقع، والعلاقات مع لغات الجوار، ولكنه لم يذكر شيئاً عن الأبجدية التي كتبت بهما اللغتان!
ومما لا شك فيه أن بداية كتابة اللغات تسير على قانون لا تخلفه، وهو البدء بالكتابة التصويرية التي تقوم على تمثيل المعاني برسوم، ثم تنتهي بكتابة حرفية هي التي تستقر عليها أغلب لغات العالم اليوم، ومنها ما يمر بفترة الكتابة المقطعية. وهذا ما ذُكر عن كتابة اللغة السندية القديمة وأخواتها في المجموعة الهندية الآرية.
غير أن أقدم الآثار الموثقة تسجل من دون وثوقية أن جميع لغات هذه المجموعة أيضاً كتبت بخط هندي قديم، قد يكون البرهمي Brahmi، منذ حوالي ألفيْ عام. وقد اعتبرت إشارة إلى نسخة سندية مستقلة من «الماهابْهاراتا» Mahabharata، أو «حكاية الملك العظيم ابْهاراتا» (وهي إحدى كُبْرييِ الملاحم الهندية التي دوّنت أساطير الهندوس، مع «الرامايانا» Ramayana)، تعود إلى القرن الثامن الميلادي، أقدم وثيقة مكتوبة بها.
وبعد ذلك كتبت السندية بخطوط محليّة، كالأرداناغاري Ardhanagari، والملباري أو الملواري Malbari or Malwari، ثم بالخط الخودابادي Khudabadi، فالخط الكُرمخي Gurmukhi على شاكلة البنجابية، وأخيراً بالحرف العربي الموسَّع. وعلى خلاف كل تلك الخطوط، أصبحت تكتب كالعربية من اليمين إلى الشمال.
تشمل الأبجدية السندية العربية 52 حرفاً، وهي بهذا محطّمةُ الرقم القياسي بين جميع أبجديات العالم التي تُكتب أو كُتبت في مرحلة تاريخية ما بالحرف العربي. فإضافة إلى الحروف الثمانية والعشرين التي تضمها الأبجدية العربية، أضافت السندية 24 حرفاً عربياً مُبتدعًا ومُعدَّلاً، لتُمثل بها الأصوات التي ليس لها مقابل في اللغة العربية، لاسيما أنها ذات لائحة غنية من الصوامت والصوائت.
وإذا كانت اللائحة المصاحبة رفقته تبين الحروف المزيدة على الأبجدية العربية، فإننا نختار أن نمثل هنا واحداً منها مع تقريب القيَم الصوتية المختلفة التي يؤديها تنوعُ رَسمه.
ولنأخذ حرف التاء الذي ليست له في الأبجدية العربية إلا صورتان، لأن صِواتة اللغة العربية لا تحتاج إلا إليهما، وهما التاء المثناة والثاء المثلثة. أما في الأبجدية العربية السندية، فإن له خمسة أشكال حرفية، لتقابل ست قيم صوتية مختلفة.
واستناداً إلى الموسوعة البريطانية فقد تمت مَعْيرةُ النسخة الأبجدية العربية الموسَّعَة المستوحاة من لدن الفارسية والأردية في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي، واعتُمدت لِلغة السندية رسمياً سنة 1853م.
وإذا كانت الأردية اعتادت على التدوين بالنمط الخطي المسمى «الفارسي» أو «النستعليق» (وهي كلمة مركبة من «النسخ» و«التعليق»)، فإن السندية غالباً ما تكتب بنمط خط «النسخ» الذي أدهش يفاعتي الأولى منذ سنين.
تجدر الإشارة إلى أن محاولات الهند فرض كتابة السندية بالخط الديواناكاري المذكور من قبلُ، سنة 1948 عقب الانفصال، فإنها لم تلق قبولاً إجمالياً، ومع ذلك تُكتب بالخط العربي وبه في الهند، ولا تكتب بسوى الحرف العربي في باكستان.
وعموماً، يبقى العامل الديني أو الأيديولوجي حاسماً في قضية اختيار الأبجدية، علما بأنه - من الناحية العمَلية - يمكن لأي لغة أن تُكتب بأي أبجدية، على وجه الإطلاق، مع إدخال التعديلات اللازمة طبعاً.
وهكذا غالباً ما يختار السنود المسلمون - وهم الأغلبية - الخط العربي، في حين يختار السنود الهندوس الخط الديواناكري، ويميل التجار إلى الشيكابوري Shikarpuris، وفق ما رصده آرفند أينغار A. IYENGAR.
ومع ذلك، فإن هذا العُرف لم يمنع من ظهور نسخة سندية لـ «ماهابْهاراتا» بالأبجدية العربية سنة 1958، كما لم يمنع قبلهُ المنصرون من ترجمة إنجيل متَّى إلى السندية العربية مبكراً سنة 1825م، غير قانعين بترجمة كابتن ستاك C. STACK سنة 1858م لإنجيل متّى إلى السندية بخط الديواناكاري، متابعين جهودهم تلك بترجمة بورن A. BURN لإنجيل يوحنا، لتترى ترجمات أخرى لأناجيل مفردة، إلى غاية 1890م، حيث صدرت الترجمة الكاملة لأناجيل العهد الجديد من لدن «الجمعية البريطانية الخارجية للإنجيل» (B.F.B.S).
غير أن كل تلك الترجمات الإنجيلية وما تلاها وهو مستمر إلى اليوم لم تنل من عقيدة السنود المسلمين شيئاً، وذلك لشدة تمكن العقيدة السمحة من نفوسهم، مما جعلهم يعتنون بالقرآن الكريم عناية بالغة، فترجموا معانيه نثراً ونظماً، منذ زمن مبكر، وكتبوا في تفسيره كذلك، إلى أن بلغت أعمالهم فيه حوالي المائة، منها 17 ترجمة كاملة، تعود أقدمها - مما وصلنا - إلى القرن العاشر، برغم أن صاحب «عجائب الهند»، البحّار الرحالة بُزْرُك بن شَهْريار الرامهُرْمزي
(ت بعد 340 هـ)، يعود بأول ترجمة إلى زمن بعيد، حيث يذكر أن ملِك «ألرا»، مهروك بن رايق، الذي أسلم قلبه ولسانه، وأخفى عن رعاياه الهندوس إسلامه، كان قد طلب عام 270هـ من الوالي العربي على مدينة «المنصورة»، عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز أن يرسل إليه عالماً مسلماً عارفاً بالهندية (وهي السندية، ربما سماها كذلك من باب التغليب) ليعرّفه الإسلامَ، ويترجم له معاني القرآن، ففعل، ووصل إلى سورة «يس».
ومع الأسف لا ندري عن تلك الترجمة شيئاً، لأنها مفقودة. وهذه الرواية - إن صحّتْ - هي ما استند إليه عبدالقيوم عبدالغفور السندي لترجيح كون السندية أول لغة أعجمية تتشرّف بترجمة معاني القرآن الكريم إليها.
ومن أشهر الترجمات الحديثة، وأكثرها تداولاً، نذكر ترجمة الشيخ تاج محمود الأمروتي (ت 1347هـ)، المسماة «نور الرحمن في ترجمة القرآن»، وترجمة العلامة علي خان أبرو (ت 1387هـ)، المسماة «التفسير المنير»، وترجمة الشيخ عبدالكريم القريْشي (ت 1419هـ)، المسماة «ترجمة القرآن الكريم»، والترجمة المدنية للشيخ محمد المدني
(ت 1396هـ)، وترجمة الشيخ محمد الملاح (1387هـ) المنظومة «نور القرآن»، التي تعتبر تحفة فنية نظمية تضاف إلى روائع المنظومات الأدبية السندية الكثيرة، وغيرها كثير.
الآثار الأدبية السندية
لا شك في أن الترجمات القرآنية التي تحدثنا عنها آنفاً تُعد من أهم الأعمال التي يزدهي بها تاريخ العلوم الشرعية في الثقافة السندية، الذي أثراه علماء فضلاء آخرون، من طينة مخدوم نوح بن نعمة الله الصديقي الهلائي (ت 998هـ)، وأبي الحسن الحنفي السندي الملقب بالكبير (ت 1138هـ)، ومحمد هاشم بن عبدالغفور الحارثي التتوي (ت 1174هـ)، وحجة الإسلام شاه ولي الله الدهلوي (ت 1176هـ) الملقب بمُسند الهند، وعبدالله بن ميّان محمد النرئي (ت 1236هـ)، ونور محمد العادِلبوري (ت 1365هـ)، علاوة على العلماء المعاصرين كعلّام مصطفى القاسمي، مؤسس «أكاديمية الشاه ولي الله» في حيدر آباد السند، وشيخ الإسلام أحمد المدني، وأستاذ العلماء شير علي شاه وغيرهم.
غير أن هذا لم يمنع نبوغ السنود جميع كافة مناحي العلوم والفنون، من تصوف، وموسيقى، وفلسفة، وطب، وغيرها، كما برز كثير منهم في شتى المضامير الأدبية المعروفة، وخاصة في فن الشعر، التي تأثرت كثيراً بالأنماط الأدبية العربية والفارسية، واستلهمتها، لاسيما أن السندية عرفت ببلاغتها، وجمال بيانها، وموسيقية ألفاظها.
وحين نذكر الأدب السندي يسطع نجم رجل مقدَّر للغاية لدى السنود، هو شاه عبداللطيف البِتائي Shah Abdullatif BHITTAI،
(ت 1165هـ)، الشاعر الصوفي الفيلسوف، الذي يذكر رايتس B. WRITES أن السنود يعتبرونه «حافظ السند» (على غرار شاعر الفارسية الأشهر حافظ الشيرازي)، وأن قلة منهم من لم يقرأ له، أو يسمع شعره، بل إن كثيراً منهم يحفظونه عن ظهر قلب، ويُنشدونه بصحبة القيثار، مستلذّين إدراكهم لمعانيه إن أدركوا إشراقة من إشراقاتها، حدَّ الجذبة. كما يذكر عبدالقيوم عبدالغفور السندي أن رسالة البتائي الشعرية المعروفة باسم «شاه جو رسالو» - وهي ملحمة في العشق تتضمن آلاف الأبيات، كتبت باللغة الفارسية، بالخط العربي - لاتزال ألسنة القوم تلهج بها إلى اليوم!
ويزخر الأدب السندي كذلك بروائع فنية أخرى، كملحمة «قصة يوسف وزليخا» لتاج محمود الأمروتي المذكور من قبل بين مترجمي معاني القرآن الكريم، وما أبدعه كثيرون، وبعضهم شيعة إسماعيلية، كشمس الدين سَبْزَواري ملتاني MULTANI (ت 675هـ)، وشاه عبدالكريم بُلري BULRI (ت 1034هـ) الأب الفني للبتائي، والملقب بسَجَل سَرْمَست SACHAL SARMAST واسمه الحقيقي عبدالوهاب الفاروقي، ولقبه معناه «الصوفي مدرك الحقيقة». كما لقب بالسندية «شَاعِرُ هَفْت زَبَان»، أي شاعر اللغات السبع، لأنه كتب بسبع لغات محلية (ت 1242 هـ)، وقدير بكسي بِديل (ت 1289هـ)، وشهْب الدين شاه (ت 1301هـ).
أما الأدباء السنود المحدثون، الذين اشتغل كثير منهم بالصحافة إبان ما سمي بالعصر الذهبي للصحافة في باكستان، فمنهم على سبيل التمثيل: شمس الدين بلبل (ت 1337هـ)، ومولانا دين محمد وفائي
(ت 1369هـ)، وحكيم فاتح محمد سيهواني (ت 1360هـ)، علاوة على المعاصرين، من أمثال شيخ أياز، ومخدوم محمد أمين، وتاجل بيواس، وفناتن شاهي، ومرحوم محمد هرون، وآغا سليم، وتنكور سنديكار، وغلام محمد كرامي، وتنوير عباسي، وعثمان أنصاري، وإياز غل، وغيرهم كثير.
الفجوة العربيـة
لا أريد لهذا المقال الذي يراهن على فتح عيون العرب على لغةٍ جارةٍ تتخذ باعتزاز أبجديتَهم العربية لباساً لها تزدهي به بين اللغات، قبل أن أشير إلى أمرين، أولهما ذاك النكران الذي يقابل به العرب اليوم مثل تلك اللغات التي أخرجت حروفهم العربية من ضيق الجغرافيا إلى آفاق العالمية، حتى دوّنت عدداً هائلاً من لغات العالم من مدغشقر جنوباً إلى روسيا البيضاء شمالاً، ومن الصين شرقاً إلى أمازيغيات المغارب غرباً.
فما أفقر المكتبة العربية ورقياً ورقمياً، في ما يتعلق باللغة والثقافة السنديتين، مقابل ما اعتنى به أجدادنا الأقدمون حين ألّف أمثال الواقدي «أخبار فتوح السند»، والمدائني «ثغر الهند» و«عمال الهند» و«فتح مكران»، علاوة على خليفة بن خياط والبلاذري وغيرهما، هذا خلاف كتب الرجال والطبقات والمسالك والممالك؛ حتى إنني - في بحثي لإنجاز هذا العمل المتواضع - لم أجد شيئاً يُذكر عن ذلك الشاعر الذي ذكرت أنه أشهر شعراء السند على الإطلاق، شاه عبداللطيف بِتائي، لغزارة آثاره الشعرية والفكرية وعمقها!
وفي حين لا يكاد المثقف العربي يعرف عنه شيئاً، بل الطالب أو القارئ العادي، يسميه الغرب «The Greatest Poet of Sindh» (أعظم شعراء السند)، ويُترجم له إلى الإنجليزية منتخبات من شعره تحت عنوان اللقب نفسه، بل ينتبه إليه إرنست ترامب E. TRUMPP منذ القرن قبل الماضي، حتى قبل الاحتلال البريطاني للهند، ويطبع تحت عنوان الديوان نفسه «شاه جو رسالو» مقتطفات من شعره مُترجَماً، في لايبزيج Leipzig سنة 1866! وأكثر من ذلك - وعلى سبيل التمثيل للمفارقة لا غير - تصدر سنة 1992 بالإنجليزية أيضاً أنطولوجيا شاملة للأدب الهندي الحديث المكتوب بين 1850 و1975 Modern Indian Literature :An Antology في ثلاثة أجزاء، برعاية كريم بومانيل متائي جورج K. M. GEORGE، تتضمن كل ما كتب بلغات الهند الفسيفسائية الرسمية الاثنتين والعشرين! هذا دون أن نسترسل في ذكر أعمال غربية أخرى تناولت اللغة السندية من كل النواحي اللغوية الوصفية والتاريخية والمقارِنة، كأعمال تشارلز هاسكل C. HASKELL، وجي إف بلومهارد J. F. BLUMHARDT، وأوغست فردريك رودلف هوينرل A. F. R. HOERNLE، ودابليو إيتش واتن W. H WATHEN، وجورج كاردونا G. CARDONA، ودانيش جاينD. JAIN، وغيرهـــم، برغــــم كل الملاحظ الموضوعية التي تسجلها آن ماري شيمل A. SCHIMMEL بأسف في مقدمة الجزء الرابع من «تاريخ الأدب الهندي» المخصص للأدب السندي.
ومع هذا الفقر العربي المجحف في حق مدونة الثقافة العربية نفسها، قبل أن يكون مجحفاً في حق الآداب العالمية الشقيقة في الدين والأبجدية، لا يسع المرء إلا أن ينوه بمجهودات إيجابية رائعة تأتي من أقاصي الدنيا لترفع من شأن العربية وشقائقها في الحَرف، كالمشروع الرائد الذي قاده الباحثون من «مدرسة علوم الحاسوب» بماليزيا: ديل نواز هاكرو Dil Nawaz HAKRO، وزملاؤه، في إطار ما يسمى بالتعرف الضوئي على المَحارف Optical Character Recognation، وهو برمجة حاسوبية لتحويل صور النصوص المكتوبة باليد أو المرقونة إلى نصوص يستطيع الحاسوب معالجتها، بمجرد تمرير ماسحة ضوئية عليها؛ حيث قدم الباحثان أعمالاً لمسح نصوص جميع اللغات التي تتخذ من الحرف العربي أبجدية لها، ومنها السندية، برغم أنها أصعب تلك اللغات، لارتفاع عدد حروف أبجديتها كما ذكرنا من قبل (52 حرفاً)؛ وهو ما تطلب من الباحثين تطوير قاعدة بيانات حاسوبية هائلة، تضمنت 4 مليارات كلمة، و15 مليار حرف، في 150 من أنماط الخطوط العربية!
والأمر الثاني الذي أود التنبيه إليه هو الخوف على السندية من ذئب اللَّتننة Latinisation المتربص بها، كما تربص من قبل وتمكّن من كثير من اللغات التي كانت تزدهي في حلة الحرف العربي.
فقد سبق لويليام جونز W. Jones منذ 1799م أن اقترح بدائل حرفية لاتينية لكتابة السندية، أسماها الأبجدية الرومية Roman Alphabet، ثم تبعه جورج غريرسون المذكور من قبل، في بدايات القرن العشرين.
وكما للحرف اللاتيني أنـــصاره الأيديولوجيون المتسترون خلف غطاء علمي في كل لغة من لغات العالم الثالث مستقلة عن نمط الخط اللاتيني المهيمن اليوم عالمياً، فإن صوت أنصاره في السند ليس قوياً، غير أنه أخذ يبرز للعيان مع أمثال الكاتب حليم بروحي Halim BROHI، ومع خطوة مَعْيرة السندية الرومية للجالية السندية التي تعيش في الغرب (وتقدر بحوالي 4 ملايين) سنة 2009م، وهي المَعيرة التي نالت رضا رابطة الجمعيات السندية في أمريكا.
وفي هذا السياق قد تُفهم جهود الاحتلال في تفريق شمل السنود بين السندية العربية والسندية الديواناكرية التي وضع لها قاموساً سنة 1850م، ولعل ذلك يكون سبباً في شقاق ذات البين، مما يقدّم بمكرٍ الأبجدية السنديةَ الرومية في الأخير حلاً مُرضياً للطرفين، وذلك على عادة فرنسا التي أصبحت مألوفة في المستعمرات السابقة .

