رؤية أحمد رامي النظرية
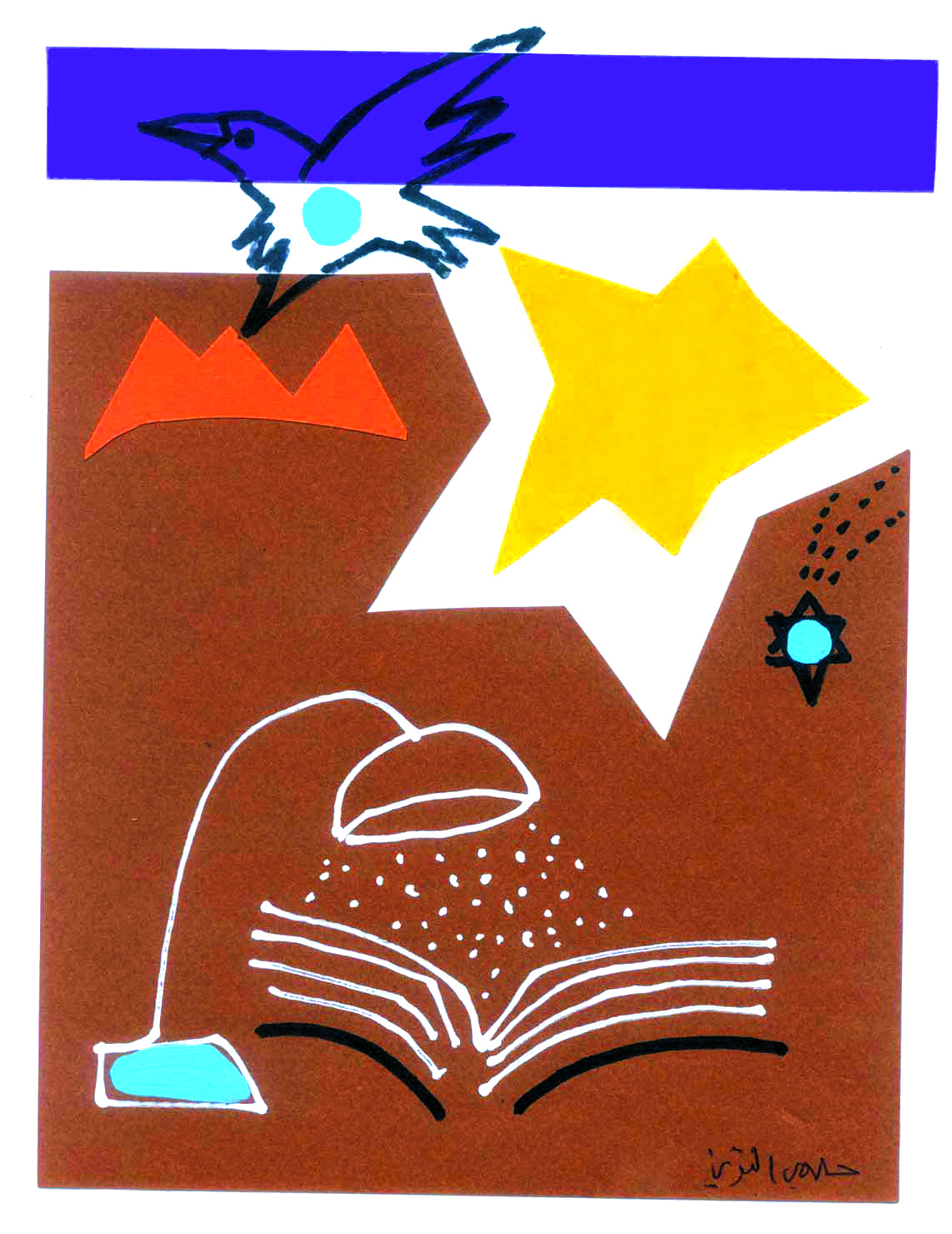
في تقرير ترشيح أحمد رامي عام 1967 لجائزة الدولة التقديرية في الآداب، جاء ما يلي: «ولما كانت الأغنية المصرية قد مرت بها في العهود الماضية فترة انحطاط، فقد كان الأستاذ رامي أسبق الشعراء إلى حمل أمانة الأغنية بالاضطلاع بتهذيب ألفاظها والسمو بمعانيها ورفع مستواها، مما أدى إلى النهضة التي بلغتها الأغنية العربية في عهدنا الحاضر، والأستاذ رامي في جميع إنتاجه الغزير لا يقتصر على الناحية العاطفية وحدها، بل يتناول الأهداف الوطنية، ومن ذلك نشيد العلم ونشيد الجامعة».
أحمد رامي (المولود في 9 أغسطس سنة 1892 بالقاهرة، والمتوفى في 5 يونيو 1981)، والذي ألّف حوالي أربعمائة أغنية، عاصر كل مدارس الشعر العربي الحديث، فقد تفتح وعيه الفني في فجر القرن العشرين على المدرسة الكلاسيكية الجديدة، وهي الحركة الشعرية التي أعادت الشعر العربي إلى سيرته الأولى، فأحيت تقاليده وقيمه الفنية، واعتدت به ملاذاً يحمي الشخصية القومية من هجمات الغزاة ورياح الثقافات الأجنبية، واستلهمت نماذجه الممتازة، وجعلت مثلها الأعلى في الفن والحياة عصور الازدهار في القرون الإسلامية الأولى، ولكن رامي شهد في يفاعته وشبابه ثلاث مدارس أخرى، هي مدرسة الديوان التي كانت أكثر تقدماً ومعاصرة.
ومن رواد تلك المدرسة العقاد والمازني وعبدالرحمن شكري، لأنهم كانوا يرون أن الشعر بادرة وجدان، والرأي بادرة عقل. والعقل قد يقتنع بين لحظة وأخرى، أما الوجدان فهو صنيع أجيال، ومكنون أزمان وأحقاب. ثم كانت مدرسة أبولو المتمردة على شعراء التقليد وعلى شعراء الفكرة، متمردة على الزعامات الأدبية، وعلى مجاهدة ما كان يسمى بالإمارات الشعرية.
وقد جمعت شعراء تلك المدرسة الموهبة الأدبية ونهلوا من آبار الفن الصافية، كما جمعتهم السماحة والحرية والطلاقة وروح الجدة والأصالة ووحدتهم الفكرة، فكرة الإعراب عن نوازعهم وخلجات نفوسهم في إخلاص وصدق، ونضارة وإشراق، لا عهد للعربية بها، فكان لهم شعرهم العاطفي والوجداني الجديد الذي لم تعرفه جماعة الكلاسيكيين الجديدة من أمثال أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، ولم يعرفه أيضاً شعراء مدرسة الديوان من أمثال العقاد والمازني وغيرهما.
وكانت للجماعة تجديداتها في بناء القصيدة وفي وحدتها العضوية، وفي إضافة قاموس شعري جديد زاخر بالألفاظ الجديدة، التي تستحم في الضياء والظلال والأنوار، وفي أسلوبهم التعبيري الجريء حيناً والطليق أحياناً، واستخدامهم للتعبير الرمزي. وكانت مدرسة المهجر بزعامة جبران خليل جبران، التي يرى بعض الدارسين أن حركة الحداثة في الشعر العربي ما كانت لتبدأ لولاها؛ تلك المدرسة التجديدية التي كانت مهمتها إعادة الشعر إلى مهمته الأولى، وهي التعبير عن النفس، وتصوير العواطف في صدق وواقعية.
قضية توقفه عند حدود الموقف الرومانسي
تكون أحمد رامي وجدانياً وفنياً خلال تلك المدارس، وشارك في نشاطها الإبداعي. ثم شهد رامي في شيخوخته المدرسة الشعرية المعاصرة، ولكنه كان قد توقف عند حدود الموقف الرومانسي الذي تكون خلاله في فترة ما بين الحربين.
لكل مدرسة فنية معطياتها الإنسانية العامة
من العسير أن نصنف الفنانين وفقاً لهذه الحدود المدرسية الحادة، ولأن الاتجاهات الفنية ثمرات لمراحل تاريخية معينة، والفن العظيم لا يمكن أن يدخل في إطار محدود، فهو يعلو على المرحلة التاريخية وعلى التقنينية المدرسية معاً، والفنان العظيم يحمل عمله الفني دلالة عصره المرحلية ويرسب فيه أعمق جوهر في التجربة التي عاصرها وفيما يمور به عصره من جديد، ولكنه - الفنان العظيم - يفعل ذلك من خلال عنصر إنساني عام يحقق لعمله البقاء ويتجاوز به عصره إلى آخر الدهر، وبهذا يخلد العمل الفني بما تخلد به الخوالد الفنية: العنصر الإنساني الباقي، والروح المرحلية المعاصرة.
ولكن من الفنانين من يسهل تصنيفه وفقاً للتقنينات النقدية والمدرسية، فالمدرسة الفنية هي ثمرة لمرحلة تاريخية محددة، وبطبيعة الحال فإن تاريخ الفن - بل التاريخ الإنساني في عمومه - لا يعرف الحسم الحاد الذي ينهي القديم ويلد الجديد في حدود فاصلة، ولكل مدرسة فنية معطياتها الإنسانية العامة التي تظل متواصلة وباقية بقاء الإنسان نفسه، أما معطياتها العارضة المرتبطة بمرحلتها التاريخية فإنها تسقط بسقوط هذه المرحلة. إن الفنانين الأخيرين - الذين يسهل تصنيفهم - هم الذين يحملون أعمالهم الفنية الدلالات المباشرة لمراحلهم التاريخية ويقفون عند السطوح الظاهرة لتجارب عصورهم، وما يحدد تصنيفهم هو رؤاهم النظرية، كما تتبدى في تصورهم لطبيعة فنهم ثم رؤاهم الفنية وفي نتاجهم الفني ذاته. والشاعر أحمد رامي كان واحداً من جيل الفنانين العرب الرومانسيين الذين نشطوا وسادت مدرستهم الفنية في فترة ما بين الحربين من القرن الماضي، وكان يحمل في رؤيته النظرية ورؤيته الفنية معاً معطيات الحركة الرومانسية العربية بشكل عام.
رؤية رامي النظرية
أما رؤيته النظرية فهي محدودة بالنظر المثالي الرومانسي المعهود، وكان يرى الشعر حقيقة داخلية ووحياً يلقى في روع الشاعر، فلا يملك له دفعاً، وكان يراه أيضاً نجوى القلب الذي لا يملك الشاعر إلا ترجمتها، وكان يرى في الشاعر صوتاً من أصوات الطبيعة: «يستمد المعنى الجليل من الدنيا تراءت له بكل المعاني، فيحاكي صوت الطبيعة في ألحانها من شدو، ومن إعوال في صياح الكروان، أو نعيق البوم على درس من الأطلال وخفيف الغصون، أو هبة الريح تدوي في البيد والأدغال وخرير الغدير أو ثورة البحر تسامت أمواجه كالجبال، صوته من فم الطبيعة ينساب انسياب الحياة في الأوصال كيف تغني أنغامه، وهي في الكون نشيد من لحنه السيال»، ويقول: «أردد صوت الطبيعة شعراً» ويراه - أي الشاعر - ملهماً موحى إليه. وكان رامي يقف في قضية الشكل عند حدود التنويعات العروضية التي اعتمدها الرومانسيون العرب وحققوها في شعرهم، وهي موجودة أصلاً في الموروث العربي ولا تحقق خروجاً جوهرياً على العمود القديم، فهو كان يرفض - كما رفض المحافظون المتشددون منهم - الشعر التفعيلي أو الحر المؤسس على توزيع موسيقي جديد يلتزم «التفعيلة» وحدة موسيقية، وعلى بناء جديد يأخذ أسلوب الشطرين ويطرح وحدة البيت إلى وحدة القصيدة ولا يلتزم القافية الموحدة.
رؤية رامي الفنية
إن رؤية أحمد رامي الفنية، كما تتبدى في شعره، فهي الرؤية الوجدانية الغنائية المعروفة عند عامة الرومانسيين، من هروب إلى مجالي الطبيعة وبخاصة إلى الريف حيث يضفي الرومانسيون على أهله الصفات المثالية كالنبل والنقاء والخيرية المطلقة كما يضفون على مجاليه صفات البكارة والجلال. ويسود ديوان رامي بشكل أساسي منزعان: الحب والأحزان... ونغمة الحب لديه كانت هادئة الإيقاع، لأن حبه حب محروم مستسلم، فيه قناعة وتضحية، وينتهي بإذعان وانسحاب باك:
تَعَجَّلُ العُمْرَ ابْتِغَاءَ لِقَائِهَا
فَإِذَا تَلاقَيْنَا بَكَيْتُ حَيَاتِي
تَمْضِي بِيَ الأَيَّامُ وَهْيَ رَتِيبَةٌ
لا هَـمَّ لي إلا اللّقَـاءُ الآتِي
أَزِنُ الحَدِيثَ أَقٌولُهُ عِنْدَ اللِّقَا
فَيَضِيعُ عِنْدَ تَقَابُلِ النَّظَرَاتِ
وَأَعُودُ بَعْـدَ تَرَقُّـبي إِقْبَـالَهَـا
وَالنَّفْسُ سَاهِمَةٌ مِنَ الحَسَرَاتِ
فَأَقُولُ: مَلّتْني وَمَلَّتْ عِشْرَتِي
وَالغَدْرُ طَبْعٌ في هَوَى الفَتَيَاتِ
وَأُناصِبُ النَّفْسَ العِدَاءَ فَتَنْطَوِي
وَلَرُبَّمَـا يَجْـني عَـلَيَّ ثـَبـَاتِي
هَمَّانِ أحمِلُ وَاحِدًا في أَضْلُعِي
فَأُطِيقُـهُ بِتَجَـلُّدِي وَأَنَـاتِي
وَأُغَالِبُ الثَّـانِي وَمَـا لي حيـلَةٌ
بَعْدَ الَّذِي أَرْسَلْتُ مِنْ عَبرَاتِي
أَشْكُو فَتَكْذِبُني الشَّـكَاةُ فَأَنْثَـني
خَزْيَانَ مِنْ دَمْعِي وَمِنْ زَفَرَاتِي
وَأَخَـافُ أَنْ تَـلْقَى الَّذِي لاقَيْتُـهُ
في الحُبِّ مِنْ وَجْدٍ وَمِنْ حُرُقَاتِ
أَجْني عَلَى نَفْسِي وَأَرْضَى ذُلَّهَـا
وَأَرَى الجِنَايَةَ أَنْ تُحِسَّ شَكَاتِي
أما حزن رامي فقد كان حزناً خفيض الصوت، ناعماً رقيقاً، إذ هو يرى عالمه من زاوية واحدة لا يتخللها قلق أو توتر، ولا يسودها إبهام ولا شك ولا حيرة، يريد أن يقول دنيانا حرمان وألم متواصلان، وليس من سبيل إلى دفعهما، فلنسلم بوجودهما ولنتغلب عليهما بالأمل والغناء:
هكذا نحن في الحياة نريد الصفو
فيها والصفو نائي المجاني
ونريد النعيم فيها ومن دون
منانا سد من الحرمان
غير أنا نعيش فيها بآمال
تسري لواعج الأشجان
وإذا أخطأت ظنون فيا رب
ظنون تريح قلب العاني
فلنعش بالمني فكم صدع البدر
حجاب السحابة المدجان
بل إنه لا يسلم بوجود الحرمان والألم فحسب، فإنه ليوطن نفسه عليهما، فهو يستعذب الألم ويستمرئ حياة الحرمان. الحزن لديه يصهر وجدانه، وهنا يصبح العذاب «نعمة»:
هاتي املئي كأس الشقا فإنني
أستمرئ الأحزان يا أيامي
الحزن أدبني، وهذّب خاطري
وأنالني عُلو الخيال السامي
وأسأل أسراب الدموع فصغتها
صوغ المعاني في شجيّ نظامي
وأرق إحساسي ومدّ مشاعري
فوصلت كل الناس في أرحامي
قاسمتهم أحزانهم وحملت من
أعبائهم شطراً من الآلام
ويرى بعض الدارسين مثل الأستاذ دريني خشبة أنه: كان دخول أم كلثوم في حياة رامي ثورة كاملة في تلك الحياة اليتيمة الحزينة الباكية، فقد استطاعت أم كلثوم أن تلهم رامي كل هذه الثروة الطائلة من المعاني (البكر!) التي لم يسبقه إليها أحد من الشعراء (فيما نعلم) والتي سجلها في شعره وأغانيه المصرية العذبة التي أنقذت الغناء المصري من الإسفاف الذي تردّى فيه زماناً طويلاً قبل أن يهيئ له الله رامي ليجدده وليهذبه، ولينفي عنه ما كان يشوبه من خيال غث، وتعبيرات رخيصة، وغزل بارد مكشوف؛ واستطاعت أم كلثوم كذلك أن تخفف من برحاء الحزن في نفس رامي، وأن تلطف من لَذْع الحُرَق التي كان ينطوي عليها من جراء نكبته في حبه، وقد اعترف هو بذلك في كثير من شعره الذي أخذ يرق ويصفو لدخول أم كلثوم فيه:
صوتك هاج الشجو في مسمعي
وأرسل المكنون من أدمعي
سمعته فانساب في خاطري
للشعر عين ثرَّةُ المنبع
ودبّ في نفسي دبيب المنى
والبرء في نضو الجِوى الموجعِ
سلوى من الدنيا تسلى بها
قلب شديد الخفق في أضلعي
طال به السهد كأن الدجى
ضل به الفجر فلم يطلع
حتى إذا غنيتِ ذاق الكرى
ونام نوم الطفل في المضجع
كأنما لفظك في شدوه
منحدر من دمعي الطيّع
فيه صباباتي وفيه الضنى
يشكو تباريح فؤادي معي
نظمت أشعاري وغنيتها
منظومة الحبات من مدمعي
أودعتها الشكوى فما رق لي
من راح بالقلب ولم يرجع
ولو تغنَّيتِ بها عنده
عاد إلى الود ولم يقطع
إن شعر رامي (شعر الدموع)، فالألم والحزن والعذاب مصادر ثراء للإبداع الفني. ونلاحظ أن رامي يعبّر عن حبه وحزنه من خلال عاطفية هادئة، تعرف الحزن وتعيشه وتدعو إلى الأمل وتغنيه. فحبه المحروم ليس هو الوجدانية المشبوبة الملتاعة كحب معاصره الطائر الجريح إبراهيم ناجي، وأمله وبهجته ليسا كأمل معاصره علي محمود طه وبهجته في مرحلته الأخيرة، إنما رامي سمير نديم يغني الألم فلا يعلو صوته وينتشي بالأمل فلا يغرق، وهو في الحالتين مغنّ أصيل، حلو الصوت والترجيع، وليس في ديوانه (ستة أجزاء) أكثر من ألفاظ الغناء ومشتقاته وأدواته.
إن رومانسية رامي كانت هادئة قريبة، ورؤيته الفنية كانت أحادية الجانب ومستقرة، وقد انسحب هذا على شكل شعره، فوضحت قلة أدوات التلوين الفني فيه وضآلة التظليل في الأداء، فهو من هذا النحو - التحفظ العاطفي والأدائي - أكثر تحرراً من شعرائنا الكلاسيكيين الجدد وأقل جرأة من معاصريه من شعراء الرومانسية العربية.
ترجمة رامي لرباعيات الخيام
إن ترجمة رباعيات الخيام من أهم أعمال رامي ومن إضافاته الباقية في حياتنا الفنية. وقصة عمر الخيام في أدبنا الحديث طويلة، بل إن هذا الشاعر قد أصبح قضية أدبية تشغل جانباً من اهتمام الدارسين من المستشرقين والشرقيين على السواء، إذ هو من الشخصيات الأدبية الفريدة التي يكثر حولها الدرس وتتفرع القضايا والمشكلات.
رامي الشاعر الذي كسبه الغناء
عُرف رامي لدى الناس في ميدان الأغنية العربية كواحد من المبرزين، أكثر مما عُرف شاعراً من شعراء الفصحى. وهو في هذا الميدان واحد من مدرسة حققت صحوة شاملة في كل الفنون مع أوليات القرن العشرين، ومثلت هذه المدرسة المجددة استجابة لدعوة الحرية للمواطن والاستقلال للوطن المصري، وتبدت تلك المطالب إبداعاً فنياً يحاول تحقيق حرية الفرد بتحقيق الطابع الذاتي في الفن، ويحاول التعبير عن الذات القومية باستمدادها من الينابيع الشعبية والمحلية الثرية بمعطيات الوجدان الجماعي.
وفي ميدان الموسيقى والغناء لمع سيد درويش إماماً للمدرسة الجديدة، فقد تمرد على التقاليد «النغمية» الجامدة التمرد نفسه الذي قامت به الفئة المجددة من شعراء عصره على التقاليد الفنية القديمة في ميدان الشعر.
ولقد طبع درويش على معاصريه بفن جديد متخلص من اللوازم الرتيبة والمحسنات الزخرفية التي يضيع معها المضمون النفسي ويبهت، ونهل من الروح الشعبي وغنى بلسان «ابن البلد» وبلسان الطوائف الوطنية، وخلّف تراثاً باقياً من الأهازيج والأدوار والموشحات والمسرح الغنائي. وكان لابد لثورة درويش في مجال «النغم» أن تكملها وتواكبها ثورة في مجال «الكلمة».
وقد كان رامي واحداً من أبرز رجال هذه الثورة، بل لعله هو إمامها ورأس مدرستها، فقد دخل ميدان الأغنية العامية من باب الشعر الفصيح، فألبسها من الأردية الفنية أجملها وأحلاها، ونقل إليها من موروثنا الشعري العظيم أروع التشبيهات والظلال. وانسحب تأثيره في مجال النظم العامي على من لحنوا وغنوا له. والنغمة السائدة في قصيدة رامي الفصيحة هي ذاتها التي في أغنيته العامية، هي نواح ملتاع وبسمة ودمعة وقرب وبُعد ووصال وصد وشوق وجفاء، ولكن هذه النغمة تنتهي أبداً في قصيدته الفصيحة وأغنيته العامية جميعاً بالدعوة الموصولة إلى الأمل والحب.
وقد تعددت جهود رامي الفنية في غير المجالات السابقة، فترجم للمسرح وألّف له، وشارك بالقصة والحوار والأغنية فيما يزيد على خمسة وثلاثين فيلماً سينمائياً، أشهرها قصتا وداد ودنانير للسيدة أم كلثوم .

