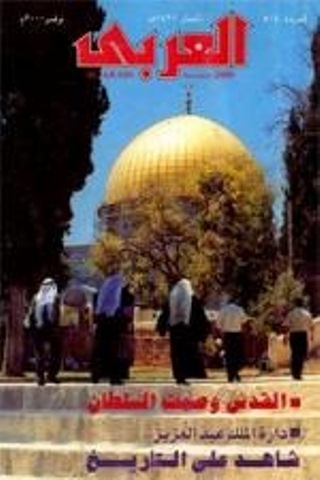العدد (504) - اصدار (11-2000)
تنفض يديها من غبار الطباشير, ثم تعلق مئزرها الأبيض على تلك الشماعة, التي تقف بشموخ منذ تدشين هذه المؤسسة التعليمية. كانت قبل أن تعود إلى البيت, تمر كعادتها بالمكتبة, تشتري جرائد اليوم لأبيها المتقاعد, وبعض المجلات النسائية لها. تسلك نورة الطريق نفسه, تقابل الوجوه نفسها, الدالة على هذه الأجساد الخشنة التي تسند جدران هذه المدينة البائسة. تدخل نورة البيت, تقدم العرض نفسه قبلة لأمها, سلاما لأبيها قبل أن تعطيه جرائد اليوم. هذه الجرائد التي أدمن على قراءتها منذ أن أقلع عن التدخين, وأحيل إلى التقاعد
كانت صور الشاعر الإحيائي تتعدد بتعدد مهامه, فمرة نراه أشبه بالخطيب السياسي, وثانية أشبه بالمعلم الذي يعلّم تلاميذه ويشرح لهم, وثالثة أقرب إلى الواعظ الأخلاقي, وأخيراً أقرب إلى المصلح الاجتماعي. كانت الوظيفة العامة للشاعر الإحيائي (مثل محمود سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومعروف الرصافي وجميل صدقي الزهاوي وغيرهم) هي الوظيفة الغالبة على شعرهم بالقياس إلى الوظيفة الخاصة التي توارت تحت ضغط الوظيفة العامة وسطوتها
فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل.. يؤكد مقولة إننا نعيش زمن الرواية ولقاء نجيب محفوظ مع السيناريست أسامة أنور عكاشة وما جرى بينهما يؤكد أكثر أننا نعيش "زمن الرواية.. التلفزيونية". فقد قال محفوظ لأسامة: "ليالي الحلمية" وقبلها "الشهد والدموع" هي روايات مرئية ميزتها أن غير المتعلم يستطيع أن يقرأ ما فيها بسهولة ومتعة, وما أكثر غير المتعلمين في العالم العربي! وكأن محفوظ بهذه الكلمات يشير إلى أهمية رواية التلفزيون التي يقدمها الكاتب في شكل مسلسلات
عَلاني سحابٌ لهُ شكل وجهكِ, قلتُ المعاد أَتَى, وركضتُ مع الراكضينَ, ولكنما الغيثُ أبطأ دهراَ ـ طويلاً مريراً ـ إلى أن تصايحت الناسُ: رُحكماك بالظامئينَ, لقد جهدوا وعيونهمو لمْ تزلْ بالسماءِ معلقةً, وهمو يرتجونَ, ألا فاعلمي أنهمْ ـ بعد حين ـ إذا ألفوا طعم هذا الظما واستكانوا له, سوف ينسون وجهكِ, مهما أذكرُهم بملامِحِهِ سوف لا يذكرونْ
أمشي في الشوارع خائفة, الوجه مغمور بالدموع, لا أعرف إلى أين أتجه. هذا الصباح, قررت أن أهرب. في ركن الشارع, وفي طرفة عين, التهمت حلوى "الكرواسون" واحتسيت عبوة الحليب التي كلفتني "لالا" بشرائها كما العادة. هذه هي المرة الأولى, منذ عشر سنوات, التي أتحصل فيها على لذة إفطار كامل. لدى العجوز, لم يكن من حقي سوى الخبز البائت وكوب من الشاي الأخضر البارد وبلا نعناع: "من الحرام أن يفسد الخبز", تقول لي دائما
إني أبحث عن الوجه الذي كان لي قبل خلق العالم في السادس من فبراير, 1829, توقفت القوات غير النظامية التي كانت تتقدم زاحفة من الجنوب لتنضم إلى الفرق العسكرية بقيادة لوبيث, والتي كانت قد وقعت بالفعل فريسة مناوشات لافال, للاستراحة عند أثييندا التي كان اسمها غير معروف لهم, على بعد ثلاثة أو أربعة فراسخ من بيرجاميتو. وعند الفجر, كان أحد الرجال ضحية كابوس عنيد: في أعماق ظلمة كوخ أيقظ صراخه المضطرب امرأة كانت تنام معه
بعد أن عزمت على صنع المستحيل للحصول على عمل وافقت على أن أصبح ساعيا لدى (غايتانو كروستاروزا) صاحب إحدى وكالات السفر والسياحة. ومكتب هذه الوكالة بسيط لا يعدو كونه غرفة ضيقة مستطيلة تصلح لأن تكون محلا لبيع مرطبات (الجيلاتي) وليس وكالة للرحلات والسفريات, ولم يكن عدد العاملين يزيد على ثلاثة أشخاص, وكنا كلنا نشغل نفس الغرفة. وفي أحد الأيام من بدئي العمل رن جرس الهاتف وكنت وحيدا فرفعت السماعة وتناهى إلي من الطرف الآخر للخط صوت رقيق عذب
استدعيت في أحد الأيام مربية أطفالي, يوليا فاسيليفا, إلى غرفة المكتبة لتصفية بعض الأمور. فقلت لها: "اجلسي يا يوليا فاسيليفا" دعينا نصفي أمورنا. أنت بحاجة إلى الفلوس, دون شك, ولكنك تحبين الرسميات بحيث أنك لم تطلبي أبدا أجرتك.. حسنا الآن.. لقد كنا قد اتفقنا على إعطائك ثلاثين روبلا في الشهر. "بل أربعون..". كلا, ثلاثون. فقد دونت ذلك. فقد كنت دائما أعطي المربيات ثلاثين روبلا. حسنا, الآن, لقد مضى على قدومك هنا مدة شهرين
"حيرة" جمراتٌ... تتلذّذ حين تقلّب أوجهها وتمرّغُها في دفء النبضِ
الغراميات المضطربة لأخي غير الشقيق "دافيد خاكوبسن" مع الجميلة "مونشا فرناندث" انتهت نهاية عنيفة. لم يكن بالإمكان أن تكون غير ذلك ـ هكذا قالت عمتنا المشتركة مارجاريتا ـ بسبب اختلاف طباعهما, وفساد أخلاق مونشا! "العمة مارجاريتا كانت متساهلة للغاية فقد كانت تسمى القرصنة عادة سيئة!". "دافيد" المسكين الذي كنت دائماً أحبه بشدة, وإن كان بدرجة أقل مما يستحق ـ لأنه كان طيباً وخيراً جداً ـ كان في ذلك الوقت قبطاناً على سفينة بضائع, عاطفيا, زائغ العينين, وسريع الوقوع في الحب!